|
مهزلة المحافظات الجديدة، إنْ تحقّقتْ؟ تردّدتُ في الكتابة بهذا الموضوع، لحساسيته. ولكنّي توكلتُ على الله، كي أدلو بدلوي في مسألة تتعرّضُ فيها وحدة البلاد إلى شرخ كبير، قد يضعُ هيبتَها على المحكّ. فمصيبة العراق كبيرة، وهي قديمة قِدَمَ الأزل. لكنّ مصيبةَ بعضٍ من مكوّناته اليوم أعظم، فهي تتفاقم كلّما مرّت الأيام وتوالت السنين وتتالت الأجيال. ولعلَّ القادمَ المنتظَر، سيكون أكثر قتامةً. ألّلهمَّ، إني أكره التشاؤم! وقلْ: "تفاءلوا بالخيرِ تجدوه"! آمين. لكنّ قراءةَ الأحداث تبدو غيرَ ذلك. قبل أيام، أطلّت علينا الحكومة العراقية الهزيلة، بكلّ قواها، وهي تتدافع بالمناكب والكلمات الطنّانة والأحلام الوردية، لتخرج بما جادت قريحتُها الطائفية بتمثيلية جديدة، بها تعمّق الهوّة بين أصدقاء الأمس وأعداء اليوم، ولتأسرَ الشعبَ المسكين البائس وتوثقَ إرادتَه مرّةً أخرى، فيما البلدُ يخوض امتحانًا عسيرًا مع فصائل إرهابية وعلى شفا انتخابات برلمانية مصيرية. تُرى، ما الحيثيات، وما الأسباب، وما الأهداف من كلّ هذا وذاك، في هذه الفترة بالذات؟ ألعقلاءُ، يرون أن التوقيت متسرّعٌ وغير موفَّق، لأنّه، كما يبدو لهم وللكثيرين، قائمٌ على أهدافٍ لا تخلو من ريحٍ طائفية ومذهبية مقيتة، اكتوى بها الشعبُ عامةً. وهذه، كما رأينا، لم تعُدْ تجدي نفعًا. لقد أُرغمَ العراقيون للتخلّي عن الحسّ الوطني بعد السقوط الدراماتيكي في 2003، بتوجيهٍ من المحتلّ الأمريكي الذي لم يزِغْ عن تعهِّدهِ بتولّي مسؤولية تفتيت العراق وتقسيمه على أسس طائفية من أجل إضعافِه، كمنطلَقٍ للتصيُّدِ العكر في دول الجوار والمنطقة عمومًا. وهذه ليست معلومة جديدة، والدليلُ على ذلك ما ارتُئي أن يكون ربيعًا عربيًا قتلَ الأخضر واليابس باستقدام جماعات تكفيرية وسلفية لتصفية ما بقي من حضارات الأمس ومن ثقافات متمدّنة تختلف عن دين الأغلبية. ومَن عاصرَ السياسة الكيسنجرية - اليهودية الأمريكية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، يعي هذه الحقيقة، كما يؤكّدها الساسة والمثقفون ومتتبّعو الأحداث دون إجراء رتوشٍ عليها أو ظلمِ عناصرها. العراق العصريّ المتمدّن، لا يُبنى بكثرة الوحدات الإدارية المستحدثة، ولا بعدد المسؤولين الفاسدين الذين تولّى العديدُ منهم وما زالوا يتولَّونَ مناصبَ هامّة في مفاصل الدولة ليست من استحقاقهم، بعد أن كانت الغالبية العظمى مِن هؤلاء، أفرادًا متسكعّين على قارعات الشوارع في دول الشتات. هذا باستثناء أصحاب الكفاءات الذين لمٍ يُنصفْهُم النظام البائد واضطُرّوا مرغَمين لمغادرة البلد بسبب أساليب التضييق عليهم بلا هوادة. فالحكومة التي تبجّحت على لسان رئيسها قبل أيام مطلاًّ من على شاشات الفضائيات بفرحته - والحمدُ لله- بنيل كلّ عراقيٍّ حقوقَه، قد فقدتْ مصداقيتَها منذ أمدٍ، لأنّ صاحبَ المقال هذا نفسُه لم تنصفْهُ هذه الحكومة، بالرغم من استحقاقه الإنصافَ أكثرَ من القادمين عبر الحدود ومِن بلدان الشتات، من أمثال مزوّري الشهادات الذين استوزروا وتسلّموا مناصب حساسة ومهمة في الدولة العراقية بعد السقوط في 2003، في حين هو وغيره من الصابرين، آثروا الإصرارَ بالتجذّر في الأرض والوطن وبين الأهل والأصدقاء. على أية حالٍ، هكذا جرت الأمور، ولنْ تكون أفضلَ حالاً ممّا كان! لا للفكر الطائفي: إنّ مسألةَ الوقوف مع أو بالضدّ من مقرَّرات أو مقترحات مجلس الوزراء باستحداث محافظات جديدة، ليس له من قيمة وطنية في هذه الفترة الحساسة، بسبب التحدّيات التي يتعرّض لها البلد، أرضًا وشعبًا، إذا لمْ يكن الهدفُ منه إصلاحُ ما كسرتْهُ التوجّهات الطائفية طيلة السنوات المنصرمة منذ سقوط النظام الدكتاتوري الملتزِم - آنذاك نوعًا ما- جانبَ الوطنية والعلمانية، في سلوك الدولة العام وفي الحراك السياسيّ بالمنطقة. كلُّ الشعبِ العراقي، من صغيرِه إلى كبيرِه، يتمنى اليوم الذي يُطبّق فيه وعليه دستورٌ مدنيّ وطنيٌّ يبسطُ أجنحتَهُ العادلة بالتساوي على كلِّ مكوّناته، من منطلَق وطنيٍّ بحت، وليس مصبوغًا بكحلة دينية أو عرقية أو طائفية أو مذهبية أو عشائرية وما إلى ذلك من تسمياتٍ تمييزية عنصرية قطعتْ صلة الرحم بين المواطن وأرضهِ، وبين أهلِه وشعبِه وبين مكوّنِهِ وسائر المكوّنات التي صارت تتحسّسُ من ذكر غيرها في الشارع وفي المجالس والدوائر والاجتماعات، وأينما تواجدتْ. من حيث المبدأ، يرى الجميع أنّ مثل هذه المطالبة، سواءً من جانب الشعب أو المناطق أو المكوّنات، كما العملُ من جانب الحكومة بالنظر في التشكيلات الإدارية الحالية وبإمكانيّة مراجعتها، لهوَ أمرٌ جديرٌ بالاهتمام، إذا كان ذلك مكتفيَ الشروط، دستوريًا وقانونيًا وجغرافيًا وطوبوغرافيًا. هذا إذا اعتبرنا الحاجة الفعلية لاستحداث مثل هذه التشكيلات بموجب الضرورة التي تقتضيها الظروف الصعبة والآنيّة لعلاج ذات البين أو لسدّ الثغرات في الإخفاقات الإدارية والخدمية والأمنية التي لم تعُدْ تُطاق. ولكن ليس بالضرورة أن يحصل ذلك بتغييرات ديمغرافية أساسُها حسٌّ طائفيٌّ به يجري تقسيم المقسوم وتجزئة المجزّأ أصلاً. فالدول المتقدّمة، تخطّت هذه المرحلة الصعبة، واقتنعتْ بضرورة إدارة كلّ وحدةٍ أو منطقةٍ شؤونها الوظيفية والخدمية والإدارية بنفسها، بأسلوب اللامركزيّة الديمقراطي، الذي يصون حقّ تلك الإدارة في اختيار الأنسب لتنميتِها وتطويرها، دون أن تسبب شرخًا في النسيج الوطني وعلى وحدة البلاد. وهذا الأسلوب الناجح في هذه الدول المتطوّرة، يمكنُ أن يُتخذَ نموذجًا يُحتذى به في بلدٍ متعدّد الأطياف والمكوّنات والأديان والمذاهب واللغات، مثل العراق. بل إنّ مثل هذا الفسيفساء، من الأصلحِ له أن يتبنّى ساستُه سياسةَ اللامركزية في حكم البلاد، كي يُتاحَ لكلّ منطقة أن تسلك السبيل الأصلَح لتطويرها وتنميتها والذي يتناغمُ مع طبيعة المكوّنات التي تقطنُه بحيث تنسجمُ مع تراثها وثقافتها وطريقة عيشها وبها تحفظ وحدة البلاد وتنمي الحسّ الوطنيّ دون تشظية المجتمع. إذن، أين المشكلة في هذا الشأن؟ بدءًا، وكما ورد في مقدمّة المقال، لم يكن طرحُ مثل هذا المشروع الكبير موفَّقًا في هذه الفترة الحرجة، لاسيّما وأنّ الحكومة العراقية برئاستها الحالية، على أبواب الأفول، بإذن الله، بسبب تراكم المشكلات والإخفاقات التي كان لها أولٌ وليس لها آخِرٌ، من دون أن يلمسَ المواطن تقدّمًا. فالحكومة الحالية مثلاً، قد فشلت في مكافحة الفساد المستشري في كلّ ركنٍ من أركان الدولة التي تتحمّل هي الجزء الأكبر من هذه المسؤولية وذلك بغضّ الطرفِ عن روّاده ولصوصه. كما أخفقت في الجانب الأمني الذي أثبتت استراتيجيات العسكر والشرطة فشلَها وقصورَها بل وتقاعسَها في أحيانٍ كثيرة. والأمرُ ذاتُه ينطبق على الجانب الخدمي الذي فقدَ قاعدتَه الأساس من المحترفين والمهنيّين بسبب مزاحمتهم من قبل القادمين الجدد الذين استوطنوا معظم دوائر الدولة وهم فاقدو الخبرة العملية والرؤية الخدمية والعلمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. والحكومة الحالية ايضًا، وُصفت أكثر من مرّة بحكومة أزمات، لازمتها في مسيرتها، ومهما حاولت بتقديم حلول ترقيعيه لتهدئة النفوس وجبر الخواطر، فهي لن تستطيعَ رأب الصدع، لأنّ الشرخَ كبيرٌ بعدَ أن وصلَ حدّ العظم وقطعَ الأرزاق! والحالُ هذه، لم يبقى من هدفٍ، سوى طرح مثل هذا المشروع لأسبابٍ انتخابية بحتة، أو لتلطيف الأجواء ومجاملة أطرافٍ تحرّجت الحكومة الحالية إزاء ما تعرّضت له مكوناتُ مناطقهم من مآسٍ وويلات ومصائب لم يشفعْ معها غيرُ فتح هذه النافذة للتخلّص من ضغوطٍ قديمة أو قادمة أخرى. ولو كان الوقتُ مناسبًا، لَما لقي مثل هذا المشروع ردودًا متباينة صبَّتْ معظمُها جامَ غضبها على الحكومة وتوقيتها بسبب انتقائها الطائفيّ، كما أفرغَتها من فرحةٍ طالَما سعى إليها أبناءُ تلك المناطق، ولاسيّما البسطاء منهم وأصحابُ الرأي المتذبذب والفكر السطحيّ الذي لا يفقهُ ما ستؤول إليه مناطقُهُم، جغرافيًا وديمغرافيًا وتاريخيًا بموجب الأجندات الموضوعة لكلّ منطقة، فيما لو تحققت مثل هذه الطروحات. ألعلَّ الخاسرَ الأكبر في مثل هذا المشروع وفي هذه الفترة بالذات، هو العراق، بسبب تفتيت أرضه وتقويض وحدتِه وتجزئة شعبِه وتمزيق نسيجه بهذه المشاريع الطائفية المستحدثّة! إذ سرعانَ ما انتفضت مناطقُ أخرى مطالبةً بمثل هذه الاستحداثات غير الموفقة في هذه الفترة العصيبة، والعراقُ يخوض امتحانًا عسيرًا في محاربة آفة الإرهاب التي استفحلتْ بالمنطقة الغربية على مرأى ومسمَع وبعلمٍ ودراية من الحكومة المركزية والساسة الغافلين أو المتقاعسين في الشراكة الوطنية طيلة أكثر من سنة. وبإحالة ملفّ تلعفر إلى مجلس النواب للمصادقة على تحويله إلى محافظة بعد نموذج حلبجة، وبصدور الموافقة المبدئية على استحداث محافظات طوزخرماتو والفلوجة وسهل نينوى، يكون الساسة قد أوغلوا بإشعال نار الفتنة الطائفية، فيما المواطنُ وحدهُ فقط هو الذي يتحمّلُ أوزارَها الكارثية. هم يدّعون محاربة الطائفية، ولكنّهم، همْ أنفسُهُم مّنْ يُصلي نارَها ويحرّك هشيمَها بلا هوادة، بحيث لم يركنْ بالُ العراق وأهلِهِ منذُ دنّسُه الغازي الأمريكي وفعلَ به قباحتَه وأنزلَ عليهِ شرورَه ولمْ يشأ البتة كفكفة دموع الثكالى والمرضعات ووقفَ نزيف الدمّ الذي بدأه منذ أيام النظام البائد بتشجيع دخولِه حروبًا كارثية حتى احتلالِه في 2003 نتيجة حماقاتِه المتكرّرة. نكتة المرحلة والحالُ هذه، وبشيءٍ من الفكاهة والتندّر، يرى البعض أن العراق وساسةّ العراق، قد يلتزمون في النهاية، الدستور الأمريكي نموذجًا في رسم مستقبلِه ليصل بعدد محافظاته عددَ الولايات الأمريكية أو قد يتجاوزها، إذا ما أُضيفت إلى المطالبات الرسمية الخمس الحالية، طلباتٌ شعبية أخرى حرّض عليها سكانُ عدد من المناطق مثل مدينة الصدر والأعظمية والكاظمية وربما لاحقًا، الكرادة والزعفرانية والشعب والمنصور بغية الانفصال عن مركز العاصمة مثلاً، ومدن وقصبات غيرُها مثل خانقين وسنجار والرفاعي والشطرة والمسيّب والعزيزية وسوق الشيوخ. ومَن يعلم، فقد تلحقها مناطق مرشحة أخرى لأسبابٍ عرقية وطائفية ودينية أيضًا، مثل راوة وعانة وكلك ياسين والكوفة ومنارة شبك وعلي ره ش الشبكية وربيعة الشمّرية والصقلاوية وأبو غريب وزاخو وسنونو وقلعة سكر ومخمور والشرقاط والحويجة وبرطلة والشيخان وباعذرا وراوندوز والدير والزبير وربّما غيرُها ممّن قد تدغدغهم فكرة الغيرة ذاتُها. وفعلاً، فقد هدّدَ سكان عددٍ من هذه المدن برفع مثل هذه المطالب إلى السلطات العليا. كما صدرت تهديدات من مسؤولي عدد من المحافظات بتحويلها إلى أقاليم في حالة إقرار استقطاع مناطق منها وتحويلها إلى محافظات جديدة، بوعيٍ أو من دونه. ومهما كانت الدوافع لهذه الأخيرة، فإنّها تصبُّ في خانة رفض إحداث تغييرات ديمغرافية بهذه الصيغة الطائفية، لكونِها عاملاً في إضعاف صلة المواطنة وخطوةً نحو تجزئة وتفكيك البلد إلى دويلات هزيلة داخل دولة، هذا إن كان سيبقى لدولة العراق من هيبة، فيما لو نُفّذت هذه جميعًا. وهذا ما يريده الأسياد في هذه الحقبة العصيبة من تاريخ العراق المتهرّئ. ألمْ يقوّضوا دولة يوغسلافيا المتحدة بعد إدخالِها في صراعات دينية وطائفية وعرقيّة وحوّلوها إلى دويلات هزيلة وضعيفة كي يسهلَ التحكّم بها وتوجيهها بحسب رغبة الأسياد؟ فهلّا نتعلّمُ الدرس؟ أمْ رغبةُ الأسياد أمرٌ غيرُ قابل النقاش؟ فلو كان شعبُنا العراقيّ أبيًّا مثلَ شقيقه المصري، لقالَ بصوتٍ واحد:" لا" لهذه المهزلة! قد يكون ذلك مضحكًا فعلاً، ولكنْ فيه من النكتة ايضًا ما يبكي، إذا سار الأمر على هذا المنوال دون الالتفات إلى الأسباب الحقيقية للفوضى والإرباك الشعبي والأمني والسياسي التي رافقت هذه المطالبات والمقترحات. ولنتحدّث بصراحة أكثر، هل شقّت هذه المقترحات طريقَها في دواوين ومكاتب مجلس النواب الذي ائتمنَه الشعب على مصالحِه قبل أن يتخذ مجلسُ الوزراء قرارَه؟ وهل تمّ التداول بصددها بين الناس وعقلائها ووقفوا معهم على فرز السالب لدى تحقيقها عن الإيجابيّ بحصولها، كي تكون هذه المطالبات ناضجة قدرَ المستطاع؟ أمّا أنْ يتخذه الأخير ويحيلَه إلى نواب الشعب، فهذا قصورٌ من ممثلي هذا الشعب، ودليلٌ على التقاعس في حقوق مَن انتخبهم لمتابعة أوضاع مناطقهم وتطويرها ودراسة احتياجاتها والبحث عن أسباب تخلّفها، بعد إيصالهم إلى قبة البرلمان. كما ينمّ عن شمّ رائحة مساومات واتفاقات وتمريراتٍ من خلف كواليس السياسة بين الخصوم الذين لمْ يكتفوا بعدُ مِن نهب قوت الشعب البائس وتحويل ثرواتِه في حسابات أجنبية عبر صفقاتٍ وعقودٍ ومقاولاتٍ لا تخلو من الوهمية والفساد، وإلاّ لكان البلد قد وجد طريقَه إلى الحداثة والتطوّر وإلى الأمن والأمان وحسن الأداء في مؤسساته الهزيلة المتعبة وفي نوعية الخدمات التي يقدّمها وفي مشاريع التنمية الفاقدة لاستراتيجياتها. ودليلُنا إلى ذلك، التخبّط وعدم اتفاق الساسة على مفردات رصد الميزانية العامة لغاية اليوم بالرغم من ضخامتها، وذلك بسبب أبوابِها الغامضة أحيانًا ووسائل صرفها الموجهة في غالبيتها للجانب التشغيلي وليس الاستثماري الذي يبني ويعمّر ويخدم ويُصلح، وكأنّي بهم وحوشًا كاسرة وهي تنقضُّ على فريستها. ولو سعى الساسة والحكومة الحالية إلى منح مزيدٍ من اللامركزية في إدارة شؤون هذه المحافظات والمناطق، لما اضطرّت هذه إلى التمرّد والعصيان والمعارضة. إنّ عهد الدكتاتوريات قد ولّى إلى غير رجعة، وجديرٌ بالجميع احتواء الأزمة برؤية وطنية ووضع المصلحة العليا للوطن ووحدته قبل كلّ مصلحة ضيّقة قد يستخدمُها البعض لدعاية انتخابية رخيصة أو لكبح جماح المعارضة التي لم تعدْ تطيق الصبر والاصطبار والانتظار المرير بفرجٍ ربّانيّ عجائبيّ. فقد طفح الكيلُ وبلغَ السيلُ الزبى! في الأخير، لنتساءل: لصالحِ مَنْ، كلُّ هذه التحرّكات غير الحكيمة وهذا الحراك التشظوي الذي يبدو في غير أوانِه؟ - للمقال صلة- لويس إقليمس بغداد، في 28 كانون ثاني 2014
دروس في الحياة لا يفقهها تجار الشعوب كثيرة هي التجارب والدروس التي تمرّ على بني البشر أو تلك التي تعيشها الشعوب. لكن العبرة فيمن يعطي لنفسه الفرصة للتعلم منها والاقتناع بأخذ المفيد فيها من أجل حياة أفضل، له ولغيره من الخلق. إلاّ أن مصيبة العرب خاصة ودول منطقة الشرق عامة، قد ابتليت ببشر تتحجر عقولهم وتنغلق بصائرهم لكل ما هو منطقي وآدميٌّ لدى غيرهم من الأمم والشعوب المتحضرة، لسبب أو دونه. أحوال العرب اليوم ما يجري اليوم، في عدد من دول المنطقة وما شهدناه منذ اجتياح السيادة العراقية في 2003، من تزمّت وعنادٍ لدى عدد من قادة وزعماء هذه الدول المطالَبين بالتنحي عن السلطة والزحزحة عن الكراسي التي قيّدوها تأبيدًا، لهم ولذوي قرباهم وحاشيتهم، هو عين التخلّف والاستبداد والاستهانة بإرادة شعوبهم المغلوبة على أمرها. لقد شاء هؤلاء "المتأبّدون"، أن ينصّبوا أنفسهم سلاطين مدى الحياة ومتسلطين على رقاب شعوبهم، غيرَ مقرّين بثقافة متحضرة لتداول السلطة سلميًا، التي من جملة منافعها، فسح المجال للغير كي يقدموا عطاءَهم ويعرضوا ما عندهم من كفاءات عملية ومزايا إدارية ومن خبرات في الحياة قد تختلف عمّا لدى هؤلاء الزعماء المتقادمون الذين توقفت بهم عجلة الإبداع وبطلت عندهم الحكمة المطلوبة والكفاءة في التفاعل مع الأحداث وفي تصريف شؤون البلاد والعباد. تشير الدلائل، أن معظم هؤلاء الزعماء، إن لم يكونوا جميعًا، قد استخدموا ما لديهم من أحكام قمعية وسلطة مطلقة في قيادة شعوبهم طيلة فترة تولّيهم السلطة، ومازالوا على هذه الحال، رغم أنهم قد فقدوا كل مصداقية في التعامل السويّ والإنساني مع شعوبهم، ما أفقدهم بالتالي شرعيتهم. وفي اعتقادي أن أحد أهم أسباب هذه الإشكالية، هو الخلفية الدينية والقبلية وربما التربوية والاجتماعية والعلمية أيضًا، تلك التي نشؤوا فيها وعليها، والمتمثلة بقِصَر نظرهم حول الأحداث و رفض الإقرار بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب واحتياجاته المتناغمة مع تطور الحياة ورقيّها. ناهيك عن العمى، المصابون به بسبب الحضور الدائم ل "الأنا الذاتية" التي استفحلت في سلوكياتهم وما يلحق تلك، من أشكال الطمع والعجرفة وحب الدنيا والسلطة والجاه والمال، ممزوجة أحيانًا بداء "جنون العظمة" المقيت وهوى السلف في إطاعة السلطان، حتى لو تجبّر وفسقَ وشطح عن الحق. وهذا في حقيقة الحال كما يبدو، جزءٌ من تركيبة الفكر العربي والشرقي التي لم تستطع شعوب المنطقة تجاوزها، بالرغم من تغيّر الأحوال وتطوّر الحياة وما فيها. فهذه الفئة، كلّما تقدم أصحابُها في العمر، تقادموا في الخبرة واستنفذوا الكفاءة والعطاء والحكمة معًا، وتشبثوا أكثر في حب السلطة والجاه والمال وأنواع الفساد والموبقات، والأنكى من ذلك في الولوج في دياميس الدكتاتورية التعسفية التي لا تؤمن ولا تعتقد إلاّ بكفاءتهم وحكمتهم وحدهم فحسب. وأمثالُ هؤلاء لا يقرّون البتة، بثقافة تداول السلطة وانتقالها السلمي، وكأنّ كراسي حكمهم، قد سُجّلت بأسمائهم إلى أبد الآبدين، كراسيَ تمليك في الشهر العقاري، بل وأكثر من ذلك، أن بعضهم يجيز لنفسه توريثها لأبنائه من بعده! إنها قمّة الاستخفاف بالشعوب وبإمكاناتها وفي حقها في حكمٍ رشيدٍ ووفق أساليب حضارية تتحكم فيها صناديق الاقتراع ورضا الله والشعب. إنتفاضة مشروعة وثورة مدعومة لقد انتفض المواطن العربي في ثورة، هي من حقه منذ زمن، لأنه ببساطة إنسانٌ خلقه الله كائنًا حرّا جميلاً، سيّدًا وغير ناقص، على صورته ومثاله، سواءً كان ذكرًا أم أنثى. فالخلق سواسية لدى الله، خالقِ الكون والبرايا والبشر منذ الأزل وإلى يومنا هذا. كما أنه، ليس من حقّ أي كائنٍ بشريٍّ الانتقاص من أخيه وجاره ورفيق عمره، لأنه ببساطة، مخلوقٌ على شاكلته وفق مشروع الخلق الإلهي الذي يتيح له الحق المشروع في حياة حرةٍ كريمة، ينشد فيها الاستقرار والعدل والمساواة والرفاهية في إطار نظام عادلٍ في الحكم والحياة. ولمّا كانت ثورة الشعوب على الظلم والطغيان والفساد وكلّ أصناف التعسف في الحكم والحياة، هي من حق هذه الشعوب المبتلاة بهذا الصنف من القادة والرؤساء المتسلطين، فما على المتنوّرين والمتحضّرين من الآدميين الحريصين على احترام خلق الله، إلاّ أن يؤازروا هذه الثورات ويساندوا القائمين بها وعليها، لأنهم أصحاب حق. ومن لا يفعل ذلك بما أوتي به، فهو على باطل، مهما ادّعى من أسباب الشرع والشريعة والقوانين التي يفتعلها ويستنبطها ويفتي بها لسند موقفه المغالط. أمام السيل الجارف من المطالب المشروعة للثائرين على الرؤوس الدكتاتورية، وقفَ الشرفاءُ من بني جنس هذه الشرائح المتنوّرة الثائرة وغيرهم من الساندين لها، من شعوبٍ وأصولٍ وطبقاتٍ وفئاتٍ متغايرة، وقفة المؤيّد والساند لحق هؤلاء البشر في العيش بكرامة وأمان في بقعة وضعتهم الأقدار في كنفها، ليكونوا ضحايا تقليديين لأنواع عديدة من الاستغلال السياسي والمادي والطائفي والمذهبي. لقد كان لتأييد مجمل الانتفاضات التي حصلت في عدد من الدول العربية - والبقية ستلحقها بإذن الله-، صداهُ الواسع في فتح أعين الناس على حقيقة حقوقهم المشروعة التي ظلّت أسيرة تقاليد بالية والتزامات شرعية غير عادلة وقوانين ردعية ووضعية غير مقبولة إنسانيًا ومجتمعيًا ودوليًا. لكن الظلم، عمره لم ولن يدوم، طالما هناك من يبحث عن التنوير ويسعى لتحرير القيد المنغلق الذي أسرته به هذه القوانين وهذه التقاليد وغيرها من الأصوليات التي لم تعد تنفع مع التطور البشري ونماء الفكر الإنساني والتنمية المستدامة التي تسعى إليها البشرية المتحضرّة جمعاء. وداعًا للستار الحديدي لقد كانت وقفة العالم مشرّفة لاسمه تعالى ولاسم الحق والعدالة، في تأكيده على حق خليقة الله بالعيش بحرية وكرامة، أينما كانت ومتى أرادت ذلك، دون منّة من أحد، لأنها ببساطة، صنيعة الخالق الجبار، الشديدِ بأسُه على المستكبرين. كما لهذه الشعوب المظلومة، قِدمُ التساوي مع باقي الخلق، في الأرض والحياة والرفاهة، وفي كل ما من شأنه أن يسهّل الحياة وسبلَ عيشها دون صعوبة. لقد خبر العالم الغربي مثل هذه الانتفاضة، بل مثل هذه الثورات العارمة التي استمدّت قوتها من عزيمة الشعب الحريص على أرضه وعرضه ووطنه وأهله وجاره، من شرور القريبين والبعيدين. من هنا كان تذكير بعض العقلاء بما حصل مع انتفاضة حقبة الثمانينات في أوربا، حين نفضت شعوبُها غبارَ سنوات عجاف من سطوة الشيوعية البغيضة ومن أساليبِ قادتِها الطغاة الذين استخدموا كل أساليب الترويع والتخويف والترهيب ضدّ شعوبهم سحابةَ سنين. لذا لم يكن أمام تلك الشعوب في نهاية المطاف، وبعد أن بلغ السيلُ الزبى، إلاّ أن يلفظوا هذه الحشرات الضارة ويعملوا على طردها والتمكّن منها، في أقرب فرصة أُتيحت لهم، ففعلوها دون تردد، حين أسقطوا الستار الحديدي إلى الأبد. ما حصل ومازال يحصل اليوم وغدًا، هو بالتأكيد، تشبّهٌ سليمٌ لما حصل لتلك الشعوبٍ التي سبقتنا في هذه التجربة المباركة، بل إنه يؤشّر إلى تطوّرٍ صحيح في العلاقات الإنسانية في الاستفادة من تجارب الغير. وهو أيضّا، استمرارٌ لما يمكن اعتباره صرخةً حق بوجه الباطل وضدّ أساليب القسوة والعنف والجور غير المبرّر الجاري بين البشر. وهذا أمرٌ طبيعيٌّ للغاية. فالشعوبُ عندما تصل حدّا من الوعي المقبول، تتمثّل بتجارب الغير لتأخذ منها ما ينفعها وتلفظ ما تراه غير مقبولٍ لديها. لقد أعجبني تصريح فاسلاف هافل، الرئيس التشيكي السابق، وداعية حقوق الإنسان والمدافع عن الشعوب المغلوبة وعن الديمقراطية، حين تحدّثه مرّةً إلى صحيفة "سي تي كي" الجيكية، أن (هناك حدودّا دنيا لمعايير ثقافية عامة مشتركة بين كل الشعوب في ارتكانها إلى الأخلاق الأساسية وإلى الأسس في تطبيق السياسات العامة للحكومات. كما أن ما يحصل اليوم في المنطقة العربية، لا يختلف عمّا شهدته بعض دول أوربا، ولاسيّما الشرقية منها حين كسرت "طوق الستار الحديدي" والتحقت بركب الديمقراطية الذي تخلّفت عنه). إن هذا الحديث عن "االستار الحديدي" الذي حطّمته شعوب أوربا بصحوتها الإنسانية مع السنوات الختامية للقرن المنصرم، قد وضعت بلدانها وقادتها على المسار الإنساني والبشري الصحيح. وفي اعتقادي أنّ ذات الشيء، بدأت تسعى إليه شعوب منطقتنا التي اكتوت بنيران حروب أزلية وابتليت بسلاطين وزعماء وملوك لاتهمّهم مصالحُ شعوبهم ورفاهيتُها، بقدر ما تسعى وتعمل على ترسيخ التسلط وتثبيت سبل مبتكرة للقمع، من أجل البقاء في الحكم ما طاب لها وما تيسّر. لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أنّ ما له بداية، لابدّ أن يكون له نهاية في زمن ما وفي مكانٍ ما. إنها صرخةُ حق، أطلقها روّاد الإنسانية ومدافعو حقوق الإنسان في كل مكان وفي كل بلد وفي كل مجتمع في هذه المنطقة المبتلاة. هي صرخة مدويّة أيضّا تدعو للتخلص من الزعماء، من ناشري الظلم والفساد والتسلّط، الذين استخفوا بشعوبهم غير مبالين بقدرات هذه الشعوب متى فاقت. هي صرخة حق بلا حدود، فيها انتفض الناس على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم ومكوّناتهم، ضدّ من سرقهم وتآمر وكذب عليهم، وضدّ من حكمهم طيلة هذه السنوات العجاف بعصا من حديد. وهي لن تخمد حتى تحقيق المآرب العادلة وفرض سلطة قانون مدنيّ عادلٍ يساير التطور البشري ويراعي شرعة وقوانين حقوق الإنسان ولا يحصرها في زاوية تداعياتٍ شرعيةٍ ضعيفة الحجة يحشرها أمثال هؤلاء المغالين بمبدأ جواز "تولّي السلطان على الشعوب كما شاء"، حتى لو ترتب على ذلك جبالاً من الظلم والقهر والفساد بسبب اتباع هذا المبدأ الناشز. إنه لمجرّد رؤية انتفاضة هنا وإضراب هناك ، أو اعتصام في مكان غيره، فهذا دليلٌ على وجود ظلمٍ، من أيّ نوع كان. فلو لم يشعر هؤلاء المضربون أو المعترضون أو المعتصمون بشيء من الذلّ والإهمال والتهميش، لما كانوا انتفضوا أصلاً. ومَنْ يشعر بما فيه كفاية من اطمئنان ورفاهة واستقرار، في حياته ولأهل بيته وعشيرته وبلدته ووطنه عمومًا، ليس بحاجة للشحن والإثارة وتعليمه كيف يعترض ومتى ولماذا. فما اعتراضُ بعض النخب المتنورة في العالم العربي ومعه عراق اليوم، سوى دليلٍ على وجود مسارات وإجراءت وتصرّفات غير مقبولة في أجهزة الحكم، تكاد تقضّ مضاجع المواطن، أيًا دان دينُه أو لونُه أو مذهبُه. لذا، واستنادًا لأصول احترام حقوق الغير، حتى لو اختلفوا في الدين أو المذهب أو الطائفة أو اللون أو الإثنية، فهو يستلزم تعلّم درسٍ في الحكمة والآداب والأخلاق في احترام الغير. فالدنيا دوّارة، وما نحن عليه اليوم، قد ينقلب بين لحظة وغيرها. فهل يرتكز الحاكم إلى مبدأ الحمة في حكمه كي يتحاشى ما قد يلقاه بوم غد؟ تركة ثقيلة للحربين العالميتين إذا كانت مقارعةُ رؤوس الأنظمة الفاسدة في بلاد الشرق عامة، وفي بلاد العرب بالذات، قد دعت إليها قيادات متنورة في المجتمعات، فإنّه لا ينبغي وأدُها والتشويش عليها أو تحجميها أو تجاهلها. بل هي تتطلب من كل الشرفاء دعمًا وتأييدًا وتأليبًا للرأي العام من أجل تنوير المنطقة ووضعها في الإطار الصحيح للعلاقات الإنسانية مع شعوبٍ سبقتنا في هذه المحنة، وكانت هي الأخرى ضحية حروب عالمية فتكت بالملايين من أبنائها في القرن الماضي. ومن هذه الشعوب، علينا تعلّم الدروس الضرورية من أجل حياة أفضل، أكثر عدلاً وسلامًا ورفاهةً. فقيمُ الديمقراطية الحقيقية، لابدّ أن تنتصر وننتصر لها، مهما كان الثمن، لأن الأوطان لا تُبنى إلاّ على تضحيات أبنائها وتصرّفهم الصحيح والناضج إزاء الأحداث، وبشيء لا يخلو من الرويّة والصبر والثبات والتواصل وديمومة النضال ضد كل أشكال التخلّف والعنف والظلم والقهر والفساد المستشري في مفاصل حكومات المنطقة قاطبة، مهما كان وأينما كان وأيًّا كان المقصود بها. وفي اعتقادي، أن مجمل هذه الأحداث التي عصفت بأوربا نهاية القرن الماضي وانتقلت عدواها، إلى شعوب عربية في المشرق العربي ومغربه، هي نتيجة تراكمات الحرب العالمية الثانية والتي ما قبلها، وما خلّفتاهُ من تركة ثقيلة آنذاك. وما تزال المنطقة والعالم كلّه يعاني من تراكماتهما وآثارهما المدمّرتين حتى يومنا هذا. وهناك من لا يستبعد، أحداثًا دراماتيكيّة ومصيريّة قد تشهدها المنطقة برمّتها، إن لم تكن قد دخلت في معتركها منذ زمن، ومعها ربّما العالم كلّه، بسبب قراءتنا لأحداث وتطوّرات لاحقة. وهذا أمرٌ مفروغٌ منه، حسب وجهة نظرنا. لذا يكون سؤالنا، ما إذا كنّا سنشهد خطوة قادمة في ذات الاتجاه، يمكن أن تأتي بنذير شؤمٍ محتملٍ أو بكارثة قادمة وراء مجمل هذه الأحداث المصيرية والدموية في بعضها. فهل ستكون حربًا كونيةً ثالثةً لا بدَّ منها؟ أبعدها عنّا الله! الحذر واجب مع كون ما تشهده المنطقة من انتفاضات ومظاهرات واحتجاجات، هي حالة صحية في مسار الشعوب وتاريخها، إلاّ أنها، قد لا تخلو من متغيّرات غير متوازنة وغير متوقعة من حيث خروجها عن المسار الصحيح الذي جاءت من أجله. وهنا كان ينبغي مراقبة الأمور والأحداث بكل عناية، كي لا تخرج هذه الانتفاضات والتظاهرات والاعتصامات عن أهدافها وغاياتها المشروعة في محاسبة الفاسدين والمفسدين وفي محاكمة الطغاة والظالمين وسالبي حقوق الشعوب، وفي المطالبة بحقوق متساوية، وفق القوانين المرعية والدساتير، كي يعود الحق إلى نصابه ويتمتع المواطن بحريته ويعيش كما تحتمه عليه إنسانيته على وفق الأعراف الدولية والديمقراطية التي ينبغي أن تكفلها دساتير البلدان المتحرّرة والمتحضّرة. وهذا الخوف مشروع، في إمكانية تسلّل عناصر تحمل أفكارًا أكثر تطرفًا وتشدّدًا لتعمل على إسقاط ما تحمله من تخلّفٍ بأفكار أصولية متسيّدة على الساحة العربية عامة في هذه الأيام الصعبة، وتعمل على فرضها بأساليب ملتوية عديدة، على الجماهير المنتفضة المكسورة الخاطر، التي قد تتراجع في غفلة منها، وفي ضوء التخويف الديني والترهيب الشرعي والإفتاء الجارف، لتسلب منها هذه الصحوة وتسرق هذه الثورة، فتضيع جهودها سدًى، وكما يقول المثل " كأنك يا زيد ما غزيت". إنّ الخوف، كلَّ الخوف، إذا اندسّت عناصر غريبة على التركيبة الوطنية لأيّ بلدٍ وتسلّلت متذرّعةً بأية حجج أو تبريرات خارجة عن أخلاقيات وطبيعة الحياة المواطنية التقليدية لتلك الشعوب. فمثل هذه التدخلات، ستكون قاتلة، لأنّ البلد يبقى ساحة مفتوحة لكلّ من هبَّ ودبَّ ودون وعيٍ، من أجل تحقيق غايات وأهدافٍ ليست ذات صلة بإصلاح الوطن والمواطن أو بتطوير البلاد وتحسين وضع أهلها وشعبها. وهذا الخوف، هو ما حصل، في ثورات الشباب في عدد من الدول العربية مؤخرًا، حين تدخلت عناصر دخيلة وحاولت أن تسرق ثورتًهم، إن لمْ تكن فعلاً قد سرقتها وجيّرتها لنفسها وجلست على الحكم، رغمًاعن أنف القائمين الأصلاء على تلك الثورات. أما ما يحدث اليوم في سوريا الجريحة، فهو انتحارٌ أخلاقي وأدبيٌ وإنسانيٌّ بامتياز، بعد أن أضحت ساحة مفتوحة للمغالين والدخلاء، اصحاب النفوس الضعيفة والسيافين وأكلة لحوم البشر والفاسدين والمفسدين في الأرض. ومن المؤسف حقًا، أن تنتصر شعوبٌ متحضرة مثل أمريكا وعدد من الدول الأوربية التي تتشدّق بحقوق الإنسان وحرّية الإنسان، لأمثال هؤلاء القتلة وتدعمهم بالمال والسلاح، من أجل المزيد من إراقة الدماء البريئة، وإطالة حرب تدمير البلدـ عوض أن ترتكن إلى حلولٍ أكثر حكمة واتزانًا من شأنها وضع حدّ للمأساة بكلّ معانيها. حصة العراق لم يكن بلدنا يومًا، خارج هذه الخارطة أو خارج هذه التراكمات. لقد تآكلَ عراقنا ومعه قيمُه المجتمعية والوطنية بفعل فاعل، فضاع فيه الشعب بين فساد واستبداد الحكام السابقين واللاحقين ووسط نواياهم القومية والطائفية والذاتية والمذهبية وبين نوايا الغازي الجديد، الذي استقدمته حماقات النظام السابق ليحطّ رحاله فيه، بعد أن كان الأخير قد رسم وخطّط له بكل عناية للنيل من نسيج شعب عريق الحضارة وغزير الثروة. لكن عيبَ شعبنا أنه متقلّب المزاج، وسريع الغضب والحنين في آنٍ واحد معًا. وتلكم، معادلة غير سهلة العلاج، ما لم تسلم النوايا ويُزال عن كشح الجهل وأصناف الممارسات المتخلّفة التي لا تتوافق مع أهداف المشروع الوطني الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى الجميع لبنائه بعد الذي حصل. فهل من الحكمة مثلاً، تعطيل دولة بكاملها، لأيام عديدة بحجة اللحاق بممارسات هي في الأصل أن تكون ضمن علاقة محصورة بين الخالق والمخلوق؟ وهل من المقبول أن تسيء قوات الأمن التصرف، وأمام مرأى أجهزة الدولة ومسؤوليها، حين تنهال على متظاهرين مسالمين وتهاجم تجمّعاتهم، فيما جلُّ مطالباتهم توفير الخدمات الأساسية والمطالبة بمحاكمات عادلة لبشرٍ زُجّوا في دهاليز السجون دون دراية السبب وراء مثل هذا التصرّف، أوطلبُ لقمة عيش شريفة، أوتوفيرُ فرص عمل لحشود مؤلفةٍ من العاطلين الباحثين عن عمل يوفر لقمة العيش لأسرهم؟ أين هذه الممارسات من الديمقراطية التي تتبجح بها أجهزة الدولة، أمام وسائل الإعلام وأمام العالم الذي اكتشف زيفها وبطلانها؟ واين كفاءة الأجهزة الأمنية التي تدّعي الحرفيّة والخبرة في الاستمكان والانقضاض على الهدف قبل تحرّكه؟ إننا نعتقد، أنه لابدّ أن تشمل صحوة الشعب في العراق أيضًا، شيئّا كثيرًا من الحكمة والرويّة والشجاعة في آنٍ معًا من جانب الطرفين، من أجل الحدّ من مثل هذه الممارسات غير الديمقراطية، وغيرها كثيرةٌ، من التي لا تقدّم المجتمع، بقدر ما تعمل على تباطؤه وتخلّفه عن الركب الحضاري الذي يستلزم تحقيق أفكار جديدة متنورة. كما تتطلب الحالة، البحث عن وسائل آنيّة، أكثرَ رصانة وجدّية في التعامل مع هذه المطالبات المشروعة من أجل البدء الفوري بتطبيقها بكل جدّ وإتقان وعدم التسويف بها وفي محاسبة الجهات المتلكئة والفاسدة والسارقة لقوت الشعب، دون مواربة أو إبطاء أو مجاملة على حساب راحة المواطن واستقراره وأمنه وصيانة كرامته وحرمته. لقد عبّر الشعب العراقي، مثل غيره من الشعوب الرازحة تحت نير الفقر والتسلّط والفساد، عن عمق تفاعله مع الحدث في المنطقة، رغم أنه قد سبق هذه الشعوب في ذلك ، في بداية حقبة التسعينات من القرن الماضي. وهو إن لم يكن قد أفلح آنذاك، فبسبب عدم نضوج التجربة وافتقاره إلى قيادات متنوّرة تشعر بحق الشعوب المقهورة وبقدرتها على التغيير إن عقدت النيات وعزمت عليها. لقد كانت خيبة الأمل كبيرة من لدن الجهات الحكومية الرسمية بتصدّيها للمتظاهرين وبالطريقة التي لمسناها وشاهدناها على شاشات الفضائيات التي تنقل أحدث "جمع الغضب" العديدة من مواقع مختلفة في معظم محافظات العراق ومدنه، ناهيك عن خيبة الأمل في تغاضي الإعلام الرسمي آنذاك، وتجاهله لدقائق الأحداث وتواصلها في نقل جميع أحداثها للملأ، إلاّ من مقاطع مقتضبة لا تمثل حقيقة الأحداث برمتها وطبيعتها ومسيرتها. وهذا ما لوحظ حتى في وسائل الإعلام الأميركية التي تتجاهل الأحداث أحيانًا، تكاد تكون بصورة شبه كاملة، حين لم تزعج نفسها في نقل ما يحدث في مدن اشتعلت فيها مطالبات الناس واحتجاجاتهم وثوراتهم على مكامن الفساد والدجل والكذب، إلاّ ما ندر وبما يُخجل. فهذه الأخيرة، كما يبدو، لا ترضى لنفسها أن يكون مصيرُ مشروعها الديمقراطي الهشّ المزعوم في العراق، هو الفشل. لذا ارتأت تجاهل مطالب الشعب وتغافلت عن نقلها بقصد وعن سابق إصرار. ونؤكد أنّ موقف الحكومة المتردّد أحيانًا، من هذه الاحتجاجات، قد بدا هو الآخر، متأرجحًا بين التجاهل والخوف معّا ممّا قد يحصل. فالدولة عندنا تعلم حقّا، عندما ينتفض الشعب العراقي، ما يمكنه أن يفعل، ولنا في ذلك تجارب ثورات عديدة في القرن المنصرم. كما أنها كانت قد استبقت الأحداث، فاتخذت أساليب التخويف والتخوين والتحذير بحجّة تسلّل عناصر بعثية وإرهابية لتنفيذ أجندات معينة. وهي حشّدت لذلك حتى المرجعيات الدينية، كي تساهم هي الأخرى، في حمل الناس على عدم الخروج والمشاركة في تلك المظاهرات. لكن الأحداث، وما رُفع من مطالب وفي الملصقات وحتى في نوعية المتظاهرين، أثبتت زيف تلك الادّعاءات ووهنها ودجلها. فالحشود التي نزلت إلى الشوارع وطافت بملصقاتها، لم يكن همّها في الأول، إسقاط الحكومة والثورة عليها، بل انحصرت مطالبها في رفض مبدأ الطائفية المقيتة المعتمدة في الحكم، وفي محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمرتشين الذين تتستّر عليهم الحكومة وفي إزاحة المسؤولين غير الأكفّاء في مختلف المرافق الخدمية وفي توفير الكهرباء وتأمين مواد البطاقة التموينية التي تعطلت بسبب فساد وزارة التجارة وغيرها من الخدمات والطلبات الأساسية لشعب يعيش أكثر من نصفه تحت عتبة الفقر، رغم أنه يطفو فوق بحيرة من ذهب. كما أن موقف الحكومة السلبي من وسائل الإعلام المتنوعة، قد أثبت فشله في التعامل الديمقراطي مع الحدث. ومجمل تلك الممارسات، قد أكدت زيف الديمقراطية التي تتبجح بها، حين إغلاقها جسورًا رئيسية وشوارع وأحياء كاملة، بوجه المتظاهرين وانهيال الأجهزة الأمنية بالضرب على حشود المتظاهرين أحيانًا، ومنهم الإعلاميين الذين ينقلون أحداث الانتفاضة الشعبية المشروعة. لقد قالها الجميع، أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع في الدستور. لكن هذا الحق قم تم اغتصابه والعبث به، من قبل جهاتٍ تولّت مراقبة الحدث بيد من حديد. وتلك صورة أخرى عن حقيقة الحكومة غير الديمقراطية التي تحكم العراق، وهي لا تختلف في حكمها هذا عن تصرفات النظام السابق في اتّباع ذات الأساليب الدكتاتورية في التعامل مع مطالب الشعب وفي الاستجابة لها. وقفة إجلال لصوت الحق خلاصة الكلام، نقول للشعوب المناضلة من أجل استعادة حقوقها في العيش الرغيد الكريم، أننا نكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وهي تستحق الثناء وتلقّي الدعم من كل حرٍّ شريف. إن طريق النجاة من كل ظلم وتعسف واضطهاد، ليس سهلاً، بل هي طريق محفوفة بالمخاطر والأشواك والعوسج. ولكنها سبيلٌ لابدّ منه من أجل تحقيق الذات ونيل الحريّة والعيش في أجواء الديمقراطية الصحيحة وغير المغشوشة، التي يتظاهر بالمنّ بها، قادةٌ متاجرون بشعوبهم. إن هؤلاء لا يفقهون معنى الحياة الإنسانية الحرة ولا سبل العيش تحت كنف الحرية الغريزية التي وُلد عليها جميع البشر. لذا، فإنّ تقاعسهم واردٌ، في السعي للارتقاء بشعوبهم وأوطانهم على حساب المصالح الذاتية الضيقة. أمّا سبيل الديمقراطية الصحيح والجلوس على طاولات الحوار الدائم، فهو الضمانة الوحيدة لاستقرار البلدان وتطور شعوبها وتنميتها المستدامة بما يخدم الإنسان، وهو الغاية في هذا النضال. وعلى من يتشيث بسلطة نالها في غفلة من الزمن أو حتى بحق مكفول، عليه أن يتذكر، أنها "لو دامت لغيره، ما كانت آلت إليه". فالذي خلقَ من هذا الشخص مسؤولاً أو حاكمًا أو زعيمًا أو رئيسَ دولة أو خليفةً، قادرٌ أن يخلق غيره أحسنَ وأفضلَ منه. وهكذا الحياة، تعطي دروسًا، كي يعتبرها عشاقها ويتمعنوا في معانيها وينقلوا تجاربهم لغيرهم، لا أن يتعالوا على شعوبهم ويستخفوا بعقولهم ويستخدمونهم أدواتٍ مسخَّرة لمآربهم وحاجاتهم ونزواتهم. فتجّارُ الشعوب، لا ولن يتمكنوا من تعلّم دروس الحياة الكثيرة.
لويس إقليمس بغداد، في 28 أيار 2013
لقاء المحبة والغيرة الرسولية
عصر يوم السبت 16 آذار 2013، جمعني مع غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، لقاء ودّي، استذكرتُ فيه الأيام الخوالي الجميلة التي أمضيناها معًا في أروقة معهد مار يوحنا الحبيب ودهاليزه وكابيلّتيه وما رافق ذلك من واقع ومواقع الحياة اليومية، وقد كنتُ من حصة فرقته في السنة الأولى من دخولي المعهد المذكور في عام 1967 في الاكليريكية الصغرى. آثرتُ أن يكون في اللقاء نفحةٌ من الخصوصية ومساحة أوفر لتبادل الرأي ومجالٌ أكبر للإنصات إلى توجيهات شيخٍ "شاب" قويّ العزيمة، مصمّم الإرادة، نضر الروحية ومتسامي الروح. في بداية اللقاء، بادرني بتمنياته لي أن أبقى شبابًا على ما لاحظه فيّ من احتفاظ معظم شعرات رأسي بسوادها، فيما شعرُه قد غزاه الشيب الوقور وأثقلته الحكمة والاتزان والمحبة والرغبة في تقديم شيء مميّز، في عصر تمرّ فيه الكنيسة جمعاء، وفي العراق والمنطقة بخاصة، بمرحلة حرجة من التجدّد والخبرة والتغيير، أحبّ البعض أن يسمّيها ب"الربيع المسيحي" لكنيسة المسيح. ومَن عرفه عن قرب، لا بدّ أن يشعر بخيوط المحبة والغيرة الرسولية التي تنبع من دواخله، وكأنها شعلة ملتهبةٌ لا تريد إلاّ اتقادًا، وقد آن أوانها لتأتي بالثمر المرتقب. هنّأتُ غبطته وأثنيتُ على انتخابه من قبل السينودس الكلداني الذي اختاره لميزة الشجاعة التي عُرف بها مذ كان كاهنًا ومديرًا للاكليريكية في بغداد، ثمّ أسقفًا غيورًا أجاد الحوار مع أتباع الديانات الأخرى، بل لنقلْ كان رائدًا لها ومازال وبسببها ذاع صيتُه وصار نجمًا كنسيًا عالميًا مرموقًا يرغب الجميع بالتقرّب منه والتحاور معه واللقاء به. بادر غبطته وتطرّق في الحديث عمّا أكتبه في الشأن المسيحي وأثنى على تأكيدي في المرحلة الراهنة، على أهمية الهوية المسيحية التي تجمع أبناء شعبنا بعيدًا عن التزمت أو التعصّب المذهبي أو القومي الذي ذهب إليه بعض سياسيينا ومثقفينا من مختلف الطوائف والملل، لكونه لا يخدم الهدف ولا يجدي نفعًا بقدر ما يضرّ ويحدّ من طموحاتنا الوطنية وتطلعاتنا المسيحية ويفتُّ من عضدنا وقدراتنا التي بسببه تشظى وتشرذم. شكرتُه على تشجيعه لي للمضي في ذات السياق ما أستطيع. كما جرى التطرق إلى مبادرة حوار الأديان قيد الإعداد، من جهاتٍ حريصة على إدامة روح التسامح والتآلف والوحدة الوطنية مع أتباع الديانات الأخرى التي نأمل أن ترى النور قريبًا وتأخذ مداها الوطني قبل كلّ شيء، بمباركة منه ومعه رؤساء الكنائس والطوائف الشقيقة الأخرى. ثمّ تناول الحديثُ، بذرةَ الرجاء التي يعقدها الكثيرون على تولّي غبطته زمام السدة الرئاسية للكنيسة الكلدانية وكنيسة العراق وأهمية أن تأخذ الكنيسة دورها الريادي الجامع لكلمة المكوّن المسيحي بتوحيد جهودها وبالتناغم والتآلف والتحاور بين جميع الطوائف للخروج بثمرة أولى للوحدة المسحية المرتجاة وهي توحيد الأعياد ابتداءً من السنة القادمة. ولتكن هذه المبادرة، البذرة الأولى للمّ شمل اللحمة المسيحية في كنيسة واحدة يملكها المسيح وحده، لا التيجان والصولجانات البالية التي تزول. وإن تحققت هذه المبادرة، ستكون حتمًا علامة لانتصار زمن العقل والحكمة والانفتاح بدل الانغلاق والتعصب على أمرٍ غير عقائدي. كما عبّر غبطته عن قراره جمع إخوته رؤساء الطوائف المسيحية في لقاء أخوي مسيحي قريبٍ جدًا، لتثبيت موقف كلمة الوحدة معًا، والانطلاق بمطالب موحدة في لقاء يجمعهم مع المسؤولين في الدولة العراقية، في سعيٍ لتثبيت إخوتهم وأبناء رعاياهم في التشبث بأرض الآباء والأجداد وفي الشهادة لمسيحيتهم التي ارتوت من أجلها أرض العراق بدماء الشهداء وصارت بذارًا لحياة أفضل وليس سببًا للهروب والهجرة غير المبرّرة في أحيانٍ كثيرة. وهنا شكوتُ لغبطته نقص الوعي من بعض رجال الكنيسة و الكتاب على المواقع الالكترونية من الذين يواصلون تثبيط عزائم المسيحيين بالبكاء على مآسٍ وأحداثٍ شربنا علقمها وتجرّعنا مرارتها، تمامًا كما سار المسيح في درب الصليب والآلام، ولكنه في النهاية كان لنا جميعًا الرجاء بقيامته منتصرًا على الموت والظالمين. وهذا ما ينبغي التنبيه له والتأكيد عليه في اللقاءات على الفضائيات وفيما يُكتب في المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام المتنوعة عن الوضع القائم في كنيسة العراق وفي المنطقة عمومًا، في أنّ لنا رجاء بالقيامة بعد طول هذه المآسي، لأنّ كنيسة المسيح مبنية على صخرة بطرسية يرعاها مسيحُها ومؤسسها ولا يمكن أن يدعها تسقط وتتآكل وتتلاشى "ها أنا معكم كلّ الأيام حتى انقضاء الدهر". وفي السرد ذاته، بشّرني بأنه عاقدٌ العزم على ترميم البيت الكلداني الداخلي وتجديده وإنعاش روحية أساقفته وكهنته ورهبانيته ضمن برنامج طموح بدأ مشواره بقرارات جريئة وصحيحة بعد الترهل والفلتان الذي أصاب الإدارة والمالية. وما أثلج صدري نيتُه بائتمان المعهد الاكليريكي المتمثل بكلية بابل للفلسفة واللاهوت إلى إحدى الرهبانيات المشهود لها بالمعرفة والتقوى والكفاءة الإدارية والكنسية على السواء كي تأخذ على عاتقها تهيئة خداّم ورعين ورعاة أكفاء مسلّحين برباط المحبة وروح الخدمة الكنسية الحقيقية بعيدًا عن بهرجة المناصب أو الرغبة بتأسيس إقطاعيات في بلدان المهجر وهجر كنائس الملّة بعدما كانت تنتعش بفائض تُحسد عليه. كما أعرب عن نيته طرق أبواب الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة من أجل حشد الجهود المعنوية لدعم كنيسة العراق بشتى الوسائل وإيقاف مدّ الهجرة غير المقبول عبر مشاريع تُكرّس لهذه الجهود من توفير مسكن وتأمين فرصة عمل إضافة إلى ما يحتاجه كلّ مواطن من وسائل الأمان والخدمات الآدمية، ما يساعد بالتأكيد على تثبيت المتشبثين بالأرض وتشجيع المغتربين من العودة إلى أرض الوطن. أليس في هذه النقاط برنامج عملٍ متكامل للكنيسة والدولة العراقية على السواء، كما اعترف بذلك رئيس الحكومة العراقية في حفل التنصيب بتاريخ 6 آذار 2013؟ إنها الفرصة الذهبية لكنيسة العراق كي تنتعش من جديد وتفرض وجودها المسيحي على الساحة السياسية والمجتمعية على السواء في ضوء الكاريزما الذي يتمتع بها غبطة البطريرك ساكو، والعلاقة الطيبة التي تجمعه مع منتمي ديانات وزعماء قيادات شعبية ودينية وحزبية ومسيحية، وهو جديرٌ وكفءٌ لها، إذا سانده إخوته رؤساء الطوائف ونحن معه بما أوتينا من غيرة ومحبة واستعداد للخدمة والتنازل. فهلْ، سينزل إخوته من الأساقفة من جميع الملل، عن عروشهم ويتصالحوا مع الله والشعب ومع بعضهم البعض ويخدموا الرعية كما خدم المسيح في حياته وغسل أرجل تلاميذه وقدّم نفسه قربانًا عن الشعب؟ حينئذٍ تكون رعية واحدة وراعٍ واحد يقود كنيسة العراق والشرق إلى برّ الأمان وتحقيق المطالب المشروعة، من خلال التفاف بطاركة الشرق وأساقفتهم جميعًا حول بعضهم، وتحرّكهم يدًا واحدة وهدفًا موحدّا على طريق بناء الوطن عبر الرجاء والقيامة والنصر لويس إقليمس بغداد، في 17 آذار 2013
عندما يصير الشعور القومي بديلاً للهوية المسيحية!
مِن الخطأ الفادح أن يؤْثرَ الفرد المسيحي ما يسمّيه "بالقومية"
على شيء أسمى وأكبر، وُلد ويعيش من أجله في شهادة حياته المطبوعِ
عليها. مهما كانت الأسباب وتعدّدت الحجج، تبقى "الهوية المسيحية" هي
التي تطبع حياة الفرد المسيحي المؤمن بربه والتابع لكنيسته، أيًا كان
أصلُها أو شكلُها أو تابعيتُها. والكنيسة هي الأخرى، أيًا كانت
مرجعيتُها، هي أمّ لجميع أبنائها وستبقى كذلك بلا منازع، علامةً مميزة
لمؤمنيها وأتباعها. تُرى، ما هو الجواب الأول الذي يمكن أن نتلقاه حين
مبادرتنا للسؤال التقليدي المتبادر إلى الذهن لأول وهلة عن هوية شخص لا
نعلمُ عنه شيئًا، لاسيّما في منطقتنا بصورة أخصّ؟ بالتأكيد، سيتركزُ
هاجسُنا الأول حول هويته الدينية كي تطمئنّ القلوب، كما يُقال، ومن ثمّ
يمكننا الاسترسال للسؤال عن قوميته وملّته وعشيرته وباقي توجهاته
الاجتماعية. إذن، يبقى الدين هو الهاجس الأول لنا، والذي يجمعنا معًا
نحن المسيحيين، لاسيّما في مثل هذه الظروف العصيبة التي اشتدّ فيها
الصراع الديني بين الشعوب وتنامى التيار المتشدّد غير المعترف
بالاختلاف سبيلاً للعيش.
إنّي أتحيّر من عدد من كتابنا ومثقفينا وهم يخوضون رهانًا
خاسرًا وغير رصين في تمجيد التوجه القومي لطائفة دون أخرى، وبإصرارهم
على فعلهم هذا بمناسبة ودون مناسبة، من دون تقديم الدليل العلمي لذلك،
وكأنها أضحت الشغل الشاغل لهم أو هي كما البلسم السحري لوجودهم وكيانهم
في تحقيق وجودهم ونيل حقوقهم ومطالبهم. إنهم بهذا الفعل غير الحكيم،
يتنكرون لأهمية "الهوية المسيحية" التي هي الأساس في رسم ملامح وجودهم
وحياتهم وقيمتهم في المجتمع.
أنا لا أنكر على أيّ كان، تفاخره بمكوّنه أو طائفته أو كنيسته،
فهذا أمرٌ مفرَغٌ منه، وهو حقٌ طبيعيٌ لا لومَ عليه. ولكنّ مسيرة
الأحداث وطبيعة شكلها وتعقّد إشكالاتها، تشير إلينا بضرورة إيلاء
هويتنا المسيحية الاهتمام الأول كي تكون في مقدّمة الأشياء والخيارات
جميعًا بسبب الظرف الراهن والهجمة الشرسة التي يتعرّ ض لها المكوّن
المسيحي أكثر من غيره. هذا هو المنطق، في الأقلّ في هذه المرحلة الحرجة
التي تمرّ بها المنطقة وعراقنا بصورة أدقّ. الهوية المسيحية، هي وحدها
يمكن أن تجمعنا وتُؤالف بيننا وتوحّدنا وتجعل منّا، ومن طوائفنا
وكنائسنا جميعها، سدّا منيعًا وشهادة جامعة للرأي والفكر في المطالبة
بحقوق وطنية مستحقة مكتملة وغير منقوصة. إني أتساءل فقط: ماذا حصد
سياسيونا ومَن ينفذون اليوم أجندات لأحزاب متنفذة في عموم العراق أومَن
تشرذمت أوصالُ ملّته وكنيسته وجماعته بين تأثير أهل الاغتراب وفكر أهل
الداخل؟ وماذا انتفع أهلُنا من تشظّي ولاءاتهم وتنوع تسمياتهم القومية
المفتعلة منذ بدء الرهان الخاسر على هذه أو تلك؟ حتى في هذه- وقد كانت
واضحة أمام الجميع منذ البداية
باقترانها باسم اللغة السريانية التي نتحدث ونعترف بها جميعًا ومعنا
العالم كلّه-، لم يشأ المتعصبون الاعتراف بها سبيلاً لوحدتنا، وقد كانت
أسهل وأرفق من الماء الزلال. هل كنّا بحاجة إلى خلق عقبة كأداء جديدة
بشتى المسمّيات التي اخترعها الأغراب لمكوّننا المسيحي كي نجعل الغير
للبدء بالتشكيك بوجودنا بسببها؟
إن الشعور القومي، شعورٌ جميلٌ وضروريٌ ومهمٌّ في حياة الشعوب
التي عرفت الديمقراطية
وعاشت الحرية وقاست وجودها بين غيرها وفق المعايير الواقعية من جهة
العودة للأصالة دون التشبّث بها ديدنًا ووصمةً تدمغ حاملَها. بيدَ أنَّ
هذا الشعور لا يُفترضُ به أن يكون من الأولويات بالنسبة لنا نحن
المسيحيين في هذه المرحلة
الحرجة من حياة شعبنا التي يوجد فيها مصيرُنا على المحك. وإذا كان لنا
أن نقرّ بمثل هذا الشعور، فبداياتُه وأساسُه يعود الفضل فيه إلى التيار
"الآثوري" الشجاع الذي ناضل وجاهد وأحيا الروح القومية هذه عبر أنشطته
المختلفة منذ الوعود المقطوعة للشعب "الآثوري" آنذاك بداية القرن
العشرين. ولعلّ من بين الوسائل التي انتهجها هذا التيار، تمثلت بتشكيله
خلايا مقاومة ومن ثمّ أحزابًا اتخذت من التوجه القومي "الآثوري" واجهة
للمطالبة بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي لم يكن يتيسّر فيه لباقي
الطوائف مثل هذا التوجه الذي كان غائبًا عن ذاكرة المنتمين إليها مثل
السريان والكلدان وغيرهم. كما تميّز "الآثوريون" بهذه التسمية وأجادوا
باستخدام مختلف وسائل الإعلام المتاحة في الداخل والخارج، إضافةً إلى
نشاطهم الاجتماعي الملموس ولاسيّما في مجال إحياء تراثهم عبر الملبس
ووسائل الترفيه المتواصلة كالنوادي الاجتماعية وكذلك عبر فنونهم الأخرى
ولاسيّما في مجال الغناء الثري الذي يكشف الشيء الكثير من هذا التمسك
لديهم والوعي المتواصل. والحق يُقال، كان غيرُهم في سبات طيلة السنوات
الكثيرة الماضية، حيث لم يكن في حسابات هؤلاء الاستيقاظ على مثل هذا
الشعور حتى السنين الأخيرة من حقبة القرن الماضي، وبصورة أوسع منذ
التغيير الدراماتيكي في 2003. فالفضل في إيقاظ هذا الشعور يعود بالأساس
إذن للعنصر "الآثوري"، الذي عُرف بهذه التسمية بالتحديد، ولولاهم لما
دخل الكلدان والسريان والأرمن المعترك الجديد في السياسة والإعلام
وتشكيل الأحزاب. هذه مجرّد حقائق، والمنصف ينبغي أن يتعامل مع الحقائق،
وليس بتشويهها.
إني هنا، لستُ بصدد تأييد ما يذهب إليه المجتمع "الآشوري"
بتسميته الجديدة على الساحة السياسية، في تسبيقه للجانب القومي على
الجانب الديني. فلكلّ مكوّن حريتُه في اختيار ما يراه ملائمًا. لكنّي
أرى في هذه المرحلة بالذات، أن المشترك الأكثر تقريبًا لنا يكمن في
هويتنا المسيحية. إذ بهذه التسمية الموحدة
يعرفنا الغير، وما عدا
ذلك فهو يفرّق ولا يجمع ويضرّ ولا ينفع، كما نلمس واقعيًا. لذا كان من
الحكمة على الجميع، أن يركزوا على عنصر الهوية المسيحية أكثر من
غيره، لأننا حين نضمن وجودنا الديني نكون أيضًا قد ضمنّنا وجود وحقوق
طوائفنا ومكوّناتنا على اختلاف تسمياتها. كما أنّي مؤمنٌ أن عصر
القوميات قد انتهى في البلدان المتحضرة، مثل أوربا وأمريكا التي نبذتها
وتركتها وراءها لأنها لم تجلب لشعوبها غير الدمار والخراب والتخلف
بتعلّقها بأفكار نازية وشعوبية وتعصبية مثل النازية الألمانية التي
جلبت ويلات حربين كونيتين، ومنها تعلّمت أوربا درسًا في كيفية التخلص
من كلّ فكر قومي ضيّق. لكنّي في ذات الوقت أختلف وأنتقد العالم الغربيّ
الذي كاد يسدل الستار على ديانته الأصلية ليتلاقى مع تيارات مادية
ورأسمالية بسبب العولمة التي جلبت عليه رياح التطرّف وأشكال الديانات
المتعصبة التي لا تقبل شريكًا لها، وكلّ ذلك بحجة الالتزام بمعاهدات
ومواثيق حقوق الإنسان والحرية، وكأنّي بهم يسيرون في زورق منقوبٍ
والمياه تجري من أسفله حتى يأتي اليوم الذي يغرق مركبهم ليغرقوا معه هم
أيضًا، لأنهم أهملوا الجانب المسيحي في حياتهم التي كانت قد طبعتها من
قبل.
نحن اليوم على عتبة جديدة
بعد تسنّم رأس الكنيسة الكلدانية الجديد البطريرك لويس ساكو زمام أمور أكبر
طائفة مسيحية وطنية، بل لنقل رئاسة كنيسة العراق، بشيء من الفخر
والاعتزاز. وفي بلدٍ أصيلٍ مثل العراق، كُتب له فقدان الاستقرار
والأمان منذ سنين طوال، يكاد اليوم يغرق هو الآخر بمن فيه بسبب دعوات
التشظّي والانقسام والتناحر الطائفي الذي يعود بالأساس إلى الاختلاف في
عنصر الدين. والمسيحيون ليسوا استثناءً من هذا التوجه، بسبب الاختلاف
في طوائفهم وطقوسهم. إذ هناك دعواتٌ ضيقة تريد دقّ الأسفين بين مختلف
مكونات الشعب المسيحي بحجج كثيرة ووسائل متعددة، بعضٌ منها من داخل
صفوفه من المتعصبين بلا دليل علمي أومن المدفوعين من لوبيات مهجرية
تعمل من بلدان الاغتراب، وهؤلاء كان يُفترض بهم عدم التدخل في مصير من
اختار البقاء والثبات في أرض الآباء والأجداد، في الوقت الذي باعه
هؤلاء برخص التراب وآثروا راحة البال وعدم مواجهة
الهجمة التي تعرّض لها جميع العراقيين دون استثناء، بمن فيهم
المسيحيون على وجه الخصوص.
إنّي أفهم من التوجهات
الوطنية لغبطته، أنه من خلال أبواب الحوار المشرعة والمشروعة يمكننا
تثبيت حقوقنا وفرض مصيرنا وتأكيد بقائنا على الأرض كشعب أصيل يعترف له
الجميع بهذه الميزة بمن فيه الشركاء من أركان الدولة العراقية الذين
أكدوا على مثل هذا التوجه يوم التنصيب، كما سمعنا ذات التأكيدات في غير
هذه المناسبة أيضًا مرات ومرّات. أليس في هذه التأكيدات من البطريرك
الجديد ومن شركاء في العملية السياسية من أمل ومن رجاء بفتح آفاقٍ
جديدة ومطمئنة للمسيحيين بإمكانية العيش مواطنين متساوين في الحقوق
والواجبات كغيرهم، إنٍ هم تمسكوا بدينهم وأرضهم ووطنيتهم وتميّزهم، كما
عهدهم الجميع من قبل؟ إني أعتقد أن هذه رسالة واضحة وكافية للجميع للكف
عن المهاترات الكلامية وتوجيه دعوات ضيقة الأفق تدعو إلى التجزئة
والانقسام والتشظّي تماماً كما يفعل الشركاء الحاليون في العملية
السياسية. وليكن الجميع على قدر المسؤولية الوطنية أولاً والمسيحية
ثانيًا والقومية (الطائفية) في التالي. فما يجمع هو الأصلح، ومن يريد
أن يفرّق فلا خير فيه مهما كانت منزلتُه وشهادتُه وتبريراتُه.
لويس إقليمس
بغداد، في 11 آذار 2013
عهدٌ سرمديٌّ فرنسيٌّ- ألمانيّ للصداقة والتعاون
مهما طالت الحروب وامتدت الخلافات بين الفرقاء، لا بدّ أن يأتي
اليوم الذي يصحو فيه العقلاء إلى الخطأ في السياسات والاستراتيجيات
لساسة بلدانهم. فالحروبُ كرٌّ وفرٌّ ولا تأتي بغير الدمار، والعاقل من
يقرّرُ وضع حدّ لها خدمة للشعوب والبلدان، مشاركةً منه في بناء عالمٍ
متحضّرٍ قائمٍ على القانون واحترام خيارات الآخر والقبول بالاختلاف
معه، طالما أنه قابعُ في بيته ولا تمتدُّ يدُه لغيرِه.
هكذا حديثًا، كان الوضعُ بين العدوّين التاريخيين اللدودين،
فرنسا وألمانيا، اللتين صحا عقلاؤهما على حقيقة مؤلمة وَصَمَتْ البلدين
بصبغة حروب متتالية للحقبة بين 1870- 1954، والتي لم تأتي بغير الدمار
والحقد والخراب. هذه الأيام، يحتفل البلدان الصديقان المتحالفان
بالذكرى الخمسين لذلك العرس السرمدي الذي أنهى في 22 كانون ثاني 1963،
حقبة تلك الحروب الأهلية بين شعوبهما، بفضل العقل الراجح لقادتهما، كلّ
من الجنرال "ديغول" الفرنسي و"كونراد أديناور" الألماني، بتوقيعهما في
باريس، على معاهدة الصداقة والتعاون السرمدية بين بلديهما اللتين
أنهكتهما تلك الفترة المظلمة من تاريخهما وزرعت أحقادها بين شعوبهما
وشلّت القارة الأوربية بأسرها. إنّ ما أثار المشاعر لدى مواطني البلدين
الجارين هذه الأيام، أسفُهم على الدماء البريئة التي سالت دون مبرّر
ثمنًا لطيش القادة والساسة في تلك الحقبة الزمنية، حتى حطّت الحرب
العالمية بكلّ مآسيها أوزارها وانقشعت الغيوم المتلبدة وغارَ الطغاة
إلى حتفهم ليلعنهم التاريخ ويضعهم في زاوية مزابله، وما أكثرها!
قد يسألُ سائل: هل كانت مآسي أوربا وخروجها منهكةً من أشرس حربٍ
عالميةٍ عرفها التاريخ، هي السبب الحقيقي وراء التبدّل التاريخي في
قاعدة الزمن والسياسة؟ وهل كان للعقل البشري دورٌ في ذلك التغيير
الجذري بالصحوة الجديدة؟ أم إن إرادة العناية الربانية كانت الأقوى في
فتح عيون البشر والعقلاء منهم للبحث في وسائل اتصالٍ أجدى مِن عمل
الاقتتال والعنف الذي ضرب أطنابه طيلة تلك الفترة المظلمة من تاريخ هذه
القارة؟ فقد تتالت الصحوات فيها بعد ذلك العرس السرمدي، حيث تلاه سقوط
جدار برلين في 1989 وتوحيد ألمانيا في 1990، متبوعًا برخاءٍ عمّ
البلدين والقارة الأوربية بأكملها لغاية الساعة، وهي تشهد تغييرات في
اتجاه التوحيد على تنوّع مجالاته.
ديغول، رمز الحرية والبناء!
عندما سقط الرايخ الثالث بزعامة هتلر، لم تعد ألمانيا قادرة على
فرض قوتها التي تجبّر بها ذلك المجنون قاسي الرقبة. فقد رضخت حينذاك
للإرادة الدولية بتجريدها من كلّ تسليح وقوة عسكرية، أي أنها قد أُفقدت
شجاعتها وجبروتها الذي كانت عليه أيام الهتلرية الطاغية. وقد وجدت
نفسها ذات يوم، تستيقظ على أشبه ما يكون حلمًا سرياليًّا في حياة
مواطنيها. إنه حلم العصر! عندما انبرى قادة البلدين المتهالكين لفتح
صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين ألمانيا الخاسرة وفرنسا المنهكة.
وجاءت كلمات "ديغول" بمثابة قرار الحسم في علاقات بلاده مع الجارة
العدوّة ألمانيا عندما قال كلماته الشهيرة أمام وزرائه قبل تركه
للسلطة:" ايها السادة، لا تنسوا ابدًا، أنْ لا بديلَ لفرنسا سوى
بعقدها عهد صداقة مع ألمانيا". ومذ ذاك أصبح مصطلح الثنائي
(كبل-Couple
)، هو الرائج الاستخدام في وصف العلاقة بين
الدولتين الكبريين اللتين
تُعدّان اليوم، الذراع
الاقتصادي للاتحاد الأوربي عالميًا. وبالرغم من احتمال بروز اختلاف في
الرأي أحيانًا، إلا أنّ المركبة الأوربية تُجرُّ اليوم بحصانين قويّين،
متعاضدين ومتماسكين في رباطٍ أشبهَ بالزواج الذي لا طلاق فيه. كما أنّ
البدائل الديمقراطية بين البلدين تجد طريقها إلى تفاهمات اساسية في
السياسة رغمًا عن الاختلاف في الجهات أو التيارات أو المحاور الحاكمة
في أيّ من البلدين، سعيًا وراء خلق تفاهمات متزنة على صعيد الأزمات أو
الحلول التي من شأنها تعزيز الدور الأوربي دوليًا.
ثباتٌ وعزمٌ رغم التحديات
اليوم، وفي ضوء التغييرات السياسية التي أتت بالرئيس الاشتراكي
لفرنسا، يتواصل الحوار دون انقطاع، ولكنْ، من دون ارتجال في المواقف
المصيرية، وذلك بالرغم من الطريق المحفوف بالصعوبات التي تفرضها
السياسة الدولية المعقدة. فالمستشارة ميركل، "تعلكُ" المواقف مرارًا
وتحسبُها بعقل راجح دون أن تتحدّى، وذلك قبل أن تفصح عن قرارِ مصيري
تتخذه في المواقف الحساسة، ولاسيّما الاقتصادية منها، التي تشكل اليوم
حلقة مهمة في أزمة أوربية خانقة تقضّ مضاجعها بسبب الكساد الضارب
أطنابه عددّا من الدول الحليفة، ولاسيّما المعروفة منها مثل إيطاليا
واليونان وإسبانيا والبرتغال وأخرى غيرها. وبالرغم من أنّ الأزمة
الاقتصادية كادت تكون عالمية، إلاّ أنّ استمرارها بهذه الحالة قد تضطرّ
أوربا لأن تتخذ قرارات حاسمة في وقت من الأوقات، بسبب إمكانية زعزعة
كيانها الاتحادي، الذي يشكلّ ركنًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي
ومحورًا مهمّا في السياسة الدولية. لذا، جاء نداء الزعيمين في كلا
البلدين في آخر زيارة للرئيس الفرنسي هولاند إلى المستشارة الألمانية
أنجيلا ميركل في ايلول 2012، لتأكيد السير على خطى صانعي السلام في
أوربا وبناتها المؤسسين، في السعي الحثيث لبناء بلدان هذه القارة
وتعزيز تضامنها المشترك. فقد أدرك الجميع أن توأمة الروح الذي ابتدأ في
1963، وكذا نصيب أوربا من الأحلام الوردية، لا يمكن الركون إليهما إلاّ
من خلال وحدة هاتين الدولتين
التوأمين، فرنسا وألمانيا، سعيًا نحو أوربا أكثر قوة وصلابة
وفعلاً، ما يعني مزيدًا من المنعة لدورها على أصعدة كثيرة. وبذلك تكون
اللبنات الأولى التي وضعها مؤسسوها، قد أتت بثمارها الكثيرة رغم الصعاب
والمشاكل المتفاقمة. إلاّ
أن هذه القارة، ستبقى عصيّة قائمة مادام الفكر المنفتحُ عاملٌ في عقول
مواطنيها دون أن يتركوا ميراثهم في الديمقراطية والإنسانية واحترام
حقوق الآخر والقبول بالمختلف عندهم، سائبًا للدخلاء عنهم من أصحاب
العقول المريضة الذين يحاولون غزوهم منذ أمد. كما يتحتّمُ على قادة دول
أوربا، أن يعوا حجم الخراب والدمار والتفكّك الذي سيعانونه فيما لو جرى
اختراق بلدانهم من جانب دخلاء على بيئتهم الاجتماعية الليبرالية وطبيعة
نظمهم السياسية المدنية. كما عليهم عدم التساهل مع أمثال هؤلاء
الدخلاء، بحجة تطبيق معاهدات حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية. فهذه
المبادئ والحقوق لا تنسجم مع مْن يحمل الفكر التكفيري والحقد الديني
وكذا مع مَن يرفض الطبيعة المسالمة المتسامحة مع كافة الأديان
والقوميات والإثنيات والمعتقدات والتيارات، أيّا كانت. فقدْ بانَ في
الأفق، ما يؤكّد هذه المخاوف في أوساط العديد من المجتمعات الأوربية
التي فطنتْ متأخرة لهذه الحالة التي تكاد استفحلت، وما في اليد حيلة
بعد أن جرت المياه من أسفلهم في غفلة من الزمن. فهل يتمكن عقلاءُ جددُ
بوضع متراسٍ لصدّ مثل هذه الغزوات المستميتة التي لا تخلو من وصمة
عدائية هدّامة تسعى لتقويض مثل تلك المجتمعات الآمنة؟
لويس إقليمس
بغداد، في 22 كانون ثاني 2013
المطران ميخائيل جميل، سيرة وذكريات
معلمٌ بارزٌ من أعلام السريان يرحل وهو في عزّ نشاطه، وشخصية
بحجم المطران ميخائيل جميل تودّعُ قرقوشَ – بخديدا مصنعَ الرجال وقوتَ
الثقافة السريانية وترياقَها، وأسقفٌ طافتْ سمعتُه أرضَ الله الواسعة
متجاوزةً حدود الوطن إلى الديار العليا والمحافل الدولية والدواوين
الفاتيكانية يرقد صامتًا، بائسًا، صاغرًا لقساوة المنون الذي لا يرحم
أحدًا. هذه هي الحياة الدنيا... ولادةٌ ونموٌّ وتعليمٌ وتدرّجٌ ورقصة
وهولٌ وسفرٌ وإنتاجٌ فنهايةٌ محتومة! ما أقساها من حياة وما أرهبكَ يا
موت! ولو لم يكن في جعبة الإنسان شيءٌ من الإيمان بالقيامة، فهل كانت
تستحق كلّ هذا العناء؟؟؟
هكذا إذن، عادَ إبنُ بغديدا البار إلى أحضان بلدته، ليس فارسًا
راكبًا على فرسٍ أصيلٍ كما اعتاد في زياراته السابقة منذ مغادرتها،
ولكن هذه المرة محمولاً، مخذولاً لا حراكَ فيه ليرقد بين حناياها، بعدَ
أن أسكته الموت القاسي قبلَ أوانه.
لقد كبا الفارس المقدام عن صهوة جواده وهو لمّا يزل كتلة ساخنة
من الحركة الفاعلة والنشاط الدؤوب والإنتاج الفكري الغزير، وهو في
حياته، لم يكنْ يعرف الملل حتى ساعاته الأخيرة، ولا عرَف التوقف عن
العَدْوِ والتسابق مع الزمن منذ سيامته الكهنوتية في حزيران 1964
وتسنّمه المسؤوليات الشاقة والعديدة أينما كان وحيثما كان، في المكان
والزمان واختلاف الظروف والميادين والأصقاع.
كان فارسًا من نوع خاص يعرف كيف يدوس الأرض بحدوته، ونجارًا
ماهرًا يختارُ أين يدقّ مسمارًا في جدارٍ مشجّع، وأكّارًا شغولاً يبذر
ثمارًا في أرضٍ صالحة، ويسقي زرعًا في مواقع كثيرة أينعت عن حاصل طيبٍ.
ذو جدارة بارعة ونيةٍ عامرة بالمحبة وانفتاح للفضاءات الكثيرة
التي نجح في تسلّقها بحكمة وعنادٍ وطموح بارز. واسع الاطلاع، عنيدٌ في
كبريائه ومغمورٌ في اعتداده، رغم همومه وانشغاله بأهوال بلدته ووطنه
وطائفته وبلبنان وأبناء المهجر الذين تولّى مسؤولية رعايتهم وزيارتهم
في كلّ فرصة سانحة، كالحمام الذي يحنّ لعشّه وفراخه.
أديبٌ مصقعٌ مقنعٌ في كلامه، سلسبيلٌ في سرده مداعبٌ في روايته،
بشوشٌ لا تنقطع ابتسامته وعبوسٌ حين يشغله همٌ أقفل عليه الحلّ .
فوضويٌ بعفوية في قهقهاته التي تنساب لتصل جنبات الفضاء الذي يسكنه
بأكمله.
ذو قلم سيالٍ لا يعرف التوقف تأليفًا وترجمة. خفيف الظل، سريع في
بديهته، مطربٌ في عشرته، كريمٌ في عمله ورفقته، سليمٌ في علاقاته،
متفتح الذهن والروية، متحرّر في قراراته وحركاته، أنيسٌ في أي مجلس
يحلُّ فيه، ولا يخفي نوعًا من الجدّية حينما يقتضي الظرف ليقول لك:
كفى، فقد طفح الكيل! شغوفٌ بالعراق، البلد الذي أولاه شيئأ كثيرًا من
اهتمامه. كيف لا، وقد توشح منصب أسقفية تكريت شرفًا في 1986، لتأكيد
هويته وعراقيته استذكارًا لدور تكريت، عقرِ دار السريان في غابر
الزمان! ومن شدّة حسرته لما يجري فيه وله، كان يعبّر عن اسفه لما آلَ
إليه حالُه ويتخوّف من تجزئته وإفراغه من سكانه الأصليين في ظلّ
العولمة والمخطط الجهنّمي
المرسوم للشرق الأوسط الجديد.
كان المطران جميل فوق ذلك كلّه، لطيفًا في معشره، محبًا للناس،
كل الناس، حريصًا على تحلية المكان الذي يحل فيه وتجميله بدعاباته
البسيطة المعقدة في آنٍ معًا، وهي خليطٌ من مداخلات وتغريداتٍ لا
تنقصها النكتة والقهقهة العريضة أحيانًا لتبديد الهموم وتبسيط سبل
العيش، رغم جِدّه في العمل وأصوله. يعرفه المقربون في جلساته، سارحًا
بذكريات الأمس التليد وحكايات الجدّات والقدامى أيام زمان وبذكريات
الصبا وقساوة أيامها وحلو طعم الأكلات التقليدية لبلدته من البرغل
والحبية والكبة وأشباهها. هذه كلُّها وغيرها في غربته الرومانية، لم
ينسى طعمها والشوق لها متى حلّ لديه ضيوفٌ من أهلها وقساوستها
وتلاميذها الدارسين في الأروقة الفاتيكانية الذين خصّهم برعاية مميّزة.
ذو صوت رخيم تطربُ له الآذان وتشنفُ الأسماع، حين ينبري في
التنغيم والولوج إلى عالم الموسيقى، لاسيّما منها ما يثير المشاعر
ويأخذ الألباب كالمقام والجالغي وشيء من روائع الغناء العربي كفيروز
وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب. ما أطربه حين كان يغني أغنيته المحبّبة "
يا جارة الوادي"
مفتونًا شغوفًا بلواعجها وترنيماتها وسلّمها وكأنها تطلع من عمق جوارحه
المكبوتة وهو مأخوذٌ بها لغاية العشق من شدّة تفاعله مع النغم.
صوته وهو في قلاّيته أو في أروقة مقره في روما، كان يجلجل وهو
يضفي على مَن برفقته أو بالقرب منه، أجواءً من المحبة واللطف والكياسة
إلى جانب سحنة من الحنين والحزن والعودة لسالف الأيام. وفي موقعه
الكنسي الرفيع وبرغم هيبة البناية التي يسكنها، كانت قلايتُه أشبه
بغرفة ناسك متعبّدٍ لعمله ومخطوطاته التي لم تُنجزْ بعدُ، وما أكثرها،
وهو في بلاد الغربة، وما أدراكَ ما الغربة!
كان جميلًا بسمرته،
يحب الجمال والوجهَ الحسن بتقاطيعه ولاسيّما شكلَ الأنف... وكم كان
يتغنى ويفخر بأنفه الشبيه بالكشتبان، وهو يعدّه من محاسن الجمال لدى
البشر. أتذكر بعضًا من مثل هذا الوصف له ونحن في صالة الدرس في معهد ما
يوحنا الحبيب في مرحة سمنير الصغار في نهاية الستينات. وحينَ أعودُ
لتلك الأيام الخوالي، أتذكر عنها الكثير الذي لا يمكن نسيانُه. ومنها
ما تعلّمتُه على أيدي معلّميّ وأساتذتي في معهد مار يوحنا الحبيب منذ
1967 لغاية 1973. وقد كان القس ميخائيل جميل آنذاك واحدً من هؤلاء
الذين لا يمكن طمسُ تأثيرهم في مسيرة من عاصروهم. إنّي أكنُّ له
العرفان بتعلّمي
على يديه الكثيرَ من مبادئ اللغة العربية، قواعدِها وأدبِها، ومن
الألحان الكنسية الطقسية التي
فيها كان مرجعًا وكنزًا نادرًا للعديدين، مع زميله وأستاذنا جميعًا
المرحوم القس جبرائل جرخي، صاحب الحنجرة الذهبية وفطحل اللغة العربية
للعديد من الأجيال الذين احتضنهم معهد مار يوحنا الحبيب بالموصل. وهنا
أعيد للتذكير، أن القس ميخائيل، كان قد سجّل ألحان "بيث كازو" الطقسية
على كاسيتات خلال فترة عمله في "السمنير" وخدمته في إبرشية الموصل، ولا
نعلم مصيرها وبيدِ مَن صارتْ، فهي كنزٌ ما زلتُ أبحث عنه منذ زمنٍ!
أتذكر أيضًا، ونحن تلاميذ في معهد مار يوحنا الحبيب الكهنوتي،
كيف كان يحكي لنا ما يجري في زياراته للسجون في الموصل، وحكايات
السجناء والمفارقات التي فيها أحيانًا، رغم صعوبة المهمة الموكلة إليه.
فقد كان تولّى تلك المسؤولية الشاقة إلى جانب مهماته التدريسية في
المعهد المذكور وخدمته في رعية مار توما وبعدها في كنيسة القلعة، لغاية
مغادرته أرض الوطن إلى فرنسا للدراسة في 1974.
وكم زادني بهجة حين
تكرّم وأرسل لي نسخة من "البيث كازو" بعد استعارة أحد الأصدقاء نسختي
الأصلية والادّعاء بفقدانها. فقد كنتُ طلبتُها من القس ميخائيل حين
توليه مهمة سكرتارية البطريركية في 1977. كما كانت بيننا خلال تلك
الفترة، عدة مراسلات بعضُها بالسريانية - ما زلتُ أحتفظ بها-، في
متابعةٍ لموقفي وقراري بعد إغلاق
معهد مار يوحنا الحبيب في عام 1973 وتشتت التلاميذ، إلاّ سواي، حيث
كنتُ قد حصلتُ في تلك السنة على إذن مسبق من إدارة المعهد ومن المثلث
الرحمة مطراني "مار عمانويل بني" لنيل شهادة الثالث المتوسط في امتحان
خارجي بالموصل ونجحتُ آنذاك بتفوق إلى جانب تفوقي في دروسي بالمعهد.
وقد زارني القس ميخائيل جميل خصيصًا آنذاك، ذات عصر أحدِ الأيام في هذا
الخصوص في البيت العائلي في قرقوش في صيف 1973،
باعتباره مديرًا لقسم الكبار في المعهد المذكور منذ عام 1971. وعندما
استنفذ أي أملٍ بقبولي عرضَه بالتحاقي بالدراسة الكهنوتية خارج العراق،
شكرتُ له اهتمامه أمام عائلتي واعتذرتُ منه في حينها، حيث كانت لي
طموحاتي بتكملة دراستي الجامعية والعليا قبل أن أقرر مستقبل حياتي.
ولكن حصل ما حصل بعدها حين تعقدت الأحداث وتفاعلت الأمور!
كنتُ قد تنبأتُ له مستقبلاً مغمورًا بالمسؤوليات في كنيستنا
السريانية الكاثوليكية، وهذا ما حصل حين اختياره أسقفًا وسيامته في
1986. وتوالت مسؤولياتُه، حتى كاد أن يكون قاب قوسين أو أدنى من تولّي
رئاسة الطائفة حين شغور الكرسي البطريركي في 2009. وفي هذا الصدد، لا
أنسى ما كرّره لي في مرات عديدة خلال زيارتين لي إلى روما في نهاية
2010 وبداية 2011، أنه كان الأجدر بتسلّم المنصب البطريركي لطائفته.
وقد ردّدها لي مرارًا وآخرُها في مطعم إيطاليّ حين دعوتُه لعشاء برفقة
أحد القساوسة الدارسين في روما بقوله:
"ديدي ياوا" أي كانت لي.
تلكم كانت آخر ذكرياتي الطيبة مع سيادته، حين قصدتُه قبل عامين
من اليوم تمامًا ولمرتين متتاليتين في فترة علاجي
في أحد مستشفيات روما بعد إصابتي في حادثة سيدة النجاة، وبمساعدة
القاصد الرسولي في بغداد ، حيث استضافني في مقرّه الروماني. وقد لاحتْ
لنا في تلك الأيام عدة فرص للقاء والحديث والخروج معًا والمشي في أزقة
الحي الإيطالي الذي يسكنه في بيازا كامبو ماريزيو الشعبي ذي الأزقة
الضيقة، مرورا بالمطاعم الكثيرة فيه، حيث كان يتحاشى احيانًا أصحابَها،
لكثرتهم، وهم يصرّون على دخوله مطاعمَهم الفاخرة. فقد صار علامةً بائنة
لأصحاب المطاعم في حيّه. كان يعرفه الجميع، بل صار جزءًا من مشهد
حياتهم، إذا انقطع عن زيارتهم أو طال غيابُه، ساورهم قلقٌ وريب. وفي
المطعم، كان لا يتردّد في البوح لي بالكثير من المشاريع والهموم التي
ترواده، ليس بخصوص بلدته وطائفته فحسب، بل بما يخص كل تراب الوطن الذي
خصه بشيء من محبته وإخلاصه وتفانيه وكذا للبنان الذي نقش فيه الكثير من
سبل العطاء والمعرفة. لقد كان له بحرٌ واسعٌ من المعارف والأصدقاء
والأحباء، ازدادت حين توليه مهامه معتمدًا بطريركيًا لبطريركية السريان
الكاثوليك لدى الفاتيكان في 1997 وزائرًا رسوليًا في أوربا في 2002.
لا أنسى وقفته وأنا في روما، مع مَن استضافهم لفترة طويلة من
شباب بلدته من الطلبة المصابين في حادثة سيارات جامعة الموصل الذين
عزّز فيهم روح البنوّة فتعلّقوا بشخصه وكان يشعرُ بعيشه وسط أهله
وعائلته وبني جلدته. فقد كان لهم الأب والأخ والصديق والكاهن، يؤازرهم
ويشجعهم ويحنو عليهم ويسهل عليهم إجراءاتهم.
رافقتُه وأنا في روما، للمشاركة في أربعينية شهداء كنيسة سيدة
النجاة في دار السفارة العراقية في العاصمة الإيطالية، وشعرتُ به
مهمومًا ومصعوقًا بتلك الحادثة الإرهابية، لاسيّما مع تزامنِ وجودِ
مجموعةٍ من جرحى الحادث وهم يعالَجون في أحد المستشفيات الفاتيكانية.
شخصية فذة بهذا القدر من العلم والكفاءة والغيرة والجدّية
والإنتاج والنشاط والنظام في الحياة، إلى جانب محبته وشدّة تعلّقه
بمسقط رأسه ووطنه وطائفته وروحه المسكونية وسعة علاقاته الطيبة مع
شرائح عديدة ومتنوعة من البشر، تستحق الاحترام- وأيَّ احترام-، على
المستوى المحلي والوطن والعالم، كما على المستوى الكنسي والمسكوني. في
سنواته الأخيرة، كان شعلة متقدة من الحرارة والحركة والنشاط والسفر
الدائب والدائم في ذهابه وإيابه.
لقد استحق أن يودعه هذا السيل الجارف من البشر المتحرّق الأنفس
أسفًا لفقدانه، غبَّ تغييبه باكرًا وهو بعد في أوج عنفوانه ونشاطه.
نم قرير العين، يا ابنَ بغديدا البار، يا فارسًا جالَ وصالَ
وفعلَ. وإن كنتَ لم تستطع توديع كنيستك وبلدتك ووطنك ومحبيك وأهلك
واصدقاءك كما كنتَ تحلم، ها هم اليوم يودّعونك بما تستحقه من إكرامٍ
للذكرى. وفي عُلاكَ السماوي، سوف تعلم أنْ ليست قرقوش وحدها تودّعك، بل
انضم إليها كلُّ محبيك من كلّ أصقاع الأرض ومن بشرٍ متعدد الجنسيات
والأتراب والأجناس. فقد أديتَ الرسالة وصنتَ الوديعة وحفظتَ الأمانة
بالصلاح والتدبير والحكمة، كما تكلّم بها شعارُكَ.
تعازيّ القلبية لرئاسة طائفتنا السريانية الكاثوليكية الموقرة
وللسينودس الأسقفي السرياني ولذوي الفقيد الكبير ولأصدقائه ومحبيه وأهل
بلدته وطائفته وكنيسة العراق جميعًا. وعزاؤُنا نيلُه إكليلَ الغار
السماوي المحفوظ للأبرار والصدّيقين والفعلة الصالحين: "نعمّا يا عبداً
صالحًا، أدخلْ إلى فرح سيدك"، فالوزنات التي أودِعَها المثلث الرحمة،
قد ربحت غيرها، ومقدارُها عند ربّ السماوات وحده!
لويس إقليمس
من تلامذة وأصدقاء الفقيد
لمناسبة إعادة إعمار و
افتتاح كنيسة سيدة النجاة في 14 كانون أول 2012:
سلامٌ لكم يا شهداء كنيسة
سيدة النجاة الأبرار الخالدين في الذاكرة أبدًا،
أصحاب النيافة والغبطة
والسيادة الأجلاء،
ضيوف الكاتدرائية من
رجالات الدولة والبرلمان والمنظمات والهيئات الدبلوماسية المحترمون،
حشود المؤمنين والحضور
الأكارم،
((( كنّا هنا !
)))
عصر يوم الأحد 31 تشرين الأول 2010، وفي الخامسة والثلث منه بالتمام
والكمال، كان ما بربو على مائتي مصلٍّ في ذات المكان الذي نحن فيه
الآن، على موعد مع مشهدٍ مروِّعٍ، وبامتياز للشهادة والاستشهاد، تمثّلَ
في اعنف هجمة إرهابية عرفتها كنيسة العراق، كمّا ونوعًا ونهجًا وفكرًا
وأيديولوجيةً. كان قدَرًا منحوسًا، فيه تكشّفت كل بشاعات الحقد
الإرهابي والفكر المتطرّف والنظرة المنغلقة على القتل ورفض الآخر
المختلف. حصل ذلك عندما تجاوز منفذو الجريمة على قدسية أكثر الأديان
سماحة ومحبة وأنبلها حبًا للإنسان والأوطان وأقربها إعلاءً لصورة
الخالق الجميلة في مخلوقه، وأكثر ناسها أصالةً في الأرض وسعيًا للسلام
والمحبة والعدل. تلك المجزرة بهولها ورعبها ورهبتها، قد لا تختلف في
قساوة الدماء المراقة في عموم تراب الوطن الجريح، إلاّ أنها وفق
القياسات المجتمعية والأحداث السياسية بتقلباتها وإعادة ترتيباتها، هي
الأقسى على مسيحيّي العراق، لأن ما أُريد بها، كان قصمَ ظهورهم وهم
أحياء، بل كانت علامة بائنة للتحريض على الهجرة ومواصلة دفعهم لمغادرة
وطن الآباء والأجداد قسرًا، وطن الحضارات من سومر وبابل وأكد وآشور...
حضارتهم ترقى إلى سبعة آلاف عامٍ، أراد نفرٌ ضالٌ، مدفوع ومموّلٌ من
"إمبراطوريات" منغلقة وأشباه دول مجهرية صاخبة عبرَ أعوانٍ لم يعرفوا
غير الكراهية طريقًا للعيش، استكمالَ مشروع الغزو الدرامي البغيض
بتحجيم هذا المكوّن المسالم أصلاً، والعمل على تعميق بذور الحقد وزرع
الفتن وتفتيت النسيج المجتمعي العراقي المتآلف منذ القِدم.
خلاصة الحكاية المرّة لتلك المجزرة الرهيبة، تجدونها في وصفي لشهادتي الحية
في الذكرى السنوية الأولى للمأساة، والتي قد تنفع مادة دسمة لصنّاع
السينما والدراما، لأنها ببساطة، حكايةُ حدث مأساوي حقيقي، ولا من
مثيلٍ لها ولا في الخيال. تلك شهادةٌ حية ناطقة من دون رتوش، لهول
الساعات العصيبة الأربع بكل بشاعاتها، أمضاها شهودُ للحقيقة في صحن
الكنيسة أو في غرفة "السكرستيا"، من قاصدي بيت الله للصلاة من أجل
الوطن وإحلال السلام والأمان فيه والطلب من الباري تنوير وإرشاد ساسة
البلاد وقادتها إلى ما فيه خيرُ الوطن ووضعُ مصلحته فوق كلّ منفعة
ضيقة، بعيدًا عن حسابات المحاصصة الطائفية التي شلّت قدرات هذا البلد
الكثير الخيرات، والقليل الخدمات والجائع للأمن والأمان والعيش الكريم.
لن ينسى التاريخ تلك الصولة الإرهابية الشرسة التي حصدت أرواح 47 نفسًا
طاهرة، بمن فيها، كاهنان شابان نذرا نفسيهما طوعًا لخدمة بيت الله
وعباده، كما عُرفا بعفتهما وسموّهما في خدمة الرعية وفي حبّ الوطن.
أحبّهما المسلم قبل المسيحي الذي كان يقصدهما لطلب مشورة أو نيل
مساعدة، ولم يبخلا يومًا في تقديمها من جيبهما الخاص أحيانًا، عندما
كان يضيق بهما مخزن المطرانية. فأيةَ كلمات أسوقها لكم أيها الشهداء
الخالدون في الذاكرة، وقد كنتُ واحدًا منكم قبل استشهادكم، نصلّي معًا،
كي تزول الغمّة عن هذه الأمّة التي اغتالتها الأقدار لتعيش في ظلام
القهر والفوضى والعنف الذي عمّقته خلافات الشركاء الفرقاء، يومًا بعد
آخر.
لن أطيل في السرد، ففي جعبتي الكثير. ولكنّي أود استخلاص العبر والدروس
والتذكير بما هو مقبول ومحسوس والمطالبة بما هو ممكن وملموس.
لقد كان الأمل معقودًا، أن
تهزّ هذه الحادثة الجلَل، ضمائر كلّ من يدّعي عبادة الله الواحد الأحد
في كلّ شبرٍ من أرض الوطن وخارجهِ. سوف لن أتحدث عن أشكال الإهمال
واللامبالاة التي حصدتها الحادثة من الإدارة الأمريكية، راعية التغيير
الدراماتيكي في العراق، التي تكاد تلك الجريمة النكراء لم تعمل عملها،
بل لم تُشر إليها في حينها، رغم أنها هزّت حتى الضمائر الميتة
للإنسانية، والسبب ببساطة، لأنها صاحبة فكرة تقسيم العراق وتفتيتِ
نسيجه المجتمعي وإفراغه من المكوّنات الصغيرة المستضعفة وصهرِها، وعلى
رأسها المكوّن المسيحي من خلال تشجيع أتباعِه على مغادرة أرض الآباء
والأجداد بالتعاون مع دول تقدّمت
بعروضٍ لاستضافتهم وإعادة توطينهم،
عوض البحث عن
وسائل فعّالة تؤمّن حالهم وتحفظ انتماءَهم. إنه لَمِن المؤسف، أنّ هناك
من انساق لهذا التيار الجارف من أبناء جلدتنا وأصدقائنا وأهلنا، راكبين
موجة الغيرة والحسد أحيانًا بالبحث عن الترف الضائع في بلدان المجهول،
مع إبقاء شيء مخجلٍ من الحنين لترابه. بالمقابل، لم يرتقي اهتمام
الحكومة العراقية إلى مستوى المسؤولية في متابعة شؤون الشهداء والجرحى،
إلاّ على خجل. كما لم تفلح في معالجة الخلل الأمني المتواصل لغاية
الساعة، ولا في إيجاد حلولٍ جذرية للأجواء المتلبدة في مناطق تواجد
أبناء شعبنا المسيحي، ولاسيّما في سهل نينوى الساخن، بسبب ازدواجية
الحكم فيها وغياب سلطة الدولة وفقدان هيبتها، ما ساهم في فقدان بصيص
أمل في التشبث بالأرض ومن ثمّ بعدم التفكير بمغادرة الوطن. لقد وعدت
الدولة رئاسةً وحكومةً، ولم تفي بوعودها كاملةً. كما وعد الكثير من
السياسيّين ورؤساء الكتل وسوّقوا تصريحاتهم الرنّانة على الفضائيات وفي
الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية، بل أقحموا أنفسهم بتلك الوعود
عندما صرّحوا بأن المسيحيين أصلاءُ في أرض العراق وأنهم يسبقون غيرهم
في أحقية هذا الوطن. إلاّ أن الوقائع أثبتت تمسّك هؤلاء القادة
والسياسيون بالتأليب على حقوق هذا الشعب المسالم بحجج كثيرة، ومنها ما
يُسمّى بسياسة الموازنة والاستحقاق الانتخابي وسلوك الأغلبية.
خلاصة الحديث، رغم صراحته وقساوته، أخاطب به أركان الدولة من هذا المكان
المقدس، الذي تضرّج بدماء الجرحى والشهداء الأبرار الذين تطرزت أسماؤهم
على جنبات هذه الكنيسة، أن يكون فعلُكم على قدر أهمية وجود هذا المكوّن
الأصيل، هذا إذا كنتم حقًّا تقدّرون هذا الوجود وتأثيره على المجتمع.
كما أناشدكم باسم مسيحيّي العراق، أن تعِدوا وأنتم تحت قبة سيدة
النجاة، مريم العذراء التي نكرمها جميعًا، والتي حفظت باقي المصلّين من
القتل والبطش البربري الذي رافق تلك العملية الإرهابية البشعة، بأن
تفوا الوعد المقطوع بحمايتهم والدأب على ترسيخ بقائهم وإنصافهم بكلّ
وسيلة تحافظ على وجودهم وتبقي على جذورهم راسخة وتطمئِنُ بقاءهم في أرض
الآباء والأجداد عبر تمثيلهم في كلّ مفاصل الدولة وهيئاتها، بعيدًا عن
سياسة المحاصصة الطائفية التي شلّت العملية السياسية وأسرت أدوات
الديمقراطية لصالح الأقوى على الساحة على حساب المكوّنات القليلة العدد
"الأقليات"، وأن تساعدوا على منع أي تغيير ديمغرافيّ في مناطق تواجد
المسيحيين بأية حجةٍ كانت، لأنّ ذلك واحدٌ من الأسباب التي ساهمت
وتساهم في تهجيرهم وفي انحسار وجودهم الريادي في المجتمع.
مسيحيًّا أقول: لقاؤنا المتجدّد هذا اليوم، هو وقفة ضمير لكلّ مسيحيي
العراق، لعيش معموديتنا وإيماننا وشهادتنا والتزامنا بكنيستنا وديننا
السمح، لا بالكلام فقط إنما بالعمل والحق، دون أن ندع تقليعة العبثية
الموجهة علينا تقذفنا بأهوالها نحو المجهول، أو بشيء من الاستهانة
والتهاون بقدراتنا. لن نستمرّ في الانحناء للظلم والاضطهاد والتهميش.
وإذا كان المسيح قد تنبّأ لنا بتعرّضنا للضيق والاضطهاد من أمم وشعوب
العالم، فهذا ليس ولن يكون مدعاة لاستمرار القبول بهذه المظالم أو
بالرضوخ للمتجبّرين قهرًا وظلمًا. فحضارةُ العراق، بقديمها وحديثها
وُلدت من رحم المسيحية. ومن يريد التأكد من ذلك، فليلتجئ إلى كتب
التاريخ وما يقوله علماء الآثار في بابل والنجف وكربلاء والحيرة وبغداد
ونينوى وتكريت وغيرها.
كنا دومًا حملة سلام ومحبة ووفاق، لا نعرف حمل السلاح، "لأنّ من يأخذ
بالسيف، فبالسيف يهلك". هكذا قالها المسيح. وآخر سلوانا، قولي مع
القديس بولس:" من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أضررٌ أم ضيقٌ أم شدة أم
اضطهاد أم خطر أم سيف؟". إذ بهذا الايمان سقط كهنتنا واخوتنا شهداءَ في
هذه الكنيسة، لتصبح اجسادهم الطاهرة بذارًا لحياة أفضل، وقرابين حب
تمتزج بها دماؤهم الزكية مع دم المسيح وأصفياء الله الصالحين
والقديسين، لتطهّر أرض العراق من كل يد اثيمة تريد النيل من كرامته
وحريته وتقدّمه وعافيته، رغم الصعاب الكبيرة التي تواجهه. ولنتذكر قول
المسيح: "لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد". وقوله: "لا تخف ايها
القطيع الصغير"، "أنا معكم
حتى انقضاء الدهر".
مهما حصل، يبقى العراق وطننا، لنا فيه مثلَ ما لغيرنا، نذودُ عنه ونحميه ولن
نغادره. ومَن غادره لتعدّد الأسباب، يوجب على السياسيين أن يفكروا، كيف
وما عليهم فعلُه لإعادتهم إلى حضن الوطن الأم، بدل التسكع في بلدان
المهجر المجهول، لأن أرض العراق تسع الجميع ومن حق الجميع تمتُعهم بكل
ما فيها من خيرات وثروات وآمال. كما أنّ من كان على سكة الهجرة، عليه
أن يفكر ألف مرة، قبل أن يترك أرض الحضارات والأجداد والأحباء. فالوضع
الناشز، غير المستقرّ القائم لن يدوم طويلاً، والفوضى الأمنية ستجد
طريقها للنظام والقانون، كما أنّ حبل الإرهاب، مهما طال وتجبّر لن
يدوم، بجاه سيدتنا مريم العذراء، سيدة النجاة، وسيدة الشهداء.
أدام الله كلّ وطنيّ عزيز، عفيف، كريم، وحاملٍ شعلة السلام والمصالحة
والمحبة. وأخيرًا، أردد مع المسيح ومعكم: "طوبى لفاعلي السلام، فإنهم
أبناء الله يُدعون".
لويس إقليمس
ناشط مدني
رئيس شمامسة كنيسة سيدة النجاة
أفضل الخيارات حيال "الربيع العربي"!
اللجوء إلى المنطق والعقل والواقع، سمة الحكماء والعقلاء
والفقهاء بين الناس، أيًّا كانت انتماءاتُهم الدينية أو المذهبية أو
الإثنية. كذا حالُ الدنيا، يومٌ لكَ ويومٌ عليكَ، ولكن كما قالها حكيمُ
زمانه: "إذا دعتكَ قدرتُك على ظلم الناس، فتذكّر قدرة الله عليك". لو
أن من أسعفته الأقدار أو جيء به إلى السلطة بأية وسيلة كانت، تمسك
بجوهر هذه المقولة الرائعة، لما عاش فقيرٌ أو وُجد مضطَهّدٌ أو مهمّشٌ
في أية بقعة من أرض الله الواسعة. وسوف نقتصر حديثنا على
المنطقة العربية ومنها العراق بصورة خاصة، في ضوء الأحداث
الدراماتيكية التي تتالت على المنطقة وقلبت الموازين واختلت فيها
المعايير على أشكالها وأنواعها. فما يُسمّى "بالربيع العربي"، رغم
المآسي وأشكال الخراب والدمار التي أتى بها في البلدان التي شهدت هذه
التحولات المأساوية، لم يستطع أن يأتي بما كان أفضل فيما سبقه من
أنظمة، رغم فساد هذه وشموليتها وقهرها لشعوبها. بل ما كان محسوبًا
عليها من مآثر أو آثار للديمقراطية التي تسعى إليها كل شعوب الأرض
الحرّة المتحررة، قد أضاعها القادمون الجدد بما أتوا به من فسادٍ عارم
وتآكل لباقي روح الوطنية والمواطنة والولائية التي كانت قائمة قبل
قدومهم وحلولهم ضيوفًا ثقلاء على الطيبين من المواطنين الأصلاء الأباة
أصحاب الضمائر والذمم التي لا تُقهَر رغم عوادي الزمن الغادر.
ألمدّ الأصولي وإشكاليتُه
قدوم التيارات السياسية الدينية، كان نتيجة الأخطاء الكبيرة
التي اقترفتها الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة سحابة سنين طويلة اتسمتْ
بالظلم والقهر والترويع والتأليه لشخوص نصبوا أنفسهم ولاة غليظي الرقاب
على هامات ومصائر المستضعفين، من خلقِ الله، خالق البشر جميعًا على
صورته الجميلة. وما تزال أنظمة بذات المواصفات تترعرع في أرض الله في
منطقتنا المغضوبِ عليها منذ الدهور. أهي ثرواتُها الكبيرة مصدرٌ لنقمة
إلهية ينفذها أشباه ُ بشرٍ رعاعٌ في المنطقة، مدفوعون بلوبي خارجي يريد
تقويضها وتركيعها وتقليص مفعولها في البورصة الإنسانية العالمية
لاحقًا؟ قد تذهب تحاليلُ بعض المفكرين في هذا الاتجاه حيث الاعتقاد
بكون الربيع العربي مرحلةً نحو دحر العناصر الدينية وقياداتها
ومرجعياتها المتزمتة وغير المتزنة، بل الرافضة لكلّ أنواع التمدن
والتحضّر والحرية التي أفرزتها مبادئ الديمقراطية في البلدان الواعية
التي مرّت بمثل هذه المراحل في حقبٍ من تاريخ بلدانها، ليس الآن ولكن
بعد حين. إنه لمن المؤسف حقًا، أن مثل هذه الدروس التي استخلصتها
البلدان المتقدمة وطبّقتها في صياغة مستقبل شعوبها وفي ترميم وإصلاح
وتطوير طاقاتها، لم تتمثل بها الطبقة الحاكمة التقليدية منها والحديثة
العهد في منطقتنا العربية، بل زادت في غيّها وتفنّنت في وسائل الإبقاء
على سياساتها المتعجرفة والشمولية وفي قهر شعوبها. وكأنّ التاريخ يعيدُ
نفسَه. فبالأمس القريب، عندما كانت الدولة الإسلامية تشهد أيام ازدهارٍ
وتطوّر نوعيّ وحصانة قوية، كانت تتسم حياةُ شعوبها بشيء من الرفاهة
والانفتاح والتسامح والنظام، ولو على خجل لا يمكن مقارنتُه مع غيرها من
بلدان الغرب. وبعكس ذلك، عندما كانت تتعرّض لانحطاطٍ أو لنكساتٍ دينية
أو سياسية، كان الساسة يعبّرون عن ذلك بآلات من القمع والانكفاء على
الذات وأشكالٍ من التزمّت والتكفير للغير، ما كان يجعل من الحياة تحت
رقابهم صعبةً ومشكلةً. وهذا ما يحدث اليوم تماماً، فنحن نعيش دورةً من
الانحطاط والانكفاء والتراجع.
أين الخيار الأفضل؟
اليوم نكاد نشهد ذات السيناريو الذي
يروَّج في منطقتنا حيث سيادة
العنف واهتزاز الفكر وتراجع الحريات واللهاث وراء المحاصصة الدينية
والمذهبية والاثنية إلى جانب الافتقاد إلى الحكمة والروية في تسيير
شؤون البلدان والعباد على السواء. هي فترة انحطاط لن تخلو من متاعب
ومنغصات واحتقانات. ولعلّه إزاء هذا المدّ المذهبي والأصولي المستحلّ
لعدد من دول المنطقة، والتكفيريّ في جزئياته لكل البشر من غير السائرين
في مسالكه وفي فكره، ليس أمام الشعوب المستضعفة، ومنها الأقليات
الدينية والإثنية، غير أن تحتكم إلى العقل والروية في التعامل مع مثل
هذا المدّ الجارف وغير الواعي لأصول الدين والسياسة والمجتمع على
السواء. ولو أنّ قادتَه وأركانَه ومحفّزيه ركنوا إلى حكمة إعطاء "ما
لله لله وما لقيصر لقيصر" ووضعوا مقولة "الدين لله والوطن للجميع" أمام
ناظريهم، لاستطاعوا إرضاء الله الخالق الذي يدّعون التحدّث باسمه
وتطبيق شرائعه. ومن ذا لا يريد تطبيق شرعِ الله الخالق الذي حبانا
وخلقنا على صورته ومثاله، لنكشف له عن جمال البشر في طبيعته وجمال
الطبيعة بوجود البشر عليها. وربّ سائلٍ: "أَ بالقتل والترويع والتهديد
تُطبّقُ شريعةُ الله؟ أليس هو الرحمنَ الرحيم العادل الجبار الذي لا
يرضى بظلمِ الناس لغيرهم؟ ألم يعاقبْ رئيسَ الملائكة الذي طغى وطرده من
الفردوس لدسائسه وأحالَه شيطانًا مرفوضًا وملفوظّا وملعونًا من الناس
جميعًا لآخر الخليقة؟ إزاء هذا كلّه، لابدّ من إيجاد وسيلة للتعايش مع
هذا المدّ غير السويّ الرامي لجرف كلّ ما لا يتناغم معه. فالمواجهة
المسلحة، لم ولن تكون الخيار الأفضل، لأنّها بفضل خبرة الشعوب لم تستطع
أبدًا تقديم الحلول المقبولة السلمية والسليمة معًا. في المقابل، لابدّ
من سلوك الحوار وطريق التعايش السلمي وإيجاد السبل لاهتداء التيار
المتشدّد إلى طريق السلام واحترام الغير، حتى لو اختلف معه في الفكر
والدين والمذهب. لأنه، مهما كانت سمة التشدّد ومهما امتدّت في جذورها
وأصولها وآلياتها، لابدّ من البحث عن مخارج آمنة للتعايش وجعل مراجعها
وقادتها تقتنع بهذه الضرورة. فعالمُ اليوم لم يعدْ كما كانت عليه الحال
قبل 1400 عامٍ خلتْ. كما لا يمكن أن يعيش البشر في القرن الحادي
والعشرين عصر المغاور والكهوف والدواب. والدليلُ على ذلك، ما يستخدمه
أدعياءُ العودة للسلف من أدوات عصرية في حياتهم اليومية. فلا يُعقل
قبولُ أدوات الرفاهة المعاصرة والمتجددة يومًا بعد آخر ورفضُ ما تحتّمه
هذه الاختراعات والآلات من حسن تصرّف وتعايش وتعاون وتساهل وتشارك
واحترام وقبول للآخر بهدف ضمان نتائج مثل هذا التقدم في الحياة وتسيير
الحضارة وفي تأمين المستقبل للمجتمعات. أمّا الردّ والصدّ والمواجهة
بالسلاح وبالتهديد والترويع، فلن تنفع. هل استطاعت الحروب التي شنّها
صدام على جيرانه أن تثنيهم عن أفكارهم العنصرية والمذهبية والقبلية
الضيقة؟ وهل إطالة النزاع بين العرب والكرد في العراق منذ اندلاع ثورة
الثائر الراحل بارزاني قد خدمت العراق والعراقيين؟ ألسنا نتحمّل شيئًا
من وزر تلك الأيام البائسة اليائسة لغاية اليوم؟ كذا الحال مع بلدان
"الربيع العربي" التي آلت إلى خريف وقيظ موحش. فالصراع في سوريا، هو
الآخر تكملة لسيناريو الحرب على العراق، وقد أفلت الرَسَنُ (الهفسار)
من سيطرة السلطان الأمريكي المحرِّض فيها، كما في غيرها من البلدان
التي شهدت تغييرات سياسية، بعد سرقة ثورات شعوب هذه البلدان من ثائريها
الأصليين وسيطرة التيارات السلفية والإخوانية عليها، وما أتت به هذه من
مفاهيم رافضة لأية أفكارٍ نابعة من شيء يُدعى ديمقراطية أو حرية، إلاّ
الديمقراطية التي يؤمنون بها وبها تُلجمُ الأفواه وتُكبّل الأفكار
التحررية وتُمحى الاتجاهات المختلفة عنها دينًا ومذهبً وفكرًا. ولعلَّ
ما نلحظه اليوم عبر وسائل الإعلام، تذمّر رعاة التغيير في الربيع
العربي، وعلى رأسهم الراعي الأمريكي الذي بدأ يخشى من انفلات العقال من
يد ما يسمّيها بالمعارضة التي اندسّت فيها عناصر القاعدة والإخوان
وطالبو السحت الحرام والسلطة. وهذا ما أدّى إلى تخلخل استراتيجية إسقاط
السلطة بالعنف والقوة اللتين دمّرتا البلد ونزل فيها الطرفان خرابًا
ودمارًا لا يرحمان في القرى
والمدن الرئيسة وفي تشتيت وتهجير الناس، فيما استغلّت عصابات
متشددة وحاقدة هذه الظروف لتُنزل ضربات ضدّ أبناء الأقليات ومنهم
المسحيين بصورة خاصة، الذين فرغت مدنهم وأحياؤهم عن بكرة أبيها. أهكذا
تُفرض الديمقراطية؟
رقصةٌ وتنتهي النمرة!
ولكن، هي رقصة، تؤديها الغانية
الجديدة، ثمّ تشيخ وتهرم وتنسحب من على المسرح كما الأسد الخاسرُ في
جولة صيد ماكرةَ!
لويس إقليمس
بغداد، في 21 تشرين ثاني 2012
في الذكرى السنوية
الثانية لمجزرة كنيسة سيدة النجاة (31 تشرين أول 2010)
"كي لا ننسى .. :كنّا
هناك"
تعود إلينا هذه الأيام، الذكرى السنوية الثانية لمجزرة كنيسة
سيدة النجاة الأليمة في 31 تشرين أول 2010، وسط ترقب مشوبٍ بالأمل
والشكّ في آنٍ معًا: الأمل يكمن في رسالة الإرشاد الرسولي الذي خصّ به
قداسة البابا المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، كي يثبتوا في جذورهم
المسيحية ويتقوّوا بإيمانهم ضدّ حملات الترهيب والتهديد والتهميش
المتواصلة ضدّهم وضدّ طموحاتهم الوطنية بحياة إنسانية طبيعية متساوية
ومتوازنة قائمة على احترام الخيارات الشخصية في الدين والمعتقد
والتوجّهات الاجتماعية وفي وسائل التعبير. أمّا الشكّ، فهو كامن في ما
نراه ونعايشه ونلاحظه على أرض الواقع، من التمادي في إهمال استحقاقات
المكوّن المسيحي بخاصة، ومعه المكوّنات قليلة العدد الأخرى (الأقليات)،
في كلّ مسالك الحياة العامة التي ينبغي أن يتمتع بها نسيج الشعب
العراقي ككلّ، اعتمادًا على مبدأ المواطنة التي تعني من جملة ما تعنيه،
مساواة المواطنين جميعًا دون تمييزٍ مكوّنٍ
عن آخر من المكوّنات الأخرى، لاسيّما المصرّة منها على الاستحواذ على
كلّ شيء بحجة ما يُسمّى باستحقاق الأغلبية والأكثرية العددية دينيًا
وإثنيًا وطائفيًا، ما أثبت تسبّبها بالخلل والفوضى والفشل في تقديم
الخدمات الآدمية الطبيعية وفي عدم الاستقرار السياسي والأمني، الذي
يستمرّ فيه البلد غارقًا في بحرٍ من المشاكل السياسية التي ليس للشعب
فيها حيلة، كما ليس له فيها لا ناقة ولا جمل.
بكلمات قليلة، لكنّها معتصرة ومفعمة بالألم والذكريات القاسية،
كلّما تذكرتُ المأساة، بسبب هول المجزرة التي عايشها من كان يصلّي في
هذه الكنيسة عصر الأحد 31 تشرين أول 2012، طيلة أربع ساعات بكمالها
وتمامها، وأنا واحدُهم... أريد أن أقول: كنّا هناك بين أرجاء هذه
الكنيسة الأجمل بين كنائس بغداد، نصلّي من أجل العراق، كلّ العراق،
بكلّ مسيحيّيه ومسلميه وسائر المكوّنات الأخرى
كي تعيش بسلام وأمان وشرفٍ،
كما كانت عليه حتى 2003.
قبل عام من اليوم،
رويتُ على مواقع الكترونية وفي مجلة الفكر المسيحي، شهادتي حول ما جرى
في هذه المجزرة من داخل غرفة السكرستيا التي تحصّنَ بها معي أكثر من
خمسين مصلٍّ، بينهم الخوري "روفائيل قطيمي" الذي نالَه قسطٌ من نيشان
تلك الحادثة، التي بقي طيلة الهجوم فيها واقفًا واجمًا صلدًا على رجليه
حتى الربع ساعة الأخيرة من انتهائها، حيث تهاوى حينها مصابًا. أين
وكيف؟ لا أدري ولا هو يعرف.
أتذكر، كيف بدأ القداس الذي كان يقيمُه القس "ثائر" ويخدمه
الشمامسة والجوق معًا، أني أثناء فترة الموعظة بعد تلاوة الإنجيل،
تندّرت مع زميلي الشماس "وديع"، بسبب مرور الكاهن الشهيد مرارًا
وتكرارًا على كلام يسوع ل"بطرس" هامة الرسل: "من تقول الناس عنّي أنا
هو".. ولم يمرّ على بدء تلك العظة "الأخيرة" للكاهن المحتفل أكثر من
خمس دقائق، حين أزفت الساعة الخامسة والثلث، حيث طرقَ سماعنا أولى
طلقات الإنذار بالهجوم وما تلاه من انفجارات وهجوم عنيف على الكنيسة في
غياب القوة المكلّفة بحمايتها التي غابت وتلاشت وغارت إلى مجهول
مساء
ذلك اليوم، إلاّ من حرس الكنيسة غير المؤهلين للأمور القتالية، كما لم
يفلح تدخلُ الحرس الخاص لمؤسسة سوق الأوراق المالية المجاورة، الذين
تمكنوا من إصابة أحد الإرهابيين الخمسة المقتحمين والذي فجّر نفسه، على
ما يبدو، على سور الكنيسة الأيسر...أتذكر آخر كلمات القس "ثائر" من على
المذبح، حين توقف عن عظته وقال: "ماكو شيء". وحاول عبثًا الاستمرار
بالموعظة، بسبب تزايد قوة الهجمة الشرسة التي هزّت أركان الكنيسة ومَن
فيها وألقت الفوضى والرعب في صفوف المصلّين... أتذكر كيف نزعتُ قميص
الشمّاسية ودفعتُه لابني "رابي" ليرتّبه كي أستطيع الخروج لأتفحّص
بنفسي ما يجري في الخارج. ولكن هول الهجمة منعتني حين رؤيتي ما يجري في
مؤخرة الكنيسة ومن ثمَّ استحالة خروجي بعد أن تمكّن الإرهابيون الأربعة
من دخولها من الباب الخلفيّ وبدأهم بتقتيل المصلّين، وقد سقط في
مقدّمتهم الأخَوان "وسام" و"سلام"، اللذين لحقت بهما والدتُهما من شدّة
حزنها على فلذتي كبدها... أتذكر العويلَ والصراخ داخل غرفة السكرستيّا
التي دخلناها فآوتنا وبقينا فيها "رهائن محتجَزين طوعًا ورغمًا عنّا"
للإرهابيين، وقد اختلط ذلك مع الفوضى التي عمّت آنذاك داخل الكنيسة
وروّعت نفوس المصلّين... أتذكر كيف بدأ أحد الإرهابيين بعد ربع ساعة من
اقتحامهم للكنيسة، وهو شاب في مقتبل العمر، يؤذن داخل الكنيسة وسماعنا
إطلاقاتٍ نارية وانفجارات بعد الانتهاء من الأذان، عندما بدأوا بمسرحية
مأساوية لقتل المصلّين بحسب رواية من بقي حيًّا في داخل الكنيسة، حيث
لمْ يسلم منهم حتى الطفل الرضيع الذي أسكتَه رصاص الإجرام ولا اعتراض
الطفل البريء "آدم" على فعلتهم
الشنيعة! ... أتذكر كيف فارقتِ الحياة تلك الشابة العروس الشهيدة
"رغدة" بين أحضاننا وسط العويل والبكاء والصراخ بعد ان كانت تمكنت من
الزحف إلى هذه الغرفة الصغيرة وهي مضرّجة بالدماء لإصابتها البليغة في
أمكنة عدّة من جسدها الطاهر وقد كانت جالسة حين إصابتها، على المصاطب
الأمامية للجناح الأيمن من الكنيسة... أتذكر كيف كان يصلّي الشهيد
"أيوب" أبياتَ الوردية ويرسم إشارة الصليب في نهاية كلّ بيت يصلّيه وهو
يتألم صابرًا ساكتًا، إلاّ من أنين الجرح البليغ الذي كان أُصيب به وهو
مرتمٍ مثلنا على أرضية الغرفة وبجواري، وأنا أتأمّلُه وأفكرّ ما عسى
يكون خبرُ إصابته أو عدمُ نجاته لدى ذويه وعائلته وأصدقائه... أتذكر
أني لم أتوانى في حينها بإرواء عطشه، بسقيِه ما استطعتُ من ماء متيسّر
من ثلاجة الماء التي كانت على ميمنتي، لحين تدميرها بثالث قنبلة أطلقها
الإرهابيون علينا من حيث لا ندري، وبسببها صمتَ الشاب "أيوب"، وكان
صمتُهُ أبديًا ... أتذكر كيف كنتُ أشجعهُ وأحلّيه بالصبر، فالفرَج
قادم... لكنّه فارق الحياة قبل أن يأتي ذلك الفَرَج الذي تأخر بفعل
فاعل. كيف، ولماذا؟ لا أعرف!
أتذكر أولى المكالمات الهاتفية الواردة من الصديق "أبو مريم" من
"أربيل"، الذي كان يتصل لسؤالٍ خاص بعد دقائق معدودات من حصول الحادث
دون معرفته به بعد، حينها أطلعتُه عمّا يحصلُ لنا طالبًا منه التصرّف
والإبلاغ عن الهجمة بالوسائل المتاحة... أتذكر الاتصال الذي أجريتُه
لاحقًا وبعد دقائق معدودات من الحادثة مع العقيد (العميد فيما بعد)
"سعد" من قيادة عمليات بغداد، وكان أول اتصال تتلقاه هذه القيادة،
وربما الحكومة أيضًا، عن العملية الإرهابية، وقد بقي العسكريُّ المذكور
على اتصال متواصلٍ معي لمرات عديدة لمتابعة الحدث أول بأول ولإعطائهم
الإحداثيات والتهيئة قبل اقتحام الكنيسة من قبل "الفرقة الذهبية" التي
لم تصلح في حينها لتُسمّى حتى ب"الفخارية"، بسبب الإرباك والتأخير
والانتظار المرّ الذي قاساه مَن كُتب له أن يبقى حيًا بأعجوبة من
السماء! أتذكر المكالمات العديدة التي وردتني من أصدقاء ومسؤولين وكهنة
ومقرّبين للاستفسار عن وضعنا بعد أن سمعوا ذلك عبر الفضائيات التي نقلت
الحادث أوّلَ بأوّل... أتذكر كيف منعتُ نفرًا من المحاصَرين معي داخل
غرفة السكرستيّا التي لم تكن محصّنة، من محاولة فتح بابها الخلفي، خيفة
أن يجذب مثل هذا الفعلُ الطائش أحدَ الإرهابيين القابع على خطواتٍ منّا
وأن يحصل ما يحصل.. أمّا الإجراء الوحيد الذي قمنا به، فقد كان دعمُنا
لبابِ السكرستيّا المتهرّئ بدولاب كتبٍ حديدي خفيف كان إلى الجوار،
تحسبًا متاحًا لاقتحام ممكنٍ، ولم يكن ذلك
مستبعدًا في أية لحظة فيما لو
حاول هذا الإرهابيُّ القابع أمامه اقتحامَ السكرستيّا
وتفجير حزامِه الناسف علينا...
أتذكر كيف استطاع ابني "رابي" من خرم الباب المذكور، أن يراقب تحرّكَ
إثنينِ من الإرهابيّين الأربعة، أحدهما الجالس أمام باب السكرستيّا
والثاني على الجهة المقابلة لنا، وهما غير ملثّمين، وقد حفر
تفجيرهما الانتحاري فيما بعد، أثرًا واضحًا في موقع قبوعهما... أتذكر
الشعور الأبوي الذي راودني
حينما طلبَ منّي إبني هذا، عدم الصمت ومخاطبتَه بين الحين والآخر
للاطمئنان عليّ، لاسيّما بعد أن أعلمتُه بإصابتي في وجهي والصنين الذي
طرّشَ أذني اليسرى. كان يقول لي: " بابا كلّمني حتى لو ما بيك شيء"...
أتذكر الحرج الذي أُصبتُ به حين سكتَ جهاز النقال عندي، واضطررتُ
لاستخدام البديل الثاني لاستكمال الاتصالات. حينها ظنّ مَن كانوا على
اتصالٍ دائمٍ معي في خلية العمليات التي شكّلها النائب "يونادم كنّا"
مع فريق مساعديه في مقر الحركة الديمقراطية الآشورية، أنه قد يكون حصل
لي مكروه بسبب ذلك الانقطاع المفاجئ... أتذكر أنّي لم أستطع الردّ على
نداءات عديدة من عديدين ومنهم نفرٌ من أسرتي في بغداد التي كانت
انشغلتْ ذلك اليوم بأمور منزلية طارئة ولم ترافقني إلى الكنيسة
كعادتها... وكذلك النداءات التي لم أستطع الردّ على الكثير منها وقد
تتالت عليّ من أصدقاء ومن عائلتي وأهلي وأقربائي من "قرقوش" ومن مناطق
أخرى وحتى من الخارج ممّن سمعوا بالحادث عبر وسائل الإعلام التي نقلت
أجواء الحادث الذي طال زهاءَ أربع ساعات بهولها وترهيبها وقسوتها
وعنفها وحقدها وإحراجاتها...
أتذكر كيف، أُطفئت الأضواء خلال النصف ساعة الأخيرة من العملية، حيث
ساد الصمتُ والوجوم. حينها قلتُ لابني الفتي: قد اقتربت الساعة، وقد
تكون النجاة حليفنا أو...؟ فتلكُم، كانت لنا إشارات للاقتحام ولحصول
شيء ما. كما تأكّد الفعلُ من الضابط في قيادة عمليات بغداد بالهاتف.
ساعتَها، تزلزلت أركانُ الكنيسة، ودوت انفجارات فاقتْ أصواتُها ما
باستطاعة الآذان تحمّلها...كما غطّت الأتربة والغبار المتصاعد
والشرارات النارية أرجاءَ الكنيسة قاطبة وكذا سقفَها بسبب هول
الانفجارات المتلاحقة، والعصف الشديد للأسلحة المستخدمة والأحزمة
الناسفة التي تفجّرت بالإرهابيين وفتّتت أجسادهم التي اختلطت دماؤهم
بدماء شهدائنا الخمسة والأربعين، بمن فيهم الكاهنان الشهيدان الشابان،
"ثائر عبدال" و"وسيم القس بطرس"... ثمّ هدأت فورة العاصفة ليصلنا بعدها
صوتٌ ينادي: "قولوا يا ألله... قولوا يا ألله! نحن قوات طوارئ". وهكذا،
تبيّن الفرج من ضوء مصباح يدوي كان يحمله أحد العسكر المقتحمين طالبًا
منّا الخروج، فقد انتهت العملية. ولكنْ كيف انتهت.. فقد كانت هناك
مذبحة حقيقية، حصدت أرواحًا بريئة، جلُّ ذنبهم أنهم كانوا يصلّون
ويتضرعون إلى الباري كي يسود السلام ربوعَ الوطن ويتعزّز التلاحمُ
الوطني الذي انهار بعد 2003 وكي يهتدي الساسة بالمثول إلى الحكمة
والروية والعدل في إدارة البلد المتهرّئ والغائص في حفرة الفساد
والطائفية وسرقة أموال الشعب وحقوقهم وقتل الأبرياء وتصفية الحسابات.
تلكم تمامًا، كانت توصية الكاهن الشهيد "ثائر" بعد قراءة الإنجيل حيث
اعتاد الطلب في كل يوم أحد من المؤمنين الصلاة لأجل هذه النية...
كنتُ الثاني الذي غادر
غرفة السكرستيا غيرَ مصدّق حالَنا. فقد حرستنا العذراء مريم، سيدة
النجاة التي ارتدتْ ايضًا ثوب سيدة الشهداء والمعترفين في تلك الكنيسة
التي يتباهى الناس باسمها، مسيحيين ومسلمين على السواء... وقد أصررتُ
بعد خروجي سالمًا على إلقاء نظرة على أركان الكنيسة، رغم اعتراض أحد
العسكر... فرأيتُ ما رأيتُ، غير مصدّقٍ الحالَ الذي آلت إليه كنيستي،
فقد كانت، ما تزال بعدُ، تفترشها بعض الجثث وقطعُ اللحم المتشظّي
والمتناثر هنا وهناك بين أركانها والفوضى التي كانت فيها المصاطب
والمذبح واللوازم الطقسية وحتى
بيت القربان الذي دنّسه الإرهابيون بفعلهم الشنيع ذاك.. وفي فناء
الكنيسة وحولها، كان جمعٌ من ذوي المصلّين وأصدقائهم واجمين بين انتظار
مريب وأمل بلقاء أحبتهم أو مرارةٍ لمرافقة جثامينهم المحترقة أو
الممزقة أو إسعاف المصابين منهم. لم استطع حينها البقاء أكثر من ذلك
بسبب القشعريرة التي شعرتُ بها جرّاء إصابتي أنا أيضًا، وبسبب ملابسي
المبللة التي اختلط فيها الماء المسكوب بسبب كسر ثلاجة الماء، بالدماءِ
التي سالتْ ممّن كان مصابًا وزحفَ باتجاه السكرستيا أملاً في النجاة.
حينها كان نفرٌ من دائرتي في انتظارٍ لنقلي لتلقي العلاج في مستشفى
القديس رافائيل للراهبات بالكرادة، ومنها إلى داري حيث كانت أسرتي
والجيران وبعض الأصدقاء في انتظار أخبارنا وعودتنا سالمين طيلة فترة
العملية، والحمد لله!
رحم الله شهداء كنيستنا الخالدين في الذاكرة. وسيبقى الكاهنان
الشهيدان، مثالاً للراعي الصالح بحفاظهما على الوديعة وشهادتهما في
كنيستهما وبين رعيتهما. لمْ يهونا أو يضعفا أمام حقد الارهابيين ولا
خارت قواهما أو تخاذلا. كما يشهد لهما من عرفهما عن قرب، أنهما لم
يضعفا أمام المغريات في فترة خدمتهما، وكانت عديدة أمامهما. كما كان
موقفهما، ولاسيّما القس
"ثائر"، من القضايا الوطنية مشرّفًا ومن مستقبل المسيحيين واضحًا
بتفضيل الانتماء إلى الوطن موحدًا والالتصاق بجذوره والأمل برؤيته
معافًا وبعودة اللحمة الوطنية لأبنائه. فقد أحبّه المسلمُ قبل المسيحي
لتعاطفه مع المحتاجين، وكلُّ من كان يطرقُ بابَ كنيسته، لم يكن يُرجعُه
خائبًا. كما كان القس "وسيم" أيضًا، مع زميله الشهيد السعيد، أصدقاءَ
للشباب وحواضنَ للأطفال المرتادين لدروس التعليم المسيحي كلّ يوم جمعة
بهمّة معهودة ومتابعة همام، إلى جانب الصوت الرخيم الذي اتسم به القس
"وسيم"، وقد كنتُ أستأنس معه وأجاريه في اللحن حين يقيم الذبيحة
الإلهية، لإجادته الألحان والطقس السرياني. وهنا لا يسعني إلاّ القول
أيضًا، أننا فقدنا حضور الخوري "الختيار" روفائيل قطيمي الذي غادر
رعيته لاستكمال العلاج وآثر البقاء في بلد الاغتراب الذي اختاره،
متمنين له موفور الصحة والتوفيق.
كلمة أخيرة، أسوقها لأبناء كنيستنا خاصة والمسيحيين عامة: سوف تعود
كنيسة سيدة النجاة عروسًا للكنائس بعد أيام، بعد إعادة تأهيلها
وتقديسها لتفتح أبوابها للمصلّين من جديد. وبفضل مرتاديها وقاصديها
ومحبيها، سوف تتزيّن وتلبس حلة جديدة تزخر جنباتُها بأسماء شهدائها
الخالدين كي تبقى ذكراهم ذخرًا وعلامةً للشهادة التي بها رَووا بيت
الله بدمائهم الزكية لتكون بذارًا للحياة. كما سيتابعُ زملاء الكاهنين
الشهيدين، المشوار الذي كانا قطعاه بذات الهمّة والحرص والرعاية مع
الراعي الجديد للأبرشية.
أخيرًا، كتب إليّ أحد الأصدقاء المسلمين في رسالة ردٍّ على الشهادة
التي كتبتُها قبل عامٍ، يقول لي فيها (أنقلها حرفيًا):
((( "
ان جريمة كنيسة سيدة النجاة اختصرت بمضامينها
وبشاعتها كل الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء بلاد النهرين الاصلاء
منذ اكثر من 1400 عام عندما قدم الغزاة الاوائل من الجنوب وعبثوا
بالعراق قتلا وتدميرا باسم الله وادخلوا مفاهيم الكراهية والقسوة
ونشروا الهمجية والبدائية بكل اشكالهاالى يومنا هذا.
قرات بامعان سرد المجزرة التي وقعت في كنيسة سيدة النجاة على يد
مجموعة متوحشة تلوثت عقولهم بعقيدة الشر.
ان
المجزرة التي وقعت في الكنيسة يجب ان تكون حاضرة في قلب ووجدان كل من
يؤمن بالحياة والسلم والمحبة مع ضرورة الحفاظ على التذكير
بها وكشف وفضح عقائد الكراهية ووضع النقاط على الحروف وبجراة على
الاسباب والافكار التي حولت هؤلاء وهم في ريعان الشباب الى متوحشين
قتله للحياة بما في ذلك الفكر المسموم الجاثم في عقولهم وعقول غيرهم و
الذي يتناقض مع السجية البشرية . ليس اله من يدعو الى الكراهية
وليس دين من يبرر القتل.
اتمنى لك التوفيق في مواصلة عرض هذه الماساة الانسانية في فلم او على
الاقل فلم وثائقي هادف وباكثر من لغة."
مع
فائق تقديري واعتزازي
اخوك
علي
الشريف)))
لويس
إقليمس
بغداد، في 29 تشرين أول 2012
بين الآشوري والكلداني، ضاع السرياني!
بخديدا البهاء والشموخ: دمتِ ذخرًا وعشت فخرًا وترعرعتِ دهرًا
هي هي "بخديدا
"(قرقوش)، علت في سماء العزّ منذ انتصابها وازدهت ببهاء كنائسها وإيمان
أبنائها
ذخرًا برائحة المسك والطيب والكرم الأوفر، وزادها
فخرًا، أصالةُ العديد من رجالاتها منذ نشأتها، ممّن صانوا كبرياءها
وتراثها وتقاليدها، فظلّوا سادتها وقدوة لأبنائها لأنهم ببساطة ظلوا
كالطود الصلد الباسق، لم يرضخوا ولم يخنعوا ولم تخر قواهم أمام مغريات
الدهر أو مصائب الزمن ونكباته.
"بخديدا" بعمرها،
لم تركن ولم تركع ولم تستسلم إلاّ لإرادة خالقها وحامية سمائها وأرضها
شفيعتها العذراء مريم الطاهرة التي تزدهي باسمها كبرى كنائسها، رغم
محاولات كثيرة لتركيعها واستباحتها. قد تكون ضعفت في أوقات صعبة أمام
تحديات فاقت قدرتها، لكنها ظلّت منتصبة القامة، راسخة في إيمانها،
أمينة في رسالتها، ناضجة بأفكارها، رائقة بمثقفيها، شامخة بكبريائها،
فاخرة بشبابها وبناتها، عامرة بكنائسها ورجالاتها ورهبانها وراهباتها،
"تُنتج منهم وتصدّر" ما لم تستطع أية بلدة أخرى، ليس في الوطن والمنطقة
فحسب، بل ربما في العالم منذ نشأتها ولغاية الساعة. كيف لا، وبها ولها
وفيها الكثير ممّا كان يعشقه الطيرُ والقطى والحمام وذاك اللقلق الأمين
الذي كان يصطفي فيها كل عام، إلى جانب أشكال أخرى من طيور السماء التي
اختفت مأسوفًا على زياراتها الموسمية منذ نشأة هذه البلدة العريقة.
وبالمناسبة، إنّي لأشعر بالأسى، كلّما تذكرتُ ذلك "اللقلق الأمينِ"
الذي كان يحطّ صيفًا، على المجرسة القديمة لأقدم كنيسة في البلدة ويقيم
عشه على قمتها ليغادرها بعد فترة حضانة محسوبة،
ومعه أجيالٌ جديدة من صنوه بعد
أن يكون قد تبارك بخيرات وبركات المصلين المتواترة على أصوات الناقوس
الضخم آنذاك. لقد غادرها ذلك "اللقلق الأمين" إلى غير رجعة، مرغمًا في
بداية السبعينات من القرن الماضي، بسبب اتخاذ قرارٍ آنذاك بتهديم ذلك
الشاهد الباسق بحجة الحداثة في التشييد والعمارة. وما زال في ذكرياتي
شيءٌ من ذلك كلما ولجتُ الحوش الخارجي الأيمن من كنيسة الطاهرة الكبرى،
حيث ما لا أنساه مرّة وأنا أجرّب دق الناقوس عصرًا، بعد استئذان ساعور
الكنيسة- رحمه الله آنذاك- عندما رفعني الحبل الغليظ مسافةً إلى أعلى،
فزادني المنظرُ رعبُا، وأنا أتطلّع كيف تتحرك تلك العتلة لتقرع الناقوس
وتسمع صوته الذي كان يطال القرية كلها وينبهها لوقت الصلاة أو لمناسبة
ما وبحسب نوع الدقات التي كان يقصدها القارع!
على أية حالٍ، هذه
حال الأيام، لا شيء يدوم ولا أحد يتأبّد، وحده الخالق هو الباقي. أما
نحن وغيرنا، فلنا بلتأكيد، موعد مع من سبقنا إلى الديار الأخرى متى آن
الأوان.
"بخديدا" كانت
وستبقى نموذج البلدات المسيحية الشاهدة بإيمانها، وتراثها، وتقاليدها،
وكرمها، ومطبخها العامر، وجزيل غلاّتها، وحبّها، واحترامها لكلّ
قاصديها، أيًّا كانوا ومن أينما جاءوا. كما أنها ستبقى قبلة السريان
دون منازع، ومنارة تشع حبًا وحيوية وتجدّدًا لمن يريد الارتواء من
مناهلها العذبة والاستفادة من واقعها التقليدي والديني والاجتماعي بكل
حيويته، وما أكثرها!
"بخديدا"، هي أمّ
الكنائس والأخويات والأديرة، منها الطاهرة القديمة والطاهرة الكبرى
ومار يوحنا الديلمي ومار كوركيس ومارت شموني ومار يعقوب ومار سركيس
وباكوس ومارزينا ودير مار ناقورتايا ومار قرياقوس دون نسيان دير مار
بهنام التابع لها جغرافيًا، علاوة على ما أُضيف وسيُضاف إليها من كنائس
جديدة، بعونه الله راعيها، وبحماية السيدة العذراء، شفيعتها.
"بخديدا"،هي
اليوم، الحلقة الجميلة المنتخبة في لقاءات رجالات الكنائس وأنشطة
شبيبتها الحيوية العديدة المتنامية. وهي الضيعة الهادئة لمن يبحث عن
واحة وفرصة للراحة والأمان ونفض غبار تعب العمر وشقاء الأيام في الغربة
والهرب من منغصات أعمال الإرهاب والتكفير والتهجير الممنهج. وهي
الحاضنة لكل ثقافة وفن وعلم وإبداعٍ بمختلف أشكالها وألوانها
وتوجهاتها. كما أنها الترعة التي تستقي من كلّ جديد وحديث دون إماطة
اللثام عن قديمها الجميل الذي يبقى زهيا ملهمًا لكلّ هذا وذاك، رغم
اختلاط الأمور في أحدث سنواتها بالخوف من توشيحها ما لا يليق بها بل
ويشّذها ويبعدها عن صيانة ديمغرافيتها وجغرافيتها وتاريخها ضمن الوطن
الأمّ. ولنا في ذلك موعد!
"بخديدا" اليوم
بأروع حلّتها، عروسٌ عامرةٌ بالفرح والإيمان، وأيضًا بالرجاء بصحوة
جديدة تحيي فيها غيرة من صانوها في عهود السواد والظلام والقهر والغدر،
وهي ليست مستثنى من هجمة بل من هجماتٍ شرسة قادمة قد تقصف هامتها بغفلة
من المتلاعبين الجدد بمصيرها والمزايدين على مستقبلها لأجل مغريات
تافهة لن تدوم، إذا لم يحسنوا التصرف ويعملوا الحكمة في اتخاذ ما
ينبغي، فيما لو استجدّت أحداث، وهي غير بعيدة في الأفق!
"بخديدا"، هذه
الأيام، طغت عليها سعادة الإنعامات البطريركية الجزيلة بالجملة، أدام
الله مبتكرها وأعزّه للأصلح والأولى منها، وبما يعزّز مكانتها
واستقلاليتها ووحدتها مع باقي نسيج الوطن الأم. فهنيئًا للقساوسة الذين
تطرّزت حللهم بألوان قرمزية
وحمراء زاهية، يعلوها لمزيدٍ
من الأبهة صليبٌ، هو في واقعه ومفهومه ليس علامة تبختر أو تيه، بقدر ما
يعني زيادة حملٍ ثقيلٍ آخر من الوفاء والمحبة والإنصاف والبذل والعطاء
والتواضع والخدمة المجانية، على كاهلِ من يحمله، فهل من معتبر!
"بخديدا" هذه
الأيام تفخر بلا اغترار، بزيادة كنائسها بوضع حجر الأساس لكنيسة جديدة
تحمل اسم مار يوسف، تحتاجها البلدة كي تضيف دليلًا آخر على أصالتها في
الإيمان و برسالتها المسيحية والسريانية بخاصة، ليس في المنطقة فحسب،
بل على صعيد البلاد والشرق أيضًا. لقد أصبحت قبلة الباحثين والمتشوّقين
لتراثٍ مسيحي سريانيٍّ ولبقايا إيمان ووجودٍ مسيحي زاخرٍ ومتجدّد بسببٍ
من موقعها وثقل وزنها وتعاظمِ أعداد مؤمنيها وممّن يقصدها لمزيد من
الأمن والأمان وراحة النفس والبال.
و"بخديدا"، سبق
وأن احتفلت في سنوات عجاف بمشاريع عملاقة على صعيد البلاد والمنطقة،
وهي اليوم تحتفل بافتتاح قاعة جميلة جديدة للمناسبات، يعود فيها الفضل
لهمّة عالية لواحد من رجالاتها القديرين من الذين كنا دائمًا نصبو منهم
بقاءهم أنقياء اليد والجلباب والغيرة دون مسايرة أو معايرة أو مغايرة
يُشمّ منها رائحة غير مقبولة على صعيد وحدة الهدف والوطن ومصلحة عموم
المكوّن المسيحي. نأمل دومًا،
أن تبقى هذه البلدة العريقة، أحد المراكز الوطنية المسيحية المهمة التي
يُحتذى بها وقبلة ومأوى
لكلِّ محبيها وعاشقيها وليس الطامعين بها. إني أعتقد، أن مثل هذه
الهمّة العالية مطلوبة ومرحبٌ بها هذه الأيام أكثر من غيرها، من أجل
الحدّ من أيّة تجاوزات أو أطماعٍ - على اختلاف مصادرها وأشكالها
وتوجهاتها- على حقوق أبناء المنطقة عامة، والبلدات المسيحية فيها
بخاصة. هذه الهمّة المشكورة، التي يُشار إليها بالبنان، من الأجدر
بحاملها أن تبقيه رصين النفس والفكر والهدف، جامعًا لا مفرِّقًا،
موحِّدًا لا مجزِّئًا، حاميًا لا مفرِّطًا، محبًا غير حاقد، عطوفًا غير
غاضب،
متواضعًا لا متجبرًا
ملوّحًا بالنصر ولو مظلومًا، متفتحًا
غير منغلق، مسايرًا ومحاورًا مع الكلّ ولأجل الكلّ ولمصلحة الكلّ، حتى
مع من قد يختلف معه في الفكر والرأي والتوجه. فالإختلاف، مهما حصل ودام
لا يفسد في الودّ قضية، ولا ينبغي تحوّله إلى خلاف وشقاق وعناد، قد
يعمي البصر والبصيرة! وليعلم هذا وذاك، أن هناك أيضًا، من يعمل في
الخفاء لمصلحة هذه البلدة الطيبة، دون واجهة أو تحفيزٍ مادّي أو إعلام
مأجور، إلاّ من غيرة شخصية تطوّعية، يسعى فيها وبها إلى تحسين صورة
البلدة وأهلها الطيبين وجعلها في عداد الحاضرات المهمّات والجميلات على
الأصعدة كافة، ودون مقابل.
وفي الختام، أقول
عندما يشعر الفرد بغيرة البيت تأكلهُ، حينئذٍ ينطلق وفي مخيلته بناء
ذلك البيت على أسس متينة وصخرة قوية ووفق طرازٍ مقبول من الساكنين
والمتفرجين والجيران على السواء، لا على رمل الأحلام الفارغة والوعود
الوردية التي لا يُجتنى منها غير الجلبة والهيصة والفرقعة الفارغة التي
لا تدوم. وبلدة "بخديدا"، بسبب هذا وذاك، هي اليوم في مفترق طرق بسبب
تجاذبات سياسية طامعة في موقعها وفي أهلها ومستقبلها. ولئن كنتُ من
الداعين بشدّة إلى الاحتفاظ بتراثنا "الباخديدي" الثري وتقاليدنا
الرائعة في بساطة الحياة وتعقّدها على السواء، وإلى أرّخة أزقتنا
القديمة وما تبقى من بيوتاتها المتهالكة، وإلى الالتزام الأخلاقي
بلهجتنا السريانية التي قهرتها العربية بقوة تداخلها وبسبب من ضعف
التزام المتحدثين بمفرداتها السريانية الأصيلة وعلى رأسهم رجال
الكنيسة، إلاّ أني أخشى ضياع كل هذه الآمال والأحلام والتمنيات في غفلة
من الزمن وفي لحظة قد تتصادم فيها الحضارات والإثنيات والقوميات
والأديان والمذاهب داخل الوطن، لتتيه في دهاليز السياسة والسياسيين
الطامعين من جميع المكونات والملل والإثنيات، من الذين لا همّ لهم سوى
تسخير مآثر هذه البلدة وطاقاتها ونقاط قوتها وطيبة أهلها وأصالتهم،
وتجيير ذلك كلٌ لحسابه ولمصلحته ومنفعة كيانه. والغد لناظره قريب!
ناشط مدني
بغداد، في 20 آب 2012
هل من صحوة
مسيحية جديدة في العراق؟
قد يسأل سائل: لماذا هذا
الإصرار من قبل الحكام الجدد في العراق، الذين نصّبهم الغازي الأمريكي
بالتنسيق مع البلدان الأوربية "العجوز"، المحسوبة ظلمًا على المسيحية،
لماذا إصرارهم المعتاد على تجاهل وتهميش
الحقوق
المواطنية الكاملة غير المنقوصة للمكوّن المسيحي بجميع طقوسه وطوائفه
ومشايخه ومعهم سائر الأقليات الأخرى؟ أو بالأحرى، لماذا هذا التهميش
المنهجي المتعمّد لهم ماضٍ
قدمًا ودون هوادة، غير مبالٍ بالأصوات الشعبية والوطنية الصارخة التي
تطالب بإنهاء مرحلة المحاصصة المقيتة التي بسببها، صارت المكونات
القليلة العدد، أي الأقليات، ضحية وفريسة لأطماع القوميات والكتل
الكبيرة التي لم تكن تحلم ولو بجزء يسيرٍ ممّا نالته من مكاسب طائفية
وعرقية ومذهبية بدعمٍ وتشجيع من الغازي الأمريكي البغيض. كلَّ يوم نسمع
ونطّلع ونشاهد مسرحيات إعلامية وخطب رنّانة من كل الفئات والأحزاب ومن
مختلف أشكال الرجال وأشباههم،
ومن النساء السافرات والمعمّمات على السواء، من الذين
ألقت بهم الأقدار الطائشة في الحكم، وهم ينددون علنًا، بمبدأ المحاصصة
الطائفية ويلعنون مخططيها ومشجعيها والقائمين عليها، ولكنهم في الواقع،
هم من أشدّ المطالبين بتثبيتها في كلّ مناسبة يشعرون فيها باهتزاز
مصالحهم في حالة تركها وإلغائها، بسبب من توجّسهم من فقدان ما قد تدرّ
عليهم، مذهبًا وطائفةً وكتلةً وعشيرةً ومصلحةً شخصيةً، من أرباح
ومنافع، عندما يحسبونها بهذه الطريقة وبشيء غريبٍ من الدقة المتناهية.
محاصصة في كلّ شيء، حتى العظم
أليس معيبًا، أن تنزل الأطماع
الطائفية والمذهبية أخيرًا، حتى على عملية اختيار طيارين لمقاتلات
F 16، التي تنوي الحكومة تجهيز
قوتنا الجوية بها، وهي التي تهالكت بسبب الإهمال في الجانب التسليحي
والدفاعي للبلد وبسبب التجاذبات العقيمة فيما بينها؟ ألا ينبغي أن
يعتمد مثل هذا البرنامج الوطني العسكري، معايير عديدة في اللياقة
والذكاء والدهاء والكفاءة والعلمية؟ أما الحدث الآخر الذي لا يقلّ في
تمريره المستهجن وبشيء من التجاهل والتهاون، فقد كان في عملية اختيار
أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وبإمكانية الذهاب إلى زيادة عدد
أعضائها، كي تشمل ممثلين عن مكوّنات وكتل مستبعدة عن هذا الجهاز
المفترض أن يكون أعضاؤه من الفنيين والمختصين وليس ممثلي كيانات وكتل
متنفذة بفعل المحاصصة. لذا كان التلكؤ في تلبية هذا الطلب المشروع وحصل
التأجيل في النظر بالمقترح، بسبب خلافات سياسية لكتل تريد الاستئثار
بها والاستحواذ على نوافذها، كلّ لصالحها. لقد أظهر المثلّث المتنفذ في
الحكم في هذه النافذة، معدنه الحقيقي حين رفضه زيادة أعضاء المفوضية
ليشمل فئات ومكوّنات مهمّشة لا يريدون لها أن تتنفس من هواء الوطن، رغم
أصالتها في الوطنية والحضارة وكفاءتها في العمل والعلم والمعرفة.
فراحوا يخنقونها في رؤياها ويشددون من قبضتهم على تحرّكاتها ومطالبها
الوطنية، بغية بقاء هذه المكوّنات الصغيرة "الأقليات"، تحت رحمتها
وأسيرة حاجاتها، كي لا تفضح فعالهم المشبوهة وتصرفاتهم غير المشروعة،
رغم إقرار الدستور، على ما فيه من مثالب وعيوب، بحقوق جميع المواطنين
على السواء. وقد تزامن هذان الحدثان، مع فعل آخر لممثلي الشعب في مجلس
النواب العراقي حين أصرّ مجلس النواب على تقويض الديمقراطية الفتية في
البلاد بخرق الدستور، من خلال التعديل المجحف لقانون انتخاب مجالس
المحافظات والأقضية والنواحي، الذي كرّس إصراره السابق بأحقية الكتل
الكبيرة الأقوى في الحصول على المقاعد الشاغرة إن وجدت. وهذا انتهاك
فاضح لحق الناخبين في اختيار ممثليهم، كما أنه سرقة مكشوفة لصوت الناخب
الذي يتجشم عناء السفر والتنقل متكبدًا المخاطر من أجل تعزيز خطوات
الديمقراطية المتعثرة بسبب تدخلات الكتل الكبيرة.
كلّ شيء لمصلحة الكيانات الكبيرة
كلّ شيء اليوم، وفي ظلّ
مفردات الكتل الحاكمة، ينبغي أن يوجه وينطلق من مصلحة هذه الكتل وهذه
الكيانات التي تصرُّ على الاستحواذ على كلّ شيء، وهي لا شيء مفيدٌ
لديها لتعطيه لما تبقى من شعب العراق الذليل. فإذا كان سياسيونا قد
ارتأوا النزول إلى هذا الدرك السفلي من التعامل بالوطن والمواطنة،
فليُقرأ السلام على "سنعار" (عراق) الحضارة والريادة والعظمة، هذا إن
بقي فيه يسيرٌ من تلك القيم التي مازلنا متشبثين بها ونعلّل النفس
بالبقاء من أجلها في هذا البد الذي يأبى الوطنيون الأصلاء ومحبّوه
الحقيقيون مغادرته وتركه فريسة بيد ذئاب مفترسة تريد أن تأكل الأخضر
واليابس وألاّ تبقي من أرضه ونفطه ومياهه وهوائه ما قد يجد فيه سكانه
الأصليون من مأوى وملاذ آمن ومن خيرات وفيرة يتم نهبها في عزّ النهار.
إذا كان السياسيون الجدد يرومون حقًا، تطوير النظام الديمقراطي الذي
صدّره الغازي الأمريكي للعراق، فما عليهم إلاّ ممارسة هذه اللعبة
بنزاهة وبروح رياضية وبإباء وطني واضح لا لبس فيه، كي ينعم البلد وأهله
بفوائدها ومفاعيلها والغايات التي تطلبت تغيير النظام الشمولي
الدكتاتوري السابق، بحسب ادعائهم، وإلاّ كانت تلك لعبة قذرة، سيدينهم
الخالق عليها ويحاسب كلّ من فرّط بسلام العراق وخيراته وحقوق أهله
ومسيرتهم الحضارية عبر السنين الغوابر رغم آلامها ومنغصاتها.
دوائر الدولة إقطاعيات
محرّمة
عندما تعالت أصوات النواب
الشرفاء الذين نطقوا باسم ناخبيهم واعترضوا على التدخل السافر من قبل
عدد من العناصر المتنفذة في الحكومة وفي الجهاز التشريعي على مسألة
اختيار طياري المقتلات
F16، ربما قامت عليهم القيامة حينذاك واتهموا بموالاة "النظام البعثي البائد"،
أو بالعنصرية والتمييز لجهة دون أخرى. وربما ذهب البعض لإلصاق تهمة
عربية وإسلامية معتادة، بإمكانية ارتباط هؤلاء المعترضين،
بالصهيونية العالمية والموساد
التي تكون – حسب الرؤية المريضة الدائمة للبعض في المنطقة- على علاقة
بهؤلاء الطيارين المختارين وبالقادة الذين اختاروهم ليكونوا صقورًا
ونسورًا شجعانًا وحقيقيين لبلدهم الذي تنهشه أطماع من يحكمه بلا حكمة
ولا دراية ولا خطة ولا عدل. فلا القضاء عادل ومستقل، ولا العسكر محترف
وجاهز، ولا الشرطة كفء ومتأهبة، ولا دوائر الدولة تنمّ عن مؤسسات وطنية
تعمل بضمير حي، ولا القادة والكتل السياسية التي تدّعي الشرعية في
الحكم قادرة على توفير مقومات الأمن والأمان وأبسط الخدمات، بعد تدمير
ما كان قائمًا أصلاً، بحجج واهية لا ترقى إلى أبسط أصول القناعة لدى
المواطن العراقي الذي تنبه ووعى للفساد والصفقات المشبوهة التي يتمّ
تمريرها في دوائر الدولة المختلفة ووزاراتها، لصالح مكوّنات وأطياف
طائفية درّت عليهم مليارات الدولارات التي تكدست بها مصارف عالمية.
هذا، بحسب وكالة أمريكية ومعلومات سرّبتها سفارتهم في بغداد، عندما
تحدثت عن حسابات مصرفية ضخمة تتزايد باضطراد لمسؤولين عراقيين في
الحكم. ألم تستعر نيرانُ الكتل السياسية حين تشكيل الحكومة الأخيرة
ليبحث كلّ فريق عن ضالته عبر وزارة أو هيئة أو دائرة كي يقتنص منها ما
يمكنه طيلة نفاذية ولاية الحكومة؟ وكأن
وزارات الدولة ومؤسساتها، أصبحت قطاعات مستقطعة للفريق الذي
يتولاها، فينهش منها ما استطاع من "كوميسيونات" وحصص بنسب مئوية من كل
عقد محال فيها. وبطبيعة الحال، هذه العقود قلّما تخرج عن نطاق المعارف
والمقربين من الكتل والأحزاب التي تتولى تلك الوزارات.
تقسيم المقسّم وتجزئة
المجزّأ
وتأتي الخطوة الأخيرة
بالإنعام على المكوّن التركماني لينضمّ إلى صفوف القوميتين الكبيرتين،
بكل امتيازاتها وحقوقها
في الدستور والقوانين الوضعية والمستحدثة، ليزيد من شكوك الأقليات،
ولاسيّما المكوّن المسيحي، بالوعي إلى ما يمكن أن يكون وراء هذه الخطوة
من مؤامرة وصفقات ضدّ هذا المكوّن من جانب المثلّث
الحاكم، وقد تكشفه الأيام القادمة. إن مثل هذه الخطوة الخطيرة،
إنما القصد منها تقسيم المكونات الأخرى المعرّضة للخطر، أي "الأقليات"،
ومحاولة إضعاف قوتها وطاقاتها الوطنية والإثنية، من خلال تشظيتها لتصبّ
في خانة تقسيم المقسم أصلاً وتفتيت ما تكتنزه هذه من طاقات، لترضى في
النهاية بالطاعة والولاء لأحد الأطراف الذي سينصّب نفسه وليًا ووصيًا
عليها بمباركة من القوى الخارجية، وعلى رأسها الغازي الأمريكي وتابعوه
من الحكومات الأوربية المتتالية على الحكم، من الذين فقد سياسيوها كلّ
أدوات الدّين وحتى الأخلاق الإنسانية واستبدلوها بكلّ ما هو مادّي
وترفيهي من ترّهات المادة والجنس والميوعة والإباحية
المستحكمة في بلدانهم. إن هذا الإجراء الجديد، رغم إيماننا
المطلق بقوة المكوّن التركماني وأحقيته في استعادة دوره الوطني والإثني
كقوة بشرية مهمة في مسيرة الديمقراطية في العراق، ولاسيّما في مواقع
تواجده التاريخية، ومنها كركوك وتوابعها بصورة خاصة، من شأنه بالمقابل،
أن يشقّ مطالب باقي المكونات التي شاءت الأقدار أن تتناقص بفعل الأحداث
المأساوية التي شهدتها الساحة العراقية ولاسيّما المكوّن المسيحي الذي
تعرّض أكثر من غيره لتطهير ديني بفعل فاعل وبخطة منهجية لا يستبعد
اشتراك أطراف خارجية بها ويتم تنفيذها بأياد عراقية. ولعلّ المكوّن
المسيحي بهذه الخطوة، سيكون بالتأكيد، أحد هذه الأطراف التي سيطالها
غبنٌ جديد قديمٌ، لم تعره أهميته، سائرُ الحكومات المتعاقبة على الدولة
العراقية، لا في عهد الدكتاتوريات السابقة ولا بعد سقوط هذه.
ديوان أوقاف المسيحيين،
آخر تلك الخروقات
وآخر ما سمعناه وشهدناه
ضمن ذات السياق، أي في تقويض أهمية المكوّن المسيحي في البلاد، جاء في
مؤسسة ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى، عندما استبدلت تسميتها
وتحددت أهميتها ورئاستها بمساواة الطوائف المسيحية مع الطائفتين
الإيزيدية والصابئة المندائية اللتين تفتقران إلى ما تتمتع به الأولى
من أوقاف ومن مؤسسات دينية وثقافية واجتماعية وتراثية وآثارية ومن
معاهد وأتباع ورجال دين ومن اتصالات عالمية ومن علاقات واسعة مع
العالم. وهذا ما يتطلب وقفة واحدة لردّ مشروع القانون الجديد المقرّ
مؤخرًا، إلى الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر فيه واستعادة المكوّن
المسيحي مكانته وأهميته في هذه المؤسسة التي ساوى فيها المشرّع بين
مجاميع كثيرة من الطوائف المسيحية مع طائفتين تفتقران إلى مؤسسات
وأوقاف منتظمة تاريخيًا وتنظيميًا. وحسنًا، فعل رؤساء الطوائف المسيحية
حين انبروا للاعتراض عليه بهذه السرعة معبرين عن استيائهم من القانون
الجديد وبمطالبة الجهات الرسمية والتنفيذية بالاستجابة لما من شأنه أن
ينصف طوائفهم وشعبهم من الإجحاف الذي ألحقه بهم هذا القانون. وإنّي
أرى، أنه آن الأوان لصحوة جديدة منظمة ومنهجية من جانب رؤساء الطوائف
دون استثناء، يدعمهم في هذه الجهود، عمومو الشعب المسيحي ومعهم شمل
النواب المسيحيين المفترض تبيان استيائهم من مثل هذه الخطوة من جانب
السلطة التشريعية غير الواعية لما يمكن أن يترتب على هذا القانون في
حالة إقراره من سلبيات حين تعيين شخصية لا تنتمي إلى إحدى الطوائف
المسيحية على رأس هذه المؤسسة المهمة، حيث من الممكن حينئذٍ التحكم
بمقدرات أوقاف المسيحيين
. وإني أرى أن الأمور لن تستقيم إلاّ
بثلاث لا رابع سواها:
-
إعادة العمل بنظام وزارة وطنية للأوقاف والشؤون الدينية على أسس جديدة
وعادلة، يكون لجميع المكوّنات الدينية فيها ممثلاً بدرجة خاصة، يعنى
بأوقاف طائفته.
-
أو، العودة إلى نظام ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى وإجراء
التعديلات الضرورية على بعض البنود التي يمكن أن يكون فيها ثغرة.
-
أو، تخصيص ديوان وقفي للمكوّنات الدينية الثلاث، أي أن يكون لكلّ من
المسيحيين بجميع طوائفهم وكذلك الآيزيديين والصابئة المندائيين، دائرة
ديوان مستقلة بأوقاف الطائفة.
وبغير ذلك، لن يكون الأمر مقبولاً
من جانب عموم الطوائف المسيحية. وحينها، وفي حالة عدم الاستجابة لمثل
هذا الحق وإلغاء الغبن الذي لحق بالمكوّن المسيحي بسبب تشريع هذا
القانون والمصادقة عليه دون رضى الطرف المسيحي، سيضطرّ الشعب المسيحي
ومعه رؤساؤه الروحيون، للقيام بما من شأنه رفع هذا الإجحاف بالطرق التي
يرتأون تفعيلها واستخدامها حتى تحقيق العدالة وإعادته إلى البرلمان
والحكومة للمراجعة.
كفانا خنوعًا وسجالات
عقيمة
مقابل كل هذا الكمّ الهائل
من أعمال التهميش والإقصاء والاستهزاء بمقدّرات أبناء الأقليات
الأصيلة، ولاسيّما المسيحيين بكافة أطيافهم وطقوسهم، من الذين ضعفت
قواهم وخارت طاقاتهم في مقاومة الكثير من الشرور والنوائب والجرائم
والمؤامرات التي طالتهم وحيكت ضدّهم، منذ عهود الأنظمة البائدة لغاية
الساعة، والتي أخذت منذ الغزو الأمريكي في 2003، طورًا جديدًا من العنف
الطائفي والحقد الديني... أمام هذه كلهّا، أليس الأجدر أن يتطور موقفنا
وننتهج استراتيجية جديدة مضادّة من الهجوم بالمطالب المشروعة بدل
اللهاث وراء فتات من يدّعي حمايتنا ويتبجّح بالدفاع عن حقوقنا، كذبًا
وبهتانًا، فيما هو يتنصل عن مطالبنا عندما يتعلق الأمر بحقوقنا
المشروعة ومصالح مناطقنا. ألم يتعهد الأكراد، كما فعل أهل السنة
والشيعة مرارًا، قادة ورجال دين وسياسيين، بدعم مناطق المسيحيين وإيجاد
حلول ناجعة لمشاكل مناطقهم ومنع أي تغيير ديمغرافي فيها، دعمًا للبقية
الباقية منهم من أجل تثبيتهم في مناطقهم وعدم مغادرة أرض الوطن، لكونهم
أصلاء فيه بحسب هذه الادّعاءات والإعلانات المجانية؟ ولكن، عندما يتعلق
الأمر باتخاذ قرارات، برلمانية أو تنفيذية في مجالس المحافظات والأقضية
والنواحي، قد يرون فيها تهديدًا لتعزيز قبضتهم على هذا المكوّن وفقدان
سيطرتهم علي أتباعه، نراهم يصوّتون ضدّ مصالح شعبنا ويصطفون مع الطرف
المقابل. ألم يحصل ذلك في العديد من القرارات التي اتخذتها الجهات
الحكومية والتشريعية؟ يؤسفني أن أقول، هناك من المسيحيين، دون استثناء
طرف منهم، مَن ركبَ موجة التابع الدائم للغريب عنه وتفضيله على أبناء
شعبه. وهذه ناقصة فينا، لا تنمّ إلاّ عن ميلٍ دائمٍ بالشعور بالنقص
والضعف وعدم القدرة على فرض الرأي والمطالبة بالحقوق والإصرار عليها
مهما كانت النتائج. أنظروا، كيف حصل المكوّن التركماني على مطالبه
بإصراره وعناده وعلاقاته وتسريباته وضغوطاته المحلية والإقليمية التي
نال من ورائها ما صبا إليه وارتوى به. أمّا نحن، فكلٌّ منا يغنّي على
ليلاه، فيما يصرّ بعضنا ويعاند على تقسيم هذا الشعب الواحد، تارة
بالمطالبة باعتباره شعبًا مستقلاًّ، وتارة بكونه يشكل الأغلبية بين
المسيحيين، وبهذا يستحق أن يكون القومية الثالثة، ولا أدري من أين أتى
هذا البعض بمثل هذه الفرية وهذه الكذبة التي لم تعد تنطلي على أحد، حتى
البسطاء من أبناء شعبنا بل حتى الغرباء عنه. إني هنا، لستُ بصدد انتقاد
مثل هذه المطالبات غير المنطقية، بل الجافية والمؤذية أحيانًا، بقدر ما
أبغي التعبير عن أملي بانتهاج سياسة جديدة واستراتيجية مسيحية شاملة
تكون المصلحة العليا فيها للبلاد أولاً وقبل كلّ شيء، ثمّ مصلحة عموم
شعبنا موحدًا، ديناً ولغة وكيانًا. إنه، وبغير ذلك، لن نكون قادرين على
مواجهة الكمّ الهائل من الأكاذيب والدسائس التي تُحاك ضدّنا في العلن
والخفاء، من خلال التمويه بالتودّد لنا والإيحاء بالدفاع عن حقوقنا
ومنحنا ما نستحقه منها ممّا تفرضه مواطنتنا الصادقة وحبُّنا لأرضنا
وديننا بمختلف مذاهبنا. فهل من مؤتمرٍ صادق ونزيه يعالج هذه الإرهاصات؟
لا للرضوخ للآراء المهجرية
إنّي إذ أصطفّ مع من دعا
ويدعو إلى إعادة بناء الشخصية المسيحية المعنوية والوضعية، بكل طوائفها
وتياراتها، وتوجيهها وطنيًا ودينيًا معًا وفق أسس جديدة تزيل آثار
الظلم والاضطهاد الذي أتى به الغزو الأمريكي وحلفاؤه، أجدّد الدعوة
للإخوة الانفصاليين الواقعين تحت تأثير تيارات "مهاجرية" لا همّ
لدعاتها ومحرّضيها، سوى شقّ الصف المسيحي، الديني منه والقومي، ممّا قد
يكون فأل شرّ على من آثر البقاء في الوطن ومواصلة مشواره متآلفًا
متعايشًا مع جيرانه وأصدقائه وأهله وأقاربه. إنّ مثل هذه التدخلات
الخارجية، إذا صيغت وسُوّقت بنيّة مشبوهة وغاية منقوصة وإرادة مهزوزة،
قد تنعكس آثارها سلبًا على كياننا ككلّ. هناك العديد من الخطوات التي
قد تلزمنا، مثقفين ورجال دين وسياسيين ومنظمات مدنية وعامة الشعب، كي
نحققها من أجل وضع اليد على المحراث وعلى أرضٍ قوية، صلدة المطالب،
وواضحة التفاهمات وأمينة في التحالفات الرصينة الصادقة بيننا أولاً ومع
شركائنا بالتالي. وهذا، مما سيعزّز من قوتنا وطاقاتنا وقدراتنا في
التفاوض والمناورة والمواجهة، إن اضطررنا لذلك، أحيانًا. ذلكم هو بيت
القصيد، عندما نكسر كتلة ثلج الاستسلام والاستضعاف والتمسكن والخنوع
والانحناء التي تلفّنا في حياتنا أمام الغريب، وقد اعتدنا عليها بفعل
الفطرة والعادة والطبع.
أملٌ بهجرة معاكسة
إنني أعذر أحيانًا، بعضًا
من نوابنا، ممثلي شعبنا في البرلمان، الذين أكنّ لهم جميعًا، كلّ
احترام، من صعوبةٍ في فرض رأيهم وسط هرج ومرج مجلس النواب أحيانًا أو
بسبب عدم قدرتهم على مناطحة اللاعبين الكبار، أصحاب الباع العريض في
اختزال الكتل والمكوّنات الصغيرة التي يعدّونها تابعًا صغيرًا لا يرقى
لأخذ رأيه في أحيانٍ كثيرة. ولكني أعتب على أحزاب وتنظيمات شعبنا من
تناكبٍ وتنافس غير مقبول في تصدّر التصريحات والبيانات والمقالات التي
تفتقر أحيانًا إلى وفرة الدقة فيها وجدّية المطلب، علاوة على الإيغال
في المكابرة والأولوية والمفاضلة، وهي عناوين مقيتة بدأ يكرهها الجميع
ويلفظها عموم الشعب، حتى البسطاء منهم. أقول، كفانا مثل هذه المغامرات
القزمية التي لا ولن تنفع، بقدر ما ستزيد من تشظّي اللحمة المسيحية
المتبقية على ضعفها، وتفتّ من عزم من بقي من أبناء شعبنا وتفقدهم صواب
البقاء في أرض الآباء والأجداد، ليلقوا مصير من راهن على الغرب فردوسًا
سرمديًا. وسوف تأتي الأيام، ولن تكون ببعيدة، لنشهد - إن حبانا الله
ذلك- عودة ميمونة معاكسة لمن اغترّ أو غُرّرَ به للتضحية بإرثه وأرضه
وأهله وأحبائه من أجل ترفٍ أساسُهُ الحسد والغيرة والتباهي بالعيش في
أرض الغال والعم سام ومجاهل المحيطات والبحار وحتى الصحارى.
لويس إقليمس
بغداد، في 8 آب 2012
هكذا تنقرض الشعوب
ما دعاني لكتابة هذه الأسطر القليلة، هو ما تشهده الساحة "القومية؟"
ذات التسمية القطارية "الكلدانية-السريانية-الآشورية"، هذه الأيام، من
سجالات واتهامات بين أطراف عديدة بسبب جعجع الأبراج الأربعة المقرّر
إنشاؤها في بلدة عينكاوة العريقة، وبسبب التصريحات والتأويلات والمواقف
المتباينة لما يسمى بتجمع التنظيميات القومية، حول هذا المشروع
المشبوه. فقد نسي أو تناسى البعض، أن هذا المشروع قد أخذ طريقه المشروع
والقانوني لدى سلطات الإقليم في عمليات البيع والشراء المتعارف عليها
في السوق في هذه البلدة ووفق الأصول المتبعة بلديًا، وأن كل الجهات قد
أخذت نصيبها من عميلة البيع والشراء والوساطة. وأن الوقت قد استنفذ
تمامًا وأن "الفأس وقع بالرأس"، وابتلع أهالي هذه البلدة الطيبة الطعم
الذي لقموا به بتطويرها وعصرنتها. وهذه كانت النتيجة.
عينكاوة الجميلة، هذه المدينة كانت عندي وما تزال وستبقى من البلدات
العزيزات، كما هي الحال على قلوب كل العراقيين الأصلاء والمسيحيين منهم
بصورة خاصة، سواء من كانوا في بلدان الاغتراب أو من الرابضين الصابرين
المجالدين في الداخل، من الذين لم يؤثروا ترف الحياة المرفهة التي سعى
إليها الكثيرون بكل الوسائل لبلوغ بلدان المهاجر التي يختالون فيها
وبها على من بقي صامدًا في أرض الآباء والأجداد . هذه البلدة الجميلة
تركها بعض أهلها، فيما آخرون باعوها برخص التراب للغرباء بحجة التطوير
والعصرنة رسمية فعلها حين استيلائها على آلاف الدونمات لغرض إقامة مطار
مدينة أربيل على أراضيها العذراء. فبعضٌ من العتب إذن، يقع على من
باعها بطريقته الخاصة وبعض منه يقع أيضًا على من غادرها بغير رجعة
ليستقر في بلدان الاغتراب، غير نادم على تضحيته بملكه وداره وأرضه. على
أية حالٍ، لكل امرئ ظروفه وأسبابه وغاياته، لن أدخل في تفاصيلها
وثناياها كي لا أجرح فلانًا وعلاّنًا، ممّن
راهن بكل ما لديه كي يخسر أهله وأرضه وتراثه ليروح "يتسكع"،
عذرًا لينشد أرض الأحلام وما ستدره عليه وعلى أجياله من مغانم
وامتيازات ومفاخر لها بداية وليس لها نهاية!. عينكاوة، مثلها مثل ألقوش
وقرقوش وبرطلة وكرمليس وتلكيف وتلسقف وباقوفا وباطنيايا وغيرها من
البلدات والقرى المسيحية المتميزة بتراثها وعاداتها، ستبقى شوكة في
عيون الغرباء والمدسوسين، يرنون إليها ويحلمون بتدنيسها وغزوها إن
أمكنهم ذلك، من أجل محو تاريخها المسيحي الناصع، والذي يذكرنا اليوم
نمامًا، بما آلت إليه ممالك المناذرة وقصورها وحواضرها الشهيرة في
الحيرة والكوفة والنجف، أيام النعمان بن المنذر، آخر ملوكها، حيث يتم
هذه الأيام، اكتشاف آثار الكنائس والأديرة التي زينت أرض العراق سحابة
قرون من حكم المسيحية في أجزاء كبيرة من العراق والمنطقة حتى قدوم
الغزو الإسلامي الذي كسح ما كان قدامه ولم يرحم أحدًا.
هؤلاء الذين يتباكون اليوم على ما يسمّى بإرهاصات التغيير الديمغرافي
وأسبابه ونتائجه، ألم يدر في خلدهم كيف آلت الأمور إلى هذه النتائج
ولماذا؟ أم إنهم تعودوا على إلقاء الكلام جزافًا، و"حيّا الله كيفما
يسقط فليسقط"، كما يقول الحديث الدارج! طبيعي جدًا أن تتغير الحياة
وتتطور والشعوب وتنقلب المناطق في عالمٍ سريع التقلبات والتقليعات
والطموحات. ولكن الذي يصمد ويصابر ويجالد برغم كل هذه الصواعق
والتبدلات والإرهاصات، هو الرابح، إن هو حافظ على أصالته والتزم داره
وأهله وبلدته ولم يهجرها برغم كل ما يحيق به، حتى لو كان ممّا قد نغّص
حياته وأحاقت بها الأخطار التي لم تنقطع ولن تتوقف عبر التاريخ. تلكم
هي شريعة الحياة وقوانينها، حتى لو كانت ظالمة وفاقدة الشرعية
والإنسانية. لقد أصبح البقاء في أرض الآباء والأجداد استثناءً هذه
الأيام، فيما أصبحت الهجرة قاعدة للعديدين ممّن ركبتهم موجة الأحلام
الوردية التي يتصورون قدرتها على نقلهم إلى هوس الجنان الخالدة في
بلدان الاغتراب. ألم يسأل العديد ممن بلغ أقاصي بلدان الاغتراب، كيف
يقضي حياته، إمّا منزويًا بين جدران مسكنه إن كان عاطلاً يستجدي ما
تتعطف به حكومات ذلك البلد الذي استقبله ليستغله وفق سياسة حكامه، أو
وسط فورة العمل التي لا ترفق به ولا ترحم حاله بحيث لا تسمح له حتى
بلقاء أحبائه وفلذات أكباده إلاّ فيما ندر وفي مناسبات متباعدة
استثنائية.
خلاصة الكلام، أن العديد من الذين يبكون أو يتباكون اليوم، على الهموم
القديمة الجديدة التي تُتهم بها جهات كثيرة، مقصدُها إحداث تغييرات
ديمغرافية في بنية المناطق المسيحية، بصورة خاصة، كانوا هم جزءًا من
هذه الأسباب بقصد أو بغير قصد، ومعهم من غادر الأرض وترك الديار
واستقرّ في بلاد الغال وآثر بهرجة بلاد العم سام وعمومته على أرضه
وأهله ووطنه. قالوا ويقولون، أن ضيق الحياة بكل أسبابها خلال ما مرّ به
الوطن منذ ثمانينات القرن الماضي ولاسيّما بعد أحداث الغزو الأميركي
الظالم، قد فكّ عقال الكثير من المجتمعات العراقية، أفرادًا وعائلات،
كي تقرر مصيرها وتبيع ممتلكاتها بأي ثمن ولأيّ كان، وتغادر مناطقها
لتبدأ حياة جديدة في بلدان المجهول، حيث وصل أناسٌ أقصى قرى بعض
البلدان التي نأى مواطنوها الأصليون قصدها، بسبب بعدها أو قساوة
أجوائها. وأنا أقول، كفانا تحجّجًا ولومًا لبعضنا البعض واتهامًا لجهات
مجهولة ذات أجندات وسياسات مشبوهة تريد النيل من بنيتنا ومجتمعاتنا.
وبدل ذلك، فلنجالد ونتحصن ونثبت في أرض الإيمان والأجداد، بقدر تجّذرنا
التاريخي الأسطوري الذي نتبجح به دومًا، دون أن نحرص عليه في تفاصيل
حياتنا اليومية، أو دون أن ندعمه بأفعال وخطوات، هي الأجدر بالالتفاف
حولها وترصينها بالثبات في هذه الأرض و"عدم إلقاء جواهرنا قدام
الخنازير لئلاّ ترجع فتدوسها بأرجلها وتعود فنمزقنا"، كما يقول متى
الإنجيلي. هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نوجهه لبعضنا البعض ومنه نتخذ
العبر والدروس والحكم، في ضوء ما جرى ويجري في بيع الأملاك والمساكن
والأراضي للغرباء من خارج مناطقنا وعقيدتنا وديننا من أجل حفنة من
الأوراق المالية التي أخذت كل هواجسنا وملكت إيماننا بلا هوادة.
لويس إقليمس
بغداد، في 17 أيار 2012
القصيدة بالسريانية التي القاها لويس فرنسيس اقليمس في حضرة غبطة البطريرك مار غغناطيوس يوسف الثالث يونان عصر يوم الإثنين المواق 16 شباط الجاري، خلال زيارة التهنئة التي قام بها وفد عراقي رسمي برئاسة الأستاذ عبدالله النوقلي، رئيس ديوان أوقاف المسيحيين وبصحبة وفدإبرشية بغداد للسريان الكاثوليك برئاسة سايدة المطران متي متوكا الجزيل الاحترام ومعه عدد من الكهنة الأفاضل ورهط من المؤمنين الذين شاركوا في مراسيم رسامة وتنصيب غبطته بطريركاً على الكنيسة السريانة الكاثوليكية يوم الأحد المصادف 15 شباط الجاري.
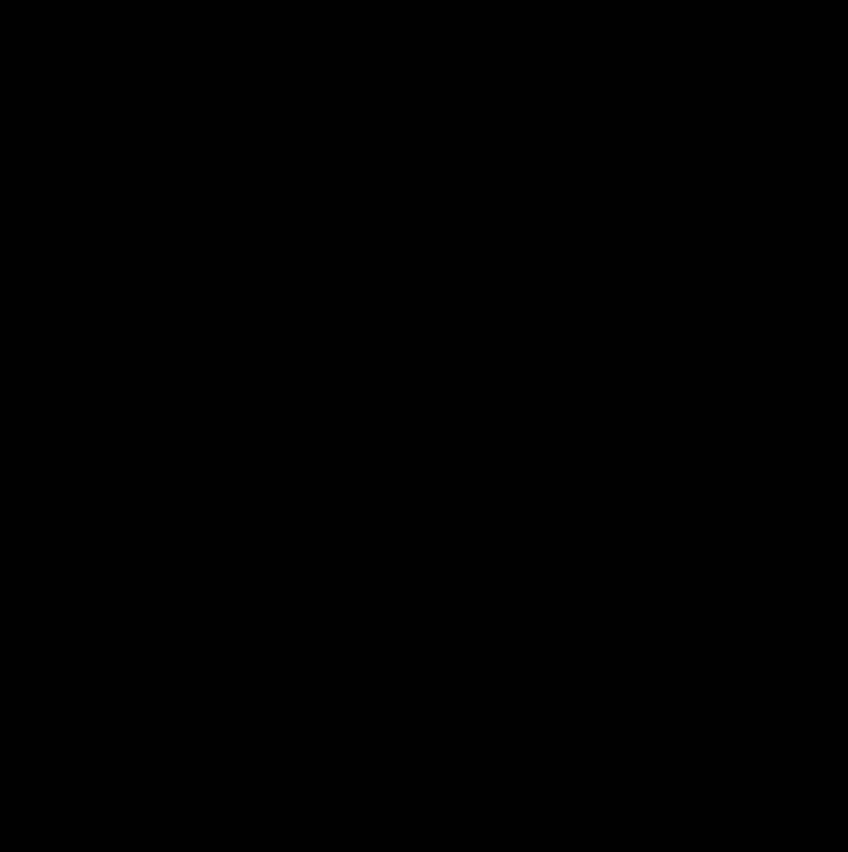
|