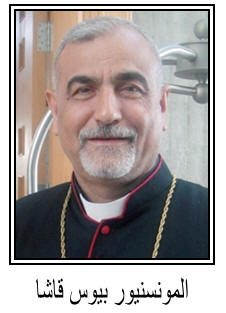في مسيرة سينوودس كنائس الشرق الوسط
الحياة لحظات مستمرة... سلسلة متتابعة... فيها ما يزرع الفرح فتكون
سبباً للتفاؤل في المسيرة... ومنها ما يعكّر صفوتها فتكون رسالة
مؤلمة. والإنسان
بحاجة إلى ولادة مستمرة في كل لحظة ومع كـــــل حدث، كون
الأحــــداث لا معنى
لها من دون الإنسان، وعبرها يرعانا المحب الخالق، فنكون حدثاً من
نوع جديد بعد استسلامنا لإرادته وإكمالنا لمشيئته
(متى 39:26)... إنه الإيمان، ومع هذا الإيمان يتكيف المسيحي فيجعل من
الحدث بشارة جديدة، ويقرأ ما في داخله من محبة ورسالة أشار إليها
الله سبحانه وتعالى من أجل أن نكون له ونحيا لأجله ومعه، وتلك
علامة نرسمها عبر مسيرتنا الحياتية في الألم أو في الفرح، فنكون
بذلك خارطة الطريق ما بين الكلمة والحدث، ما بين الرسالة والتعليم،
ما بين التجدد والحاجة، ما بين الخالق والإنسان... إنها حاجة، بل
حاجة من نوع جديد.
نعم، مرت بلادنا في أزمة أمن وأمان _ وإنْ كان لحد الساعة
لم يستتبّ الأمان كما يجب _ ولكن المسيرة إنشاء الله بجهود الطيبين
وذوي الإرادة الحسنة تسير نحو التهدئة والاستتباب. فالحمد والشكر
لرب السماء. وما حصل للمسيحيين في بلاد العرب لمؤلم حقاً، فمصر
أصولها قبط، والرافدين أصوله أبناء الحضارة، وهذا ما جعل من العرب
المسلمين المخلصين أن ينظرون إلى هجرة المسيحيين وإفراغ بلدانهم
قضية في العمق، وأساسية في التسلسل... وكم أتعزى بهذه الكلمات،
ولكن أقولها صراحة وحقيقة _ والحقيقة يجب أن تقال في وجه الأقوياء
_ ما الذي أتّفق عليه إخوتنا من أجل قضية مسيحييهم؟.
نعم، مقالات عدة حُرِّرَت، وكتابات متنوعة أُدرجِت، ولكن لم
نجد صوتاً واحداً متحداً لا شائبة في سماعه إلا المحبين، يُعلن من
على منابر الخطابة ومنابر دور العبادة لإعلام بسطاء الزمن وفقراء
المسيرة أن قضيتهم هي مسيحيوهم إلا المحبين، بينما كان سينودس
كنائس الشرق الأوسط من أجل العرب والمسلمين كما كان لمسيحيي
بلدانهم، وما يُصرّح به المرجعيات المسيحية ما هو إلا نداء محبة
ولا شيء آخر.
فوجودنا وقضيتنا ابتدأت منذ زمن، وأُثيرت منذ الاحتلال ولحد
اليوم، وعبر ذلك كله نما في داخلنا _ نحن جيل القضية _ خوفٌ وكبر
مع أيامنا بنهاراته ولياليه، وبسببه لم نعد نبصر شيئاً حتى عيوننا
بل حتى مستقبلنا، كما أصبحنا _ نحن وإخوتنا _ نربط مصير وجودنا
بالإرهاب القاتل، والطائفية المقيتة، والعنصرية المزيَّفة،
والتهجير القسري، والاستغلال الوظيفي، والتسييس المصلحي، والمنصب
الأناني، والمكان المسروق... وملكت علينا السذاجة، فأصبحنا لا نعرف
كيف نحلّ عقدة مسيرة وجودنا كون إخوتنا لم يفتشوا عن حقيقة الحدث
وما يحصل، ولم يفكروا يوماً بأن يحلّوا عقدة الشرق الحياتية، بل
رسموا لهم هدفاً أنه من الواجب، بل من الجدير السعي فيه، هو
إبعادنا كي يقابلوا لوحدهم ما هو للغرب الذي ينظرون إليه. إن هذا
الإهمال في التفكير وفي قلّة الوعي، يقود إلى أن ينسب الغرباء إلى
إخوتنا أنهم يضطهدوننا عبر حملة منظَّمة في أحداث ومواقف فردية أم
ثنائية متباينة، ومن المؤكد ليست إلا لأغراض سياسية.
نعم، إن ما يحدث في عوالمنا العربية من ثورات أو تحركات أو
مظاهرات هدفها التحرر من ظلم ومن كبت حريات، كما هو نزاع على سلطة
يراد بها ومن أجلها عبر صراعات فكرية في التسلط على رقاب الآخرين،
وإصدار الحُكم عليهم. كما يريد المنزّل في ما تقول الآية، أو كما
يصور الفكر، وكيف يجب أن يطبّق، وإنْ كان الإنسان غريباً عنه،
إضافة إلى التناحر الكبير من أجل مصالح دنيوسياسية، وهذه كلها تخيف
المسيحي ويبقى يتساءل: لماذا وكيف وحتى متى يُسيَّس طريق السماء،
ويُفرَض على الإنسان حسب ما يشاءون؟... لماذا يهتم أهل الشأن
والمناصب بهذه الأمور بدل أن يهتموا بإكساء العريان، بإشباع
الجائع، بإرواء العطشان، بإطلاق حريات الكلمة ومسيرة المجتمعات؟...
فالفقراء قد ملئوا حاراتنا الشعبية دون أن ندري، هذا من جانب. ومن
جانب آخر لا زال الخوف يزرع الهلع في قلوب تُبّاع المسيح حيث لا
طمأنينة ولا سلام، حيث لا عدالة في حكم الأوليات، حيث فرض القساوة
على أصحابها أو غربائها بأن يَرتَدُوا كذا ولا يجوز إلا هذا
القانون كونه عنوان السلطة. ففي ذلك يتصرف المفوَّض كما يشاء في
إهانة الغريب المؤمن ببشارة الخلاص، وسيبقى يخاف حينما لا يجد
كرامة لشخصه ولا حقوقاً لإنسانيته، تثميناً لجهوده وكفاءته، بل يصل
الأمر بتهديده لكي يترك مهمته ومحله الوظيفي كونه مستقيمَ السيرة،
نزيهَ الحياة، ولا همّ له إلا ذرات التراب التي تحتضنه، والإنسان
الذي يشاطره إياها، كما يزداد خوفه حينما يجد العراك والحراك بين
منتسبي رسالة إيمانية واحدة، فالواحد يكفّر الآخر، والآخر يرهّب
الثاني، ويبقى الأمر حرباً قاسية في الفكر والعقيدة من الباطن،
والسيف والرمح أمام الأنظار، وفي هذا كله يستمر الخوف سيد الموقف
على أبناء الوطن بأسره، أو أبناء الأوطان بأسرها.
ولكن، حينما تستتب القلوب، وتهجع النوايا، عبر كلمة المحبة
الصادقة من دون تزييف، تُمحى الحدود والفواصل، تُبنى الجسور
والمعابر، تكثر اللقاءات، فيفهم الواحد الآخر، ويخدم الواحد الآخر،
ويشترك الواحد مع الآخر في مصير واحد وإنْ كانت عبر صداقات مؤقتة.
فالمحبة حيث تملك ينسى حاملها أنه كبرياء الزمن وأناني المسيرة،
كما هو لكثير من الذين يجدون أنفسهم بأن الحياة سلطتها بأيديهم
فيقررون ما يشاءون، ويفرضون على الآخرين قراراتهم وحسب مشيئتهم،
كونهم كبار الدنيا، وينسون يوماً أنهم زائلون وسيدينهم التاريخ،
كما يحاكمهم الحق حكماً، وأي حكم!، دينونة، وأية دينونة!... وفي
هذا كله تبقى الحقيقة حقيقة مهما خُدِعَت ومهما شُوِّهَت ومهما
شُيِّدت ومهما نُسبت إليهم زوراً، فهذه حقيقة مزيَّفة، وحاملها
فاسد، كون حقيقة السماء لا تمحوها الإرادة السيئة والهدف الأناني
كونها حقيقة الله ليس إلا.
مايهمنا في هذا كله، أن كل قضية تثمر في وطننا هي قضيتنا،
ومهما كانت ظروف المسيرة قاسية علينا أن نتفاعل في أنْ كيف نكون؟،
عن ماذا نفتش؟، أين محلنا؟، ماذا نريد لأنفسنا، لكنائسنا، لمسيرة
إيماننا؟... فالقضية تخصّ الجميع، صغار القوم أو كبار الزمن، رجال
العبادة أم مؤمني الكنائس، فالإيمان واحد والرسالة واحدة، فمَن
يحملها عليه أن يجد مجالاً في أن يكون من نوع جديد. والتجديد يعني
أنجلة الحياة، والأنجلة تعني أن نقرأ علامات الزمن وكلمات البشارة
بالحالة التي نحياها، ليس الهروب منها. فنحن لم نُخلَق لنهرب، أو
لنحمل الحقائب وإنْ فارغة. ولم نُخلَق لنسجل تراثاً لا يحق لنا أن
نسترجعه، أو وجوداً لا نستطيع إظهاره أو إعلانه... فالمسيحي يتجدد
كل يوم، يعني أن يصغي إلى ما يقول الرب يسوع كل يوم.
نعم، ربما نحن في مركب قريب من الغرق منه إلى الخلاص،
والمسيح في وجوهنا نائم في سبات عميق وربما لا يدري فينا... تلك
حقيقة مزيَّفة. فحقيقة الراعي أن يسهر على رعيته كونه مثال الراعي
الصالح والأمين أن يسهر بعيون الإيمان وأفكار الشجاعة وعقول
التجدد. وما أحوجنا اليوم إلى تجديد ما ورثناه من إيمان، فقد كانت
لحظة تغطيسنا في جرن الموت لنحيا للحياة لحظة سُجّلت أسماؤنا في
سجلات السماء، حيث التسلسل الإيماني. ومنذ تلك اللحظة أصبحت قوتنا
ليست قوة صهيل الخيل وقعقعة السلاح، وسكين الإرهاب وطائرات الحروب،
بل قوة محبة وخدمة ورسالة وسلام وبناء، من أجل المجتمع ومن أجل
الإنسان، وليس من أجل الأنا... ففي الأنا تضيع حياة الـــــ "نحن".
إنه لَمِنَ المؤكد أننا نعيش مجتمعات مختلفة الرأي تجاهنا،
فهناك مَن يبالي بنا، وهناك مَن لا يهمّه وجودنا. هناك مَن ينسبون
إلينا كل حضارة وأعمدة بناء وحقيقة حياة، وهناك مَن يضعنا على هامش
المسيرة وربما إنكار ما قمنا به، وإنْ كانت أسطر الطرق شاهدة
للحقيقة التي عشناها، وإنْ كانت مأساة زرعها الفاسدون باتّهامات
باطلة، فشوّهْوا بذلك وجه الخالق الرحمن الرحيم، كما دمّروا
الخليقة كما في برج بابل
(أر 11:51)
، ومع هذا نحن من مجتمعاتنا ولسنا شيئاً مضافاً، نحن شيء منها وجزء
من ذراتها، فإذا ما صاحت إلينا لبّينا النداء، وإذا ما تحركت
تحركنا معها. وما يحصل لها ولساكنيها يحصل لنا ويجري على جميعنا.
والسؤال ـــ هنا كونه يحمل ألم الجميع، يحمل همّنا وهمّ الجميع،
ولا نعلم إنْ كان الجميع يحمل همّنا كما نحن. فنحن يهمّنا كل إنسان
ولو من غير إيماننا، كون الإنسانية رسالة المسيح الحي، وكلنا أخوة
في هذا المسار إنْ كنا في صراط الكنيسة أم في صراط المجتمع أم في
صراط مستقيم، ولا وصية لنا غير المحبة التي تزيّن حضارتنا كغرباء
حتى سابع جار، بل أبعد من ذلك بكثير كونها تظهر قاماتنا في كيف
نكبر في القامة والحكمة والنعمة أمام العلي وأمام ابن الأرض.
إننا مشروع محبة، بل موضوع أكيد لمجد الله في العمل والعيش
وليس في الكلام والثرثرة وعاطفة الموت ومنابر المناسبات، في
الأخوّة الأكيدة وليس في القرابة الجسدية أو المصلحية كما يعمل
الكبار في تقريب مَن لا يستحقون كونهم لم يروا مجالاً للمحبة
الواسعة الأطراف التي عملوا على تضييقها حتى أخضعوها، وفي ذلك
مخطئون وإنْ قالوا إنهم على حقيقة من أمر فكرهم وعقيدتهم. ومع هذا
تجديدنا، أو أن نكون جدد المسيرة لحياة الحي ولمسيحية جديدة، ننطلق
من القبر المفتوح في تقوية الإيمان بقياس المحبة. فالإيمان هنا
رسالة لتقويم المسيرة، والمحبة غذاء لها، والمؤمن ما هو إلا حقيقة
المحبة في قبول الآخر وإنْ اختلفت رسالتهما.
هذا هو النوع الجديد الذي يحمله إنجيلنا إلينا كل لحظة وفي
كل حدث، ومع ذلك نكون مسيحيين من نوع جديد، ليس بقوتنا وعقلنا
وإدراكنا بل بعوننا مع عمل الروح ومواهبه الخلاقة... إنه أقنوم
ثالث يسير معنا على طرقات الزمن كما سار الأقنوم الثاني على طرقات
الجليل والناصرة يوماً. وكلا الأقنومين يحملان محبة الآب إلى
السالكين في سبل الحياة فيتجدد وجه الأرض وتتجدد رسالتنا، فنكون
بذلك مسيحيين من نوع جديد في الإيمان
(متى 21:21) وحقيقته، والرجاء
(مز 14:27) وعدم خيبته، والمحبة الصادقة
(متى 39:22) ، البريئة، الطاهرة، لا المحبة المزيَّفة والمصلحية والأنانية... إنه زمن
نثبّت فيه أقدامنا لنعلن أن الرب "قد
قام وليس هو ههنا "
(6:28)... نعم، وآمين.
اكبس هنا للأنتقال الى الصفحة الرئيسية للمونسنيور بيوس قاشا
|