
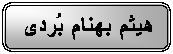
قصص قصيرة
صدى
يأتون ويذهبون هكذا ، أغنية الحياة الازلية ، من التراب الى الثلج .. كانت واقفة امام النافذة تتأمل الوادي والجبل المعمم بقبعة من الثلج البض البكر . كل شيء في الغرفة كان يفصح عن أحاسيس المرأة ، المصباح الواني ، الفراش المسفوح ، الاواني الملتمعة ، .. ووجهها . تذكرت كلمات أغنية قديمة .
عندما تغطى الثلوج قمم الجبال ويهبط الليل ، الليل الابيض ..
يتناجى العشاق .. وتدندن الاغصان العارية بالاغاني الاليفة..
يأتي فارسك الثلجي على صهوة القمر الفضي ..
الفراش اكتوى بالنوى ، أمس موحشا يصطلي بالرغبة لعناق جسده المسكون بالثلج البض الدافئ ..
(( في المرة الاولى جلب جوزا وبلوطا وزعرورا ، وأشياء اخرى ، كان يضحك وهو يحدثها عن الجبل والثلج والدببة التي تخطف الرجال الى غيران قصية في قمم رهيبة ، كانت تهيم في رنات صوته وهي تتأمله ، ورويدا رويدا كان صوته يغيب في فضاء الغرفة ، ولا تفقه بعدها سوى انفتاح وانغلاق شفتيه الناريتين ))
صدى الاغنية يتسرب الى حناياها سياطا تلهبها فتحس أن الاشياء تستحيل الى نار ذات أسنة برتقالية .
ويهبط الليل ، الليل الابيض …
تتحرك أصابعها تبحث في طيات جسدها القابع تحت الثوب عن الاماكن التي حرثها فيه …
(( في المرة الثانية عندما أتى ، لم يتكلم البته ، حملها بين يديه بصمت ، صمت صاخب بالحركة والقاها على الفراش .. ))
لو يأتي الان … !
سرت الكلمات في الغرفة كمواء مبتور لقط جبلي ثم تلاشت … لاشيء سوى جبل شاهق ينام بوداعة تحت طيات الثلج، وليل كئيب أبيض يغفو ببلادة في الوادي العميق وصدى أغنية قديمة..
يأتي فارسك الثلجي على صهوة القمر الفضي .
الثلـج
تغوص قدماه في طيات الثلج المنفرش على امتداد الارض حوله ، يتوقف ويلتقط أنفاسه المتهدجة . ينزل الجسد الممدد على كتفيه وينيمه برفق فوق الثلج فيتشكل متخذا وضع المسدس ، يفرك الرجل أذنيه المتصلبتين بكفيه فتسرى فيهما حياة دبيبة ، يشعر بتخدر لذيذ فيغمض عينيه ويغرق في غرفة موصدة الابواب وقد نبتت في جدرانها مدافيء تهمي بنيرانها وتشيع حرارة يافعة في جسده المكدود . يخزر رفيقه الممدد الذي لاينم عن أية حركة سوى هبوط وصعود صدره فيهمس .
- لا بأس يا صاحبي ، لم يبق سوى تسلق هذا الجبل ونصل القرية .
الخطوات الاخيرة للوصول الى القمة ثم ينحدر نحو القرية النائمة بوداعة صبية مجدولة الضفائر على سفحه ، تذكر الزوجة الواقفة وراء النافذة ترشق السفح بنظرات زائغة فتملكه رغبة حامية في تسلق البقية نطأ مثل ماعز جبلي نزق ، الجسد الهامد على كتفيه سرت الحياة في خلاياه فأنشأ يئن ، وبعد حين شعر الرجل أن القمر أشرق في قبة السماء منيرا فضاء الجبل .
الخطوة الاخيرة … حسنا ها انت الان في القمة ، .. آه ، يا قريتي ها اني اغمر وجهي الاسيان في شعرك الليلى فدفئيني .. ولكنه حين قذف نظرة مذعورة الى المنحدر لم يجد الا الثلج المكدس ووادٍ سحيق ، فأحس ببرودة قاسية في عروقه وببطء أقعى ينظر القمر الذي بدأ نصفه المضاء بالاختفاء وراء سحابة رصاصية .
اندلق القمر ثانية يغسل الفضاء بنوره الفضي ، صحا من تأملاته على صوت واهن .
- هل وصلنا … ؟
- تقريبا
الاخر يتحرك ببطء شديد
- أحس بفقدان نصفي السفلي .
تمعن في الوادي المنبسط تحته وتسلقت نظراته تتفحص معالم الجبل الباسق أمامه ، التمعت عيناه وسرى الدم في عروقه، هتف .
- هيا .. تمدد على كتفي جيدا .. هكذا .. ، لكي تحس بالدفء ، ماذا تقول .. ؟ انك مقرور .. لا بأس لم يبق سوى تسلق هذا الجبل ثم ننحدر نحو القرية ..
القصيرة جداً … لماذا … ؟!
ترى – أواجه دوماً – ما الذي يدفعنا الى كتابة القصة القصيرة جدا … ؟ أهو العجز .. ؟ أم قصور في الاداة والمطاولة اللغوية ؟ أم هو الكسل ؟ ولم ظهر هذا اللون من الأدب ؟ وما فرقه عن القصة القصيرة … ؟
قد يقول قائل ان هذا اللون من الأدب قد برر وجوده لأننا في عصر السرعة والتكنولوجيا فيحتم إذن ان يولد أدب جديد يحاكى العصر وتحولاته ، وأن الوقت لم يعد يتسع لتصفح قصة قصيرة ، أو قصة طويلة ، أو رواية … قصيرة كانت أم طويلة . ورغم أن هذا الرأى فيه من الصحة الشيء النسبي اليسير ، الا أنى لست معه ، فالقصة القصيرة جدا ولادة طبيعية وصحية في أدبنا المعاصر ، وأن ولادتها مستقلة بكينونتها الخاصة . مع كونها امتدادا صميميا لفن القصة والرواية – تشرط علينا ان نرعاها ونحتفل بها ، لكي نتخلص من الاشكالات التي تصاحب كتابة القصة القصيرة مثل الاستطراد والاسترسال اللغوي غير المبرر في قصة لا يحمل بناؤها وحدثها كل هذا السيل من الكلمات ( أنا لا أعني أن نقوم مقام الخياط ونمسك المقص ونعمل نهشا في القصة القصيرة ونحيلها قسرا الى جمل وتعابير غير مرابطة يكتنفها الغموض والتفكك لتصبح – بالتالي – قصة قصيرة جداً ) . ل! ا … بل أعني فهم خصائص وبناء هذا اللون من الابداع ، من جزل في اللغة ، واقتصاد في السرد والتركيز والايحاء في الفكرة وشموليتها ، وابراز الجوانب المشرقة للعمل الابداعي ، وتبعا لهذا فأن القصة القصيرة جداً حالة انسانية – كالقصة والرواية والشعر واللوحة … الخ – ترصد دقائق الحيوات الانسانية في ضربة سريعة خاطفة ، وليست عجزا أو عكازا يتكئ عليه القاص ، كما أنها ليست صالة استراحة او محطة انتظار .
وأنا – كقاص – عندما شرعت بكتابة القصة القصيرة جداً لم اكتبها لشيء سوى تلبية لذلك الهاجس الذي يحلق بي عاليا الى عالم خاص وآخاذ ، كومضة برق ، أو قصف رعد ، أو تكون قطرة ماء أسفل حب ( بكسر الحاء ) وضمن حالة انسانية أعيشها بكل جوارحي ، وتنثال الكلمات عندئذ كقطرات المطر لتتشكل بالتالي قصة قصيرة جداً .
وفي هذه المحاولات حاولت أن أدخل ميدان هذا الفن ، عساي أن أوفق وحسبي أن أكون .
- لابد ان وراء هذا الرجل قصة … ؟
ثم مع نفسي
- لا أفقه ما يعتريني عندما أراه. شعور ليس بالعطف عليه، ولا السخرية منه، ربما كانت الرهبة، الرهبة مم.. !؟ ربما من سحر عينيه أو هيئته، أو من شيء آخر، لا أدري…
ومشيت ساعيا نحو مؤخرة الزقاق وصورته السرمدية تتجمع في ذاكرتي : قامة مديدة فارعة، وجه صارم أبدا، عينان واسعتان صقريتان، أنف مستقيم، شارب كث فضي، وجسد كدعائم الجسر الفولاذية الرابضة خلفه.
- ما حكاية هذا الرجل، وما سر التصاقه اللامحدود بدجلة ؟
$ $ $
صوت..
- سيفيض لا محالة.
صمت قصير يرين يقطعه صوت نسائي رقيق.
- أرأيتموه هذا الصباح؟ لم يتبق سوى نصف متر تقريبا ويصل الى الحافة الحديدية للجسر.
وصوت ينذر بخطر خفي..
- وان حدث وفاض فأن الميدان(1) هو الضحية الأولى. حي في الموصل
وصوته به رنة رجاء.
- ولكن الجيش والدفاع المدني والمنظمات الجماهيرية نزلت الى الشاطئ وأخذت تنشيء السدود الترابية.
وتذكرت بيتنا، أساس الحائط الخلفي يلامس باستحياء مياه الشاطئ التي تلطمه بعنف وقسوة في الأيام العاصفة… كنت في الأيام الربيعية المشمسة أضع كرسيا على شرفة الغرفة الخشبية المطلة على دجلة في حي الميدان، وأجلس أتامل النهر الرائع وهو ينساب بكل هدوء نحو دعائم الجسر والنوارس تحلق فوق الزوارق المتهادية على سطحه وفوق السماكين وهم ينشرون شباكهم ويغنون والنوارس فوق اجسادهم تصيء، كنت أهمس بوله..
- فردوس أرضي..
ثم تتعاقب في ذهني صورة نقيضة: السماكون واقفون يوجوم وعيونهم تعاين المويجات الهائجة، والنوارس تحلق عاليا هاربة نحو الغيوم الربابية والزوارق تتلاطم بصخب، فأهمس ملتاعا.
- ايمكن أن يتحول الفردوس الى جحيم؟
أنفض الفكرة من رأسي وأقوم متوكئا على سياج الغرفة الخشبي بنقوشه الموصلية الخلابة وأتأمل السماكين بسحنهم وسيقانهم المشعرة المكشوفة للشمس والريح وهم يعدلون من وضع شباكهم وأقول لنفسي:
- أية حياة رائعة يعيشها هؤلاء الناس.
ثم اغمغم.
- أية حياة رائعة تعيشها يا أبي.
وأصحو على صوت أعرفه يقول لي
- هيا يا أسعد
اقول له، والدهشة لما تزل تلجم حواسي
- أين… ؟
- قررت ادارة الجامعة أن تشترك في انشاء السدود.
$ $ $
فجأة رأيته أمامي…
كنت أهم بحمل أحد الأكياس الرملية عندما رأيت، وأنا منحنٍ، قدمين حافيتين متشققتين، جمدت يداي في موضعهما على طرفي الكيس وأخذت أرفع رأسي مستعرضا الجسد.. القدمان وخلفهما شريط من الماء المائج.. الساقان المشعرتان المنفرجتان وبينهما الشاطئ البعيد للنهر النزق، ثم لملمة دشداشته على فخذيه ووراءهما أغصان السرو والكالبتوس والاثل، ثم حزامه وأسفل سرته وخلفهما اوراق الاشجار المتشابكة.. صدره، ووراءه نهايات قمم الأشجار الباسقة، وأخيرا، رأسه بشعره المبعثر وخلفه سماء زرقاء تتخللها بضع غيوم رصاصية. كان وجهه في تلك اللحظة رؤوما الى درجة الذوبان، ابتسمت بوجهه ونبرت:
- مرحبا.
اجابني بهمهمة
- مرحبا.
وانفرجت شفتاه عن ابتسامة حيية، ثم تمتم ببضع كلمات، بصق في باطن كفيه وانحنى، رفع أحد الأكياس الرملية وهتف من بين اسنانه:
- هيا يا أسعد.
رددت لنفسي بذهول :
- يعرفني.
وقلت له :
- من أين تعرف اسمي… ؟!
تاه بصره في البعيد، أحسست بأنه انفصل عني تماما، وهمس بنبرة حزينة شفافة :
- كيف لا أعرفك، كنت في صباك تشبهها تماما.
قلت في دهشة أكبر :
- أشبه من.. ؟!!
وكأنه انتشل من عالم مسحور قال مرتبكا:
- لا شيء… لا شيء… هيا… هيا.
حملت كيسا ثانيا وأنا اعاينه مأخوذا، سحب شهيقا عميقا ثم زفره بقوة هائلة ورشقني بنظرة ثاقبة وهتف :
- تعجل يا أسعد، علينا أن نعارك النهر.
وخلال طريقنا اعدت عليه سؤالي :
- أشبه من… ؟!
جمدت اسارير وجهه وارتجفت شفتاه، خجلت من هذا الاقتحام غير المبرر ثم سمعته يهمس :
- هيا الوقت من ذهب.
- بالمناسبة ما اسمك الحقيقي ؟
- كل الناس تعرفه، أنت بالذات كنت تلاحقني وتصرخ بعبث طفولي حسين المجنون.. حسين المجنون ثم ترشقني مع اقرانك بالحجارة وتهربون الى عطفات الأزقة.
- وكنت تركض وراءنا.. ؟
- كان بودي أن أفعل وأمسكك أنت بالذات لكي أشبعك تقبيلا.
- تقبيلا.. ؟
قال مبتسما :
- لا تتصور كم كنت ولا زلت أحبك، كان بودي أن أحزّ صدري بمدية وأضعك بين جوانحي لكي تتوحد بي..
- لم بحق السماء.. ؟
- لأنك كنت تشبهها.
- اشبه من يا عم.. ؟!
وقبل أن تصدر عنه أية نأمة اقتحمتنا صرخة مدوية.
- انها تغرق…
نظرت اليه، لم اجده، وبعدها سمعت احدهم :
- لا فائدة، من يستطيع مقاومة التيار .
فتشت عنه بين الوجوه بيد اني لم اجده، وبغتة.. انبثق عن يساري فوق الاكياس وهو ينظر بعيون مجنونة نحو جسد الصبية ويهدر بصراخ كالزلزال :
- زينب..
وكانت امرأة في ميعة العمر تولول صارخة :
- هاجر…
والقى نفسه في دجلة، حسين المجنون كما يسمى، يجاهد ضد التيار، كانت المويجات المصطخبة تقذف الصبية بلا رحمة، والعم حسين يشق صفحة دجلة بعنفوان شبابي متوثب وهو يصرخ :
- زينب..
وانطلق بقفزة هائلة ثم انغمر في اللجة كالسهم، صاح الرجال:
- لن يخرج.
ابتهلت بحرارة
- يارب حقق مسعاه.
وخرج جنب هاجر، امسكها بيد واحدة وصار يسبح نحو الشاطئ بمظاهرة التيار بيده الثانية، وأخيرا وصل الى الشاطئ المحزّم بالاكياس.
هرع الرجال وتلقفوا الصبية ومددوها فوق الاكياس، فيما بقي هو في الماء على الشاطئ المائج، انحنى عليها بعضهم ثم رفعوا رؤوسهم آسفين وقال احدهم..
- لا حول ولا قوة إلا بالله..
صرخ كالرعد :
- مستحيل، زينب لن تموت..
واستقرت عيناه على وجهي، لوح لي بعينين مخضلتين بالدموع ثم حولهما نحو السماء وهمس كصوفي متيم :
- زينب، ها اني راحل اليك.
تلقفه الماء وهو ساكن، جرفه التيار الى وسط النهر وهو كالقشة لا يتحرك، قفزت فوق الأكياس واشرأبت بعنقي، كانت اعماق النهر تناديه بالحاح وأخيرا، تحت الجسر رفع ذراعه ملوحا، صرخت :
- عمي حسين..
اخذت الذراع تتبع الجسد الساعي نحو القاع، صاح الناس :
- انتحر الرجل..
لهجت بصوت ثقب سكون الكون..
- لماذا… ؟
وانفجرت باكيا.
في المقهى جلست والحزن يعمم رأسي، كانت صورته ملتصقة في رأسي مثل شعرة سرمدية وهو يرمقني بعيون باكية، وداعا، لا ياعم.. لم اثرت الرحيل.. ؟ انهم يقولون عنك مجنون. ان في جمجمتك تفاصيل لم تبح بها… ، كان رأسي يدور، يسبح في بحر من التساؤلات والمرايا، وصورة مطربة عريقة تمتزج مع العقالات والسدارات ورؤوس حليقة وصوت مطربة شرقية ثاقبة الصوت، ضجيج، ضجيج، ضجيج، لا يا زينب، النهر، الغرق، الفيضان، نفثت دخان سيكارتي فتحلق أمامي كلغز غامض، انتبهت جيدا الى قرويين يجلسان قبالتي، كان الأول يقول بحزن :
- ألم تسمع الخبر يا حمد… ؟
- أي خبر… ؟
- غرق حسين الحمود.
قال الثاني مندهشا :
- غرق حسين الحمود.. !
أومأ الثاني برأسه. قلت مشاركا الحديث :
- اتقصد، الذي غرق هذه الظهيرة !
أجابت بنبرة محايدة :
- أجل…
قلت له بحرارة..
- هل تعرفه.. ؟
- انه من قريتي..
- من تكون زينب ؟
اغتسل وجهه بدفقه من حزن نبيل ثم قال :
- يبدو انك تعرف عنه أشياء كثيرة.
- كان صديقي .
وبغتة سألني :
- هل تظن انه كان مجنونا.. ؟
- لا اعتقد، انما هناك شيء كان يؤرقه كثيرا.
وبعد وقفة قصيرة نبرت مؤكدا :
- اعتقد ان هذا الشيء كان امرأة.
- صحيح..
ثم قال وقد انفصل عن جو المقهى تماما..
كنت جالسا اراقب قطيع الأغنام النائمة بوداعة، وأحرسه من الذئاب المنتشرة في الفلاة، وكان هدير دجلة الغاضب يصفع هدوء القرية عندما ناداني من خلل غلس الليل..
- أحمد..
- من… ؟
- أنا حسين..
- ما الأمر يا حسين ؟
وسمعت نبرته الحزينة قبل ان ينبثق جسده أمامي..
- اريد المجذافين..
- اتعبر… ؟
- ولو على جثتي..
- ولكن النهر هائج.. لن تستطيع
ثم استدركت مواسيا..
- هل ساءت حالتها… ؟
أجابني بحزن هائل وبصوت راجف :
- زينب تموت يا أبا شهاب، ان جسدها يلتهب، الحصبة أتت عليها تماما، ان لم أذهب بها الى مستوصف الناحية ستموت.
- ولكن عبور دجلة محاولة محفوفة بالمخاطر ان لم تكن مستحيلة.
- سأفعل… سأفعل.
وامام اصراره لم يكن لي خيار ثان، دلفت الى الكوخ وأتيت بالمجذافين.
- انتظرني يا حسين، ساعبر معك
- ساعبر لوحدي…
- سأوقظ المرأة لتحرس القطيع وأوفيك حالا..
ولم يكن أمامي سوى الليل، لقد ابتلعته الظلمة، ركضت الى بيته وأنا اثقب بكارة الليل السادر بندائي وصراخي..
- حسين، حسين..
كان الرجال يخرجون مستفسرين، فأهتف بهم..
- سيموت، أنه يريد العبور لوحده..
وفي بيته وجدت زوجته واقفة أمام التنور وهي تنشج بحرقة.
- أين ذهب…
أجابت من خلل العبرة الساخنة..
- أخذ زينب ونزل الى الشط.
انحدرت نحو الشاطئ ووقف ملجوما، كان حسين يصارع التيار وزينب ملفوفة بشف على حجره، كان يضرب المجذاف فيميل الزورق بشدة ليدخل الماء الى قعره، كان الرجال يصلون تباعا الى الشاطئ، صرخت..
- حسين، ارجع أيها المجنون.
كان القمر لحظتئذ قد انسل الى قبة السماء ينير غضب دجلة وحسين وزورقه مثل قطعة صغيرة من اسفنج، وبغتة سمعت صرخة رجولية طويلة.. كان الزورق مقلوبا ولا أثر لاحد قفز الرجال نحو اللجة، وخلال صراعي مع دجلة امسكت بجسده وهو يحاول الغوص ثانية في غياهب الموج، ساعدني رجلان في اخراجه بينما تناوب الآخرون في البحث عن زينب، كان يصرخ كلبوة مستثارة:
- دعوني… دعوني أخرج زينب.
ثم أنشأ يصرخ :
- زينب.
فيردد الليل الساجي الصدى.. ز.. ي.. ن.. ب.. !
وبقي كل يوم من الفجر وحتى الليل يجلس على الشاطئ تارة ويغوص في الماء تارة اخرى حتى يئس من العثور عليها ثم اخذ يفقد عقله، لم يستطع أن يتحمل الصدمة، صدمة فقد ابنته الوحيدة فاصيب بالجنون. وبعد ذلك اختفى من القرية فجأة، لم نعرف كيف رحل ولكن زوجته قالت..
- مكث طوال الليل يبكي بحرقة وبقيت اهدئه حتى استكان فنمت وحين افقت في الفجر لم اجده.
رحل حسين ولم نعرف مستقره الى ان وجده سليمان في الموصل فكلمه ورجاه أن يعود، بيد ان حسين لم يعرفه أو هكذا اوحى، كان يقول له:
- انا سليمان يا حسين.
فكان حسين يهز رأسه كالأبله.
- ألا ترجع يا حسين؟
ويقول سليمان ان حسين لملم دشداشته واختفى في زحام الأرصفة.
وأخيرا بدأت الأشياء تتوضح، نعم.. أخذت أفهم لم قال بأنه كان يود أن يحز صدره ويضعني في حناياه، لم هذه النظرة الثاقبة، لم الجنون، أو بالاحرى لم الهروب، لم هذا الالتصاق اللامحدود بدجلة، لم حاول أن يموت من أجل الصبية هاجر، لم انتحر حين علم بموتها، ولم توسعت حدقتاه وهو ينظر الي بعينين مخضلتين بالدموع ويقول وداعا .
التجلي
سقط مستطيل الضوء على أفراد الجوقة الموسيقية الذين يحتلون الفسحة الواطئة
الجالسة على مقدمة المسرح فبدأ العازفون كمومياءات مزروعة منذ الأزل بوجوههم
الشمعية واقدامهم الجامدة وأياديهم المصلوبة على أبدان آلاتهم الموسيقية
وقف قائد الفرقة والضوء البنفسجي يصفع ظهره والنصف السفلي من قامته وقد اكتسب
في وقفته هذه هيئة طاحونة هوائية مهجورة خرساء منذ الأزل تبكي مراوحها التي
نخرها الصدأ، صمت، صمت ثقيل يلبد في ثنايا القاعة الغارقة بالغلس
والأنفاس مبهورة محتبسة داخل الصدور اللابدة على مقاعدها، ثم…حركت الطاحونة
مراوحها
***
البحر.. آه.. انه البحر
ومضت العينان العسليتان، تحرك رأس الطاحونة نحو عازف (الجلو) ونوست إحدى
الأذرع بتساوق منظم مع همسات البحر المنسل من أحشاء آلة الجلو، أشارت
العينان - أين الرياح
وتحركت الذراع الأخرى للطاحونة نحو (الساكسفون) الذي أطلق ريحه
الهوجاء
التي ما عتمت أن لطمت البحر على وجهه فأنشأ يدمدم بصوت مجلجل كرجل في قمة
غضبه، وومضت العينان
عرائس البحر
تراقصت الأوتار تتلو صلواتها بخشوع، صار الكمان ملكاً مطلقا يحكم
القاعة بأسرها، امتدت إحدى الأذرع نحو الرقبة ونضت ربطة العنق السوداء ثم هبطت
وتحسست الأزرار الذهبية للسترة السوداء… العازفون ماضون في حرث أراضيهم
البكر والصدور تختلج بعنفوان دافق وعيون كثيرة تومض ثاقبة عتمة الفضاء
تصير الطاحونة ملاحاً يرقى درجات الفسحة الواطئة، البحر يناديه، يفتح
ذراعيه، يسمع ندائه السري
تعال يا صديقي، تعال
مشى على الرمال، تنطبع أقدامه راسمة عليه أسس طاحونة عادت اليها الحياة
بعد أن هجرتها منذ زمن قصي، سمع صوت صديقه
كدت تنساني
أجابه مأخوذاً
وهل ينسى الإنسان قلبه
وتلفّت حوله يتقصى أبعاد المكان، وجد قبة كبيرة تتبختر بجبروتها تحت
سماء حُبلى بغيوم ربابية، سعى نحو القبة يوماً وبعض يوم وحين وصل وجد قصراً
هائلاً كله بياضٌ في بياض تجلس فوقه القبة الزرقاء، جلس على الرمال وهتف
التجلي
يا صديقي البحر
أتته نبرة عاتبة
أما قلت لك، إنك نسيتني
لا يا صديقي، ولكنها الذاكرة اللعينة
لم يجبه صديقه، بل غلف الفضاء صمت طويل تخللته صيحة نورس ضل جماعته
ضرب جبينه بقبضتيه، يبحث عبثاً عن أسم صديقه، ضاع عليه.. تدحرج كعلبة فارغة
داخل تجاويف دماغه المتلبد، جاس السماء بعينين مسهدتين حائرتين، وبغتة
مثل فجوة تتفتح في جدار سد فينبثق منها في البدء سيل من الماء الصافي
المتلألئ تذكر أسم صاحبه، هتف
آبسو..1
تناهى إلى أسماعه صوت صديقه الحبيب وهو يقهقه ولمح باباً ضخماً ينفتح
من بنيان الهيكل الحجري الهائل للقصر وصديقه ينسل منه مبتسماً.. لم يحفر
الزمن أخاديده في وجهه إلا في بضع شعيرات في نهايات ذؤابته وسالفيه فقد
وخطهما الشيب، وسع القائد الموسيقي خطاه، كاد يقع، هرول…وفي نقطة ما قرب
جذع صنوبرة معمرة، التقى صديقه، التحما، تفارقا، التحما، ثم تعانقا…
***
لا تذهبي أرجوك
كانت الحورية تبتعد نحو الضباب الأبيض، ركض صوبها ماداً ساعدين
مفتولين
متوترين، انجذبت إليه كالنسيم وركنت بين ذراعيه، ضمها إلى حناياه كقطعة
نفيسة وصار يراقصها، دار حول نفسه مرتين، طاوعته كقطعة إسفنجية ضمها بقوة
تحولت الحورية إلى عطر زكي أخذ يتصاعد إلى منخريه، تنملت خلايا جسده
وداهمته قشعريرة لذيذة حين أنشأت الرائحة تتسلل إلى أعماقه، أمسك صدره حيث
استقرت وهمس
أحبكِ جاءه صوت صديقه وهو يوغل في النأي
تذكرنا كل حين ثم بقهقة حبيبة
ولا تنسى اسمي أجاب برهافة .. سأفعل
أستقل صديقه عربته الخرافية المطرزة بالأصداف والاشنات الخضر
دكت الخيل سنابكها بقوة على أرض المسرح نتج عنها فرقعة جعلت قائد
الفرقة الموسيقية ينظر حوله بذهول.. كان (الساكسفون) يصلي الجو
ببرقه ورعوده والقاعة تسبح بضوء برتقالي بارق وقد وقف الجمهور
برمته يصفق بحرارة لقائد موسيقي بعينين عسليتين، أندمج مع موسيقاه
حد أنه تجلى فوق خشبة المسرح مجسداً المعنى الحقيقي للسمفونية وقد
تجرد من ملابسه
---------------------------------
(1) اله المياه عند العراقيين القدامى
النهر والمجرى
كان من العسير – أيامئذٍ– أن أستجلي مغزى ذلك السؤال الذي بدأ كبيراً عصياً مثل طلسم قديم لِمَ بكى سمير….؟ وتزاحمت الأسئلة في رأسي كطنين الزنابير… هل تبكي الأشياء؟، البيوت؟ الزقاق؟ المدن؟ الطيور؟، وهل يبكي الكبار، هلى يبكي أبي؟ لم أعاين أبي يبكي البتة، منذ فقهت الحياة وحتى تلك اللحظة وأنا أبن تسعة أعوام. الرجال لا يبكون هكذا كنتُ أردد مع نفسي دوما عندما ألمح الدموع السخية الناصعة وهي تنسفح من عيني أمي العسليتين الالقتين وتنساح مثل الندى الفجري على خديها الورديين، وكنت أتساءل وأنا أتابع أنامل أمي وهي تمسح الدمع المتجمع على الغمازتين بلمح البصر، ولِمَ البكاء؟ وتطرق الأسئلة رأسي بالحاح، هل يبكي بيتنا المهجور؟، أتنتحب غرفتي الصغيرة الباردة ؟ أيشهق طواره الواسع؟، أتنشح شجرة التوت العملاقة؟، وكان السؤال يعقب السؤال ؟ واللغز يلاحق اللغز، ووجه سمير المتغضن وهو في طريقه إلى الاختفاء بين راحتي يديه اللدنتين، كان يتعملق أمامي، كالزقاق، كالسماء، كالدنيا....
***
قال أبي وثمة فرح في عينيه مثل جزيرة خضراء.
- هل انتهيت؟
أجابته أمي وأناملها تمسح العرق المتفصد على الجبين المتعب.
- لملمت كل شيء.
فجاء صوت أبي من الزقاق
- سآتي بـ (البيك آب)، أحضري اللوازم الخفيفة قبل كل شيء.
خاطران فحسب جالا في ذهني عندئذٍ ـ وأنا واقف كالأبله وسط الحوش وتحيطني من الجوانب صناديق وبقج وأكياس مملوءة بالملابس والأواني وابواب خشبية مشرعة بوجه السماء تفصح عن أحشاء غرف مسكونة بالوحشة والصمت والحزن على فراق الأحبة -، الأول: ان الأمر واقع لا محالة وإننا بعد ساعات سنكون في بيت جديد وزقاق جديد وصبيان جدد،… والثاني الذي وضعني في موقع مؤسٍ وحزين، هو أني سأفارق سمير. وربما إلى الأبد رغم وعودي الكاذبة أو العاجزة بأننا سنتزاور دوماً بعد أن يستقر بنا المقام في البيت الجديد، ولكني –ألان– لستُ متيقناً من تحقيق ذلك لاسباب ، أحدها البعد الكبير بين زقاقينا، مشيت نحو فيء التوت وتقرفصت أتأمل الحمامة، كانت ساكنة تلوذ بالصمت، أدخلت إصبعي بين قضبان القفص الخشبية، فهجمت -مثل نمر جريح– تنقر أصابعي بقسوة، وتذكرت سمير….
- الحمائم ما خلقت للأقفاص يا أسعد…
فأرد محاولا طمس الدافع الحقيقي لقصدي.
- أخاف عليها من الهر.
فيقول بصوته الذي هو مزيج بين الطفولة والرجولة المبكرة.
- الحمائم لها أجنحة يا صديقي، لها أجنحة. . . . ولكنها تعود إلى أصدقائها.
ثم يربت على كتفي ويقول بحنان :
- كن صديقها يا أسعد، ولا تكن مثل الشرطي حسن.
ارتعدت للحظات وأنا أحدق في فم الزقاق ثم قلت في زعل.
- يعني أنا….
فقال في تأكيد.
- أذن أطلق سراحها.
ومددت أصابعي نحو باب القفص، ففتحته وأدخلت يدي، إنزوت الحمامة خائفة مستوفزة وقد أشهرت أظفارها متأهبة ، أمسكتها من جناحيها وأخرجتها، استكانت بين يدي وثمة في عينيها نظرة، لم، ولن أستكنه مغزاها أبداً، ربت على ريشها الملون بحنان ثم قبلتها من رقبتها، وأفردت يدي في حركة خاطفة وأطلقتها، طارت وتهالكت على غصن قريب وكأني بها قد نسيت الطيران، ولما أستوت – أخيراً – جالسة على أرجلها المغطاة بالريش رشقتني بعيون بها حور، ثم أفردت جناحيها لزرقة السماء، زفرتُ بقوة وشعرتُ بإحساس فياض من الهدوء والفرح، ثم خرجتُ إلى الزقاق.
***
- هل ستذكرني يا أسعد؟
- سمير…!
قد تبرق الدنيا، وقد لا تمطر، المطر يظل لصيقاً بالبرق لا يمكن الفصل بينهما، والسماء التي ظللتنا طوال الفصول الأربعة، وهذه الحيطان الآجرية التي تشكل في توازنها وتطاولها معالم زقاقنا الحبيب، وبيوتنا، واهلنا، ورجالنا، و. . . . ، و. . . . ، أن تنسى فلن تنسى، سمير، خالد، سعدية، أحمد، جاكلين، عامر، جورج،… والكثير من الأجساد الغضة والوديعة السارحة في أفيائها تمارس أجمل طقس، الطفولة. . . . أن أنسى فلن أنسى عنتر الذي كنته (كنتم ترشحونني لهذا الدور لطولي الفارع وجسدي الممتلئ، فكنت أذهب إلى المطبخ متسللاً وأنا أحاذر أن لا أوقظ أمي وأبي وقت القيلولة، وأعمد إلى القدر فأقشط السخام الأسود وأصبغ وجهي بالسواد وأخرج إلى الزقاق صائحاً
– أنا عنتر، أين شيبوب؟
فيقفز سمير وقد لف رأسه بعصابة حمراء وتمنطق بسيف خشبي، ويرقص أمامي مثل
الشيطان ثم نبدأ اللعب وتوزيع الأدوار، الملك زهير والأمير شاس، وعبلة،
وغالباً ما تكون جاكلين لملاحتها، وعمارة، وشداد، وزبيبة، و. . . . .) ،
وكنا نمثل، آه يا سمير، ما أجمل الصبيان وهم يمثلون، يأتي التمثيل
ويتجسد – عند الصبيان – وجهاً آخر للحقيقة، للحياة، لا تكلّف ولا تصّنع ولا
زيف. . . . ، ماذا أنسى يا سمير، فهل ينسى النهر مجراه، وهل ينسى أسعد
مجراه، هل ينسى سمير.
***
وإذ تبتعد سيارة (البيك آب)، وأنا ملقى في مؤخرتها مع الأشياء بإهمال، رأيت تلويحة اليد، يد سمير، وهي تفتر تدريجياً ثم تتهالك صاغرة بجانبه وثمة في وجهه ووجوه الأحبة الآخرين الواقفين بجانبه، ذلك الحزن الطفولي الصادق العميق، وقبل أن تنعطف بنا السيارة رأيتُ سمير يجلس متهالكاً على أسفلت الزقاق، ثم يجهش بالبكاء.
صورة
في سعيها الحثيث لتغطية كل تفصيلات الغرفة احتوت الأضواء البنفسجية الناثة من
مصباح رابض قرب السقف مقابل النافذة المفتوحة على ليل خاصم قمره، كل شيء أمسى
في وهلة وامضة في ذاكرة
الضياء… سرير واسع يسع لكائنين يرقد فوقه رجل في عقده السادس بصلعة ملمعة
حمراء، ووجه حليق يشف عن وجه متورد بالدم، وقد تناثرت على جانبي جسده فوق
الشرشف المدعوك كتب ومجلات ذات أغلفة أرجوانية وعلى يمين النافذة المفتوحة ثمة
مكتبة أبنوسية زاخرة بكتب أنيقة نظيمة وأمامها تماماً يجلس كرسي دوار يحتضن بين
ذراعيه مكتب من الصباح تكدست فوقه أكوام الكتب، وهناك على يمين الكرسي ثلاجة
كهربائية صغيرة، فوقها تماماً صورة شاب أنيق بربطة سوداء قصيرة تطوق العنق حول
ياقة قميص أبيض وسترة سوداء وثمة في الوجه الأصلع الشاب التماعة عينين صقريتين
وبسمة آلقة مشرقة، تقف على جانبه عروس في ميعة الصبا بوجه صبوح جذاب ونظرة خجلى
تحوي بين دفتيها فرحة حيية عجزت الأهداب المسبلة قليلاً على إخفائها …
***
صوت زجاج يتكسر بعنف جعل الرجل يستيقظ وينظر حوله بتساؤل مبطن بنعاس آسر، أتسعت حدقتاه ذهولاً حين لمح الشاب ينزل من الصورة وقد أدمت كفه فتات زجاج الصورة المتفتت وانتشر الدم على شكل نقاط على مساحات مختلفة من قميصه الناصع البياض، وبعد أن اصلح هندامه ومسح كفه المدماة بمنديل أخرجه من جيب سترته رمق الكهل الجالس أمامه على السرير بنظرة حقد ونبر ..
- تهيأ ..
هز الكهل رأسه متسائلاً ..
استطرد الشاب
- للنزال.
وبعد هنيهة
- احدنا ينبغي ان يموت.
لاحظ الرجل أن ثمة مخالب أخذت تنمو على أطراف جسد الشاب وصار له وجه قنفذ فتي ثم تهيأ وقد أكتسى وجهه ملامح وجه جلاد يتهيأ لسحب الانشوطة، قفز الرجل من سريره، صار جسده ناعماً، وهو في تحليقته السرمدية في فضاء الغرفة، تمايل بجسده الفارع ذات يمين وذات الشمال، وصار صراخه وصوصة خانقة، وانقض على الشاب، وتشابك الجسدان …
***
![]()
![]()
وقفت شمس النهار اليافعة على النافذة، تجمع في ذاكرتها البكر تفصيلات الغرفة … سرير يسع لكائنين يرقد فوقه أفعوان هائل بلا أنياب وقد انتشرت بقع الدم على أنحاء واسعة من جسده الملتف حول رأسه الصامت بعينيه المفقوئتين، وعلى جانبي جسده المرقط كتب ملطخة بدم أحمر قان، بعضها قد تمزقت أغلفتها والبعض الآخر مفتوحة على صفحات بيضاء استوطن الدم المتيبس أبدانها، وعلى يمين النافذة المفتوحة ثمة مكتبة أبنوسية زاخرة بكتب متناثرة على الأرض وقد تحطم أحد ألواحها وأمامها تماماً كرسي دوار أنثقب قماشه فأعلن عن إسفنج حائل اللون، يحتضن بين ذراعيه مكتب من الصباح تكوم فوقه قنفذ أصابه الإعياء يلعق جراحه ونقاط الدم المتكورة على نهايات جسده الابري، وهو لا يني ينظر نحو الافعوان الممدد على السرير ويختض جسده بعنف، له رأس متعب يماثل رأس الافعوان في كل شيء … وفي الصورة المتكسرة الزجاج المعلقة فوق الثلاجة الصغيرة جلست تلك العروس الغضة تذرف دموعاً ثاوية من عينين أقتحمهما التغضن والانتفاخ والسواد، انساحت تشق لها مجرى بصعوبة على الخدين المتغضنين المكتسيين بزغب اسود ناعم، وفم تهدّل جانباه بفعل الزمن
زيارة
دخلتْ دون أن تطرق الباب، إندهشتُ لهذا الاقتحام الأنثوي المباغت لمكتبي، فاح فضاء الغرفة برائحة الأنثى، وعندما أصبحت قبالتي تماماً، في الجهة الأخرى من مكتبي الأنيق، قالت ..
- أتسمح .. ؟
وقبل أن ارد، جلست على الكرسي وهي تشد طرف تنورتها الوردية نحو الأسفل، ثم رشقتني بنظرة زاخرة بالتحدي ونبرت
- هيثم بردى … حسب تصوري .. ؟ !
أجبتها ونظراتي تسافر في أغوار عينيها السماويتين، علني استكنه إبعاد هذه النظرة الجليدية.
- نعم .. أنا هيثم، تفضلي … هل من خدمة ؟
لم تجب، بل أنشأت تخزر الأوراق البيضاء الملقاة أمامي، أردتُ أن اصهر الجليد فناولتها سيكارة، بيد إنها رفضت بإيماءة من رأسها، ثم امتد الصمتُ بيننا صحراء يكتنفها السراب، فأخذتُ اتملاها بإمعان: …. شعر أشقر مسترسل بتموج خفيف حتى الكتفين البضين، وجه ناصع البياض، أنف مستقيم يوحي بالاستفزاز والخيلاء والمناكدة، وفم صغير ملموم، وعنق طويلة، تأففت بعصبية وقالت:
- قد تتساءل عن زيارتي هذه ؟
توقفت للحظة، ريثما أسألها، ولكني لم أفعل، فأستطردت.
- جئت أسألك سؤالاً واحداً، واحداً حسب
قلتُ مبتسماً.
- ألا يجدر بنا أن نتعارف ؟
أجابتني بحسم.
- يكفي أن أعرفك أنا، تستطيع أن تناديني، ندى، هدى، سميرة، باسمة …..الخ
فاجأتني، بغتة، رغبة بطردها، ولكني تمهلت وقد اقتحمني حب الفضول عن فحوى سؤالها، فقلت لها.
- أطرحي سؤالكِ
- لقد قرأت آخر رواية صدرت لك
قلت لها باسماً .
- الغرفة 213 ؟
- نعم ..
- حسناً، وماذا بعد .. ؟
تجاهلت سؤالي وهتفت.
- لم جعلت زكريا يموت بهذه الطريقة ؟
قلبتُ قلمي بين السبابة والوسطى، وأنا ابحث عن الاجابة، ثم قلت.
- انها الطريقة المنطقية التي عالجتُ بها خاتمة الرواية، كان يجب ان يستشهد.
قاطعتني بصوت كحد السيف.
- بل يموت.
استفزتني، فتواترت لهجتي.
- أنت مخطئة يا آنسة …
وتوقفت علني أضفر بأسمها، ولكنها عندما عاينت فمي المفتوح قالت.
- نادني بأي أسم.
أجبتها، بغتة، ببرود صقيعي.
- اعتقد إننا خطان متوازيان
وانشأتُ الملم أوراقي متحاشياً النظر اليها، قامت ووضعت كفيها على حافة المكتب وانهظت جسدها بعنف، ثم نبرت بصوت كزئير لبوة غاضبة.
- ستبقى تكتب نصوصاً محّنطة، ما دمت تسكن هذا البرج، انزل أيها الأستاذ وتنفس هواء الواقع.. انزل…؟!
ورشقتني بنظرة ازدراء، وخرجت كما دخلت، دون أن تغلق الباب.
***
هل كان حلماً ؟ أحدق بذهول في الباب الموارب، إلى المقعد، اتخيلها جالسة تكلمني بحنق، افرك عينيّ واردد لنفسي
- لا ليس حلماً.
وتثوي الكلمات هذا الرأس المصدوع، لم جعلت زكريا يموت ..؟
نادني بأي اسم، البرج…؟ أية جرأة، بل أية صفاقة!، هل ما قالته صحيح ؟ هل نصوصي
محّنطة
حقاً ؟ هل …؟
شعرت بصدغي يهمي ملتهباً وجسدي قنابل موقوتة زرعتها فيه هذه اللعنة الأنثوية الشقراء ثم أشعلت الفتيل ونهظت من مكتبي ممسكاً بجبيني المسعور نحو الحمام لاغسل وجهي.
***
ابتلعني الشارع ، أخذتُ اتملى الوجوه المارقة، خيل لي أن كل شخص التقيته يلسعني بنظرة شامتة ويمرق كالسهم ويختفي، سحلت قدمي إلى الكشك لابتاع علبة سكائر فرأيت صاحبه الكهل يرميني بنظرة شامتة - هكذا تخيلت، وهو يقول.
- أستاذ هيثم، هل أنت مريض.. ؟
أجبته بعصبية
- لا …
ولاحقني صوته الحنون.
- خذ قسطاً من الراحة يا بني.
أخذت أحث الخطى نحو شقة زميلي القريبة وكأني أهرب من قدر محتوم، وحين أضحيت أمام الباب ضغطت على الزر، فأنفتح الباب على وجه لم أره من قبل، فنبرت معتذراً.
- أنا أسف …
قال الرجل بهدوء.
- من تقصد.. ؟
- أنا في غاية الأسف، يبدو أني توهمت، جئت لزيارة صديق يسكن هذه العمارة.
- أتقصد صباح مجيد.
وشدتني عيناه الصافيتان المتألقتان، فكرت … رأيت هذا الوجه من قبل، ولكن أين …؟ وسمعته يقول.
- إنها فعلاً شقة صباح، تفضل أدخل ..
ودخلت الشقة، وحين استوينا جالسين في غرفة الاستقبال سألته.
- هل أنت قريبه ؟
بيد أن الجواب حيرني.
- تستطيع أن تقول هذا.
ثم أنشأ يتملى وجهي بشيء من الدقة ، وتهيأ لي أنه همس شيئاً ما، ثم مد لي سيكارة فتناولتها منه ساهماً، ليس بغريب عني، أشعلها لي بمقداحة قديمة تفوح منها رائحة البنزين، وقال بصوت خفيض.
- أسمي زكريا
- تشرفنا، وأنا …
قاطعني ..
- هيثم بردى.
- يبدو انك تعرفني جيداً، لا بد أن صباح كلمك عني ؟
- كثيراً.
وفجأة، قال مستطرداً.
- أهنئك على روايتك ( الغرفة 213 ).
قلت متباهياً
- شكراً .. هل قرأتها ؟
- من الغلاف إلى الغلاف.
- ما رأيكَ بها ؟
- جميلة … لولا النهاية !
- ما بها .. ؟
جلس لصقي، وقبل أن يتحدث قلت له .
- آه .. اعذرني، لقد نسيت اسمكَ.
ابتسم بوجه مشرق، ثم استطرد.
- يبدو إنك كثير النسيان، من حقك طبعاً، روائي، وصحافة ومشاريع قصصية لها اول ولا آخر لها، ولكن لا بأس ..
ثم بعد وقفة قال بصوت عميق لافت للنظر .
- اسمي زكريا … زكريا سليمان إبراهيم.
قلت له فجأة ..
- عجيب .. اسمك يطابق تماماً أسم بطل الرواية.
- هذا مجرد صدفة غريبة.
قلت مغيراً وجه الحديث.
- لنعد إلى الموضوع..
وبعد وقفة همست.
- لِمَ لمْ تعجبك نهاية الرواية ؟
قال بنبرة صافية وبجرس حاسم وقد وضع ساقاً فوق أُخرى.
- أخطأت في محورين هما:
الأول: كان بمقدوركَ أن تضع الأحداث في مسارها الصحيح لو كنت نبهتَ زكريا إلى
الحالة التي كشفها
صوت ضميره حين كان يُصلي اذنيه بالحقيقة المروعة.
الثاني: إنك وضعت نهاية غير موفقة حين جعلتني أموت مثل حشرة.
قاطعته بذهول.
- تموت .. ؟!
- مثل حشرة.
نهض فجأة ونظر اليّ من علٍ باحتقار، ورعد بصوته العاصف.
- مثل حشرة أيها الروائي الواعد .
مادمت الصالة تحتي، لم اقوِ على النهوض، همست بوجل.
- من أنت ؟
بهدوء، أجاب.
- زكريا، أنا زكريا بطل الرواية.
وأختفى من أمامي، انتشرت ملامح وجهه: في السقف، الجدران، الأرائك، الصور، وأثاث الصالة، صرخت برجاء .
- زكريا .. زكريا، مهلاً يا رجل.
وادور حول نفسي صارخاً، زكريا … زكريا، والوجه يحاصرني من كل حدب، اركض صوبه، ينأى عني، يتوارى، ثم شعرت باسوداد يغلف رؤاي ، وتهالكت على كتف صباح الذي دخل تواً.
- هيثم … هيثم، ما الذي جرى .. ؟ ما خطبكَ ؟
وهوى على خدي بصفعة شعرت على أثرها بحواسي تنسل إلى جسدي ثانية، وقفت كالتمثال وراوزت عينيّ، كان صباح واقفاً قبالتي وفي مقلتيه سؤال.
- هيثم ؟!
سمعت صوتي.
- زكريا كان هنا.
- أي زكريا ؟
- بطل روايتي ( الغرفة 213 ) .
قام وطوق كتفي بذراعه المفتول، ثم همس
- أنا آسف.
ثم ضاحكاً.
- كان لها صدى هائلاً.
وبعد هنيهة.
- أنت بحاجة إلى النوم.
- لا يا صاح، صدقني … كان هنا وهو الذي فتح باب الشقة وكلمني، وأخيراً تركني بعد أن اشعل حرائقه.
ولكن صباح أجابني بثقة.
- كانت الشقة مقفلة، وهذه مفاتيحي.
وقبل أن أجيب رأيتُ صباح ينقل نظراته بيني وبين كفه التي تتدلى منها سلسلة المفاتيح بذهول مجنون، ثم سألني بصوت متهدج.
- كيف دخلت الشقة … ؟
هرول نحو النافذة، وجدها موصدة، رجع اليّ وعيناه تقدحان سؤالاً لغزاً.
- أقلتَ انه فتح الباب ؟
- أجل …
تهالك على الأريكة وأنشأ يفرك صدغه ثم قام نحو المغسلة قائلاً.
- سأبتلع قرصاً منوماً
وابتلع بدل القرص قرصين، استلقى على الأريكة وارتحل في إغفاءة رخية بسرعة فائقة .. بقيتُ وحدي أتملى أشياء الصالة، زكريا… مستحيل، أنه بطلي الخيالي الذي صنعته أنامل مخيلتي، كيف استحال من شخص على الورق إلى رجل حقيقي يزجرني كما زجرتني زائرة الصباح المجهولة، وقمت كالملسوع متسائلاً بحرقة .
- من تكون هذه المرأة … ؟!
وأستحضرت صورتها في ذاكرتي، الشعر الأشقر المتطاير، النظرة الحالمة المنبثة من سحب زرق لعينين بلون البحر، وهمست ثانية بتساؤل أكثرا الحاحاً.
- من تكون .. ؟ !! أتكون هناء بطلة الرواية ؟
ما الخطب يا صاح، كن واقعياً، إنها فتاة لا وجود لها، من صنع الخيال، ولم لا .. قد يكون الخيال الوجه الاخر للواقع، قد تكون هناء شخصية حقيقية، ألم تقل في مستهل الرواية أنها مستوحاة من واقع حقيقي، اذن هناء حقيقية، ولكن من يضمن .. من يضمن .. من .. ؟
واحسست بالدوار يتلاشى رويداً رويداً، واستوى كل شيء في مكانه : النافذة، الأريكة، التحف الصغيرة، وجسد صباح النائم، تمددت على الأريكة الأخرى للصالة، وأنشأت أحدق في السقف، تشكلت في مداه الأبيض المترامي صور مربعات ودوائر وأشكال هلامية وآدمية ونباتية وحيوانية من البقع الرطبة المتقشرة المنتشرة في أديمه كالبهاق، .. لا أدري لم باغتني النوم عندما تشكلت في ميدانه صورة رجل وأمرأة يمشيان جنباً لجنب متشابكي الأيدي، وأمامهما دائرة تشبه الشمس، ثم لم أعد أعي شيئاً….