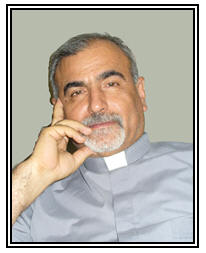أحبوا وطنكم... لا تيأسوا!... لا تستسلموا!... لا
ترحلوا!
لا... لا... لا...!!
المونسنيور بيوس قاشا
ونصوص هذه الفقرات تقول:"أرض شرقنا مرويّة بدماء شهدائنا، عاش
عليها آباءُ كنائسنا وقدّيسوها، وهي مهد الحضارات والأديان ومنبت
الكنائس والأديار التي منها أخذنا هويتَنا وإيمانَنا وحضارتنا
وحضورنا في هذا الشرق حيث أرادنا الله، يقتضي منا الأمانة للمسيح،
والتزامَ الشهادة لمحبته، وتطبيقَ مبادئ إنجيله المقدس... ومهما
تفاقمت المصاعب فإن لنا علامات رجاء ساطعة فيما لكنائسنا من غِنى
روحي وثقافي واجتماعي ووطني".
وأزادوا قائلين في كلمات بيانهم:"إن المسيحية أصبحت عنصراً جوهرياً
من ثقافة المنطقة... كما أن إيماننا المسيحي يقتضي منا أن نجسّده
في رسالة تنبع من عمق أمانتنا للمسيح ووحدتنا فيه والإقتداء به،
وتقتضي منا في الأساس أن نحافظ على وجودنا والبقاء في أرضنا
متضامنين ومتآزرين بمسؤولية مشتركة، فيما نتطلّع بأمل إلى شبابنا
في العالم العربي أن يكونوا شهوداً للإنجيل، وهم بناة المستقبل في
ورشة الشهادة للإنجيل في هذه المنطقة من العالم".
نعم، ما أمرَّ حياتنا هذه السنين، كل يوم نسكب دموعاً وتُسفَك
دماءٌ، وتترمّل نساؤنا ويرحل أقرباؤنا، واصبحت بيوتُنا خربةً لا
نَفَسَ فيها ولا حركة، وحتى الطير هجرها، والسنونو لم يعد إليها،
وأُهملت قبورُنا، ولا أحد مَن يحمل موتانا إلى حيث يرقدون، وقُبرت
أحلامُنا وشُوّهت وجوهُنا، ولم يعد لنا مَن إليه نشكو حالَنا، وأخذ
كلٌّ يداوي قلقَه وقساوةَ مضجعِه حسب علمه وتفسيره ونظرته وحكمته،
وكأن الإله قد نسي شعبه
(إش 14:49)،
وهل من شعب قاسى ما قاسيناه... حروب جعلتنا سيوفاً ملتوية، وحصار
صنع منا مستعطين، نخاف أن نتطلّع من خلال أبواب مساكننا خوفاً، بل
نهمس همساً كي لا تسمع يمينُنا ما تقرّره شمالُنا، وأصبح الأقوياء
وأصحاب الكراسي هم السادة، ومكث الأبرياء والفقراء محتَقَرين
ومهانين وليس إلا عبيداً، ولكن الرب دعانا جميعاً أحباءه
(يو15:15)،
فلا مَن يطالب بالحق، بل هناك مَن يصفّق للظلم واتّهام الأبرياء
لغايات كونهم يقولون الحقيقة، وذلك عبر منظار قريب، مع علمي أن
الله لم يعلّمنا أن ننظرَ بل علّمنا أن نحبّ.
نعم، تساؤلات وتساؤلات... نعم، علامات استفهام وأخرى تعجبية قد
تركزت في عقولنا وقمة حكمتنا، وكأننا في وادي الدموع وساحةِ
المعارك وميدانِ القتال، ولم نعد ندري مَن نُنْصِفْ ومَن نَتَّهمْ،
ونصّبنا ذواتِنا حكّاماً لِمَن يقف في وجوهنا منادياً من أجل نيل
حقه وتقرير مصيره وتعايشه للحقيقة، عاملاً بقول سيده:"قولوا الحق،
والحق يحرركم"
(يو32:8)...
وهذه كلها آلام وشقاء حصلت لربنا أمام كبار الحكّام والسلاطين ودار
الولاية وسفر قيافا وحنّان... وهكذا تمضي الأيام بنا ولا ندري أين
المرفأ وإلى أين نحن سائرون... هل في مواكب الألم، أم في طريق
الأحلام، أم في حقيقة الحدث حيث الإنتهازيون يقتنصونها، أم
ماذا؟... وحتى متى؟.
نعم، أحبّنا المسيح، فهل من حب أسمى من حبّه لنا
(يو13:15)...
فافتَقَدَنا، ونصبَ خيمتَه بيننا لينقذنا من حالتنا، ومن بؤسنا
وشقائنا، الجاثمة على صدور خِلْقَتِنا... حبّه جعلنا نقدّس ألمنا
ونقهر صراعنا مهما كان قاسياً علينا، ونمسح دموعنا بمنديل سيدة
الشهداء كما فعلت وارينا لأنها أحبّت
(لو 47:7)...
ولأننا نحب سنضع أمام أنفسنا مسيحنا المصلوب
(غلا 1:3)،
وكلنا أمل وإيمان ورجاء أن الغني مهما كان غنياً سيكون يوماً في
جهنم
(لو23:16)،
ولعازر مهما كان فقيراً ستحمله الملائكة إلى أحضان نبي الآباء
إبراهيم
(لو 22:16)،
وفي كلتا الحالتين هو الله الصالح
(لو 13:12)،
إذ في الأول عمل الغني لإله البطون، وفي الثاني عاش الله لعازره...
وفي كل ذلك تكون الشهادة هي سموّ التضحية كما هو الحال في شهداء
وضحايا سيدة النجاة، حيث أصبحت دماؤهم حبراً وعلامة لصلاتهم
ومناجاتهم.
نعم، الشهادة لنا رسالة حملتها إلينا كنيسة العليّة، والشهيد ما هو
إلا راسم لمسيرة الحياة بقطرات الدماء التي تُسكَب لتبجّل الإله
المُحبّ الذي ينتظرنا عبر سلّم يعقوب، وساعة التجلّي، ولحظة
الصعود، والعيون شاخصة إلى حيث هو الكائن
(رؤ 3:6).
وفي الشهادة سارت القافلة حاملة إسطيفانوس وأغناطيوس وآخرين،
وبموتهم عُمِّذَت كنيسة المشرق باسم كنيسة الشهداء.
نعم، إنها مسيرة شاقة ولكنها مُحبّة... وصلت إلينا بعد مرّ
الأجيال، وتجددت في طرق الأزمان بعد أنهار من دماء القداسة، حيث
أصبح المسيحيون مشاريع عطاء، لا لشيء إلا لكونهم تُبّاعاً للذي قال
لهم:"مَن آمن بي وإنْ مات فسيحيا"
(يو25:11)،
ولم يفكروا يوماً أنهم قُتلوا لأنهم ذبائح المحبة، فاتحين طريقاً
للسلام، وحياةً للمهمَّشين والمرذولين، وملاحقتهم ما هي إلا تحقيق
لِمَا قاله مسيحنا:"يسلّمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغَضين
من الكل من أجل اسمي"
(متى 9:24)
إن هذه المشاهد الإيمانية، وإنْ كانت مؤلمة ومُحبّة، فهي علامة
مسيحية في سرّ البطولة الحقيقية التي حملها شهداؤنا، فخلطوا دماءهم
بتربة وطنهم وكانوا شهوداً
(متى 19:28)،
كما كانوا مدرسة إليها انتمى المعمَّذون باسمه، وأصبحوا حنطة كانت
للجائعين خبزات
(يو9:6)،
وللعطاش ينبوعاً محيياً
(يو14:4)،
وكتبوا تاريخاً حافلاً وطويلاً كونهم فضّلوا الموت على نكران
إيمانهم أو هجر أوطانهم أو حمل حقائبهم، فقد كانوا من أجله يموتون
كل يوم.
أعزائي... صحيح إننا نعيش وضعاً مأسوياً وصعباً، بل جداً قاسياً،
بل مخيفاً، لا نعرف كيف ومتى ستكون نهايته وكأنه نفق ليس مظلماً
فقط بل بلا أمل في الخروج منه... وهذه المواقف القاسية لا تعني لنا
إلا أن نوحّد كلمتَنا ونُرَوحِن حياتَنا من أجل أفق البقاء ومواجهة
الضياع الذي يتربّص بنا، لنزرع الأمل والرجاء، لأنني أخاف أن يكون
هذا الضياع من صنع أيدينا وصبغ إرادتنا. فما نحتاجه ليس أكثر من
إدراك عمق حضورنا المسيحي وسموّ رسالتنا الإنسانية، كي لا نكون
فريسة سهلة للقاصي والداني، للعصابات والجماعات الظالمة والمظلمة.
يجب أن نكون بعضنا لبعض راية تحتها تستظلّ أجيالنا، وعلى أكتاف
قلوبنا نحملها مهما كانت الشدائد والضيقات والإضطهادات، ومهما
تحكّمت فينا لغة السيف والعنف والتفجير... هذه كلها لا تفزعنا
كوننا نؤمن أن الله معنا
(لو 50:9)
فمَن علينا.
ولنا في شهدائنا أعظم أنموذج، ودماؤنا وإنْ سالت كما في سيدة
النجاة ما هي إلا شهادة على حقيقة ما كتبناه وما تعلّمناه وما
آمنّا به... إنها الحقيقة في الصميم، ولا يمكن للحقيقة أن تحني
قامتها أمام أقزام الشرّ بل لخالقها ليس إلا!.
ولندرك جيداً أن العالم يستغلّنا لملء صفحات جرائده ومجلاته
ودورياته وعناوين أخباره وفراغ برامجه، فيطلب أعدادَنا قبل أن يدرك
أنّ عددَنا هو وطنُنا، وإنّ بقاءنا هو مسيحيتنا، وإن رسالتنا ما هي
إلا إنجيلنا، وإن إنجيلنا ما هو إلا حب، وحب فوق الصليب فقط.
فإن كان هناك أصوات تدعونا إلى أن نهمل البلاد ونغادرها بطرق شتى
وبسبل مختلفة عبر منابر الزمن وسلاطين الدنيا وعبيدات الكراسي بحجة
لمّ الشمل وحقوق الآخر، فالكنيسة ستبقى الشاهدة الأمينة مع أبنائها
الأمناء على حقيقة الكرازة من أرض الوطن حيث تبدأ البشارة، ومن هنا
يأتي الخلاص
(يو22:4)...
وما الدنيا إلا تجارة خاسرة وبائسة يخطط لها ذو الجاه والسلطة
والمال... إنها الدكتاتورية بالذات.
"لنفهم كلنا، كما يقول البابا يوحنا بولس الثاني، أن بقاءنا هو
ضمان لبقاء القيم التي ترمز إلى الإستقلال والتعددية والتوازن
الطائفي واحترام حقوق الإنسان، عندها فقط نقيم الحوار في وجه
الإستخفاف والتهكّم، ونقاوم الإستسلام واليأس، لأن الخطر كل الخطر
بالنسبة إلى الأقلية هو الإنطواء على الذات"... ويضيف ويقول:"أردتُ
أن أتكلم عن جمال أرض الشرق وقداسته، فإني لأعبّر عن تعلّقي بهذه
الأرض"... ما أسماها من كلمات وما أعمق معناها، فالحرية ليست في
وطن محصَّن بل في آتون مضطرم كالفتية في الآتون... فلا يجوز أن
نكون أحجار عثرة أمام الآخرين بل صخرة صلدة لنعطي ثمناً لدمائنا
ونكون بذاراً صالحاً لأجيالنا، فتكون شهادتنا هي حقيقتنا، ولا يجوز
أن نبقى تائهين على دروب الزمن، ومهاجرين، حاملين همومنا وبلايانا
وصلباننا من أجل اللجوء والتوطين، وبذلك نقلع جذورنا من أرض
أجدادنا، ونفرغ كنائسنا التي علينا واجب إنعاشها وحمايتها لتواصل
مسيرة الإنجيل الخلاصية مسارها.
نعم، كلنا نعلم أن بلداننا، وخاصة بعد إنعقاد سينودس أساقفة الشرق
الأوسط في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تعيش مرحلة حساسة وشديدة
الخطورة، بل وصلت الحالة إلى طردنا واضطهادنا وتهجيرنا، شئنا أم
أبينا، وهكذا خطّطوا وهكذا أرادوا، وما علينا إلا أن نعمل كي لا
نكون عبيداً مطيعين لهم، بل نقف موقف الندّ عِبْرَ تضامن كلنا
للمواجهة عبر الشجاعة والأمل والرجاء، كي لا تَمُتْ روح السينودس
فينا، فهذه مشيئتهم... أما نحن سنعمل جاهدين على إبراز هوية وجودنا
وحقيقة حضورنا عبر الوحدة والكلمة، وليس عبر حمل الحقائب والرحيل
إلى حيث أرض الله الواسعة، فتلك خطيئة ضد روح السينودس ليس إلا!.
فما نحتاج إليه هو أن نحكّم عقولنا، ونحدّد جهة مسارنا، وندرك
أهمية رسالتنا الوجودية المسيحية، ولنفهم ما نقرأ، وما أكّدوه لنا
آباؤنا البطاركة حينما قالوا:"إن الرسالة هي الشهادة الحية، وإن
الهجرة تستنزف وجودنا وتسدّ آفاق مستقبلنا، ونحن نفتخر بأننا
شرقيون مسيحيون ولسنا مسيحيين من الشرق"... فنحن لسنا أقليّة بل
نحن سكان أصليون، لنا تاريخ أصبح جزءاً من تاريخ الشعوب، كنا ولا
زلنا بُناة حضارة بلاد الرافدين والنيل، وساهمنا في نهضة اللغة
والثقافة والمجتمع. فمسيحيتنا غِنى لشرقنا، ولا يجوز إنكار ذلك،
فنحن منه وله ومن أجله.
فلا نستسلم لليأس القاتل كي لا نكون في مهبّ الريح، يلعبون بنا متى
يشاؤون وأينما يشاؤون وحسبما يشاؤون، بل لنكون طلاب مدرسة "تحت
أقدام الصليب"، نملأ قلوبنا شجاعة للشهادة للحياة، وكلمة في
الإستشهاد "كونوا حكماء كالحيات"
(متى 16:10).
ولنعمل برؤية مستقبلية واضحة لدى الجميع من أجل حقوقنا في أرضنا
وأرض أجدادنا... وما أحوجنا اليوم إلى تعبئة روحية ونظرة جريئة
وبعيدة المدى في معنى وجودنا، وإلا عبثاً نحتمي خلف أنظمة، ونتحصّن
وراء ضمانات، ونتطلّع إلى حمايات وسياجات، وعبثاً نسعى إلى تثبيت
وجودنا على أرض نظنّها ثابتة تحت أقدامنا إذا لم نسمع كلمة الرب في
أن ننعش إيماننا، فالروح حسب إعتقادي قد ابتعد عن مسيرة دعوتنا
"حتى متى أكون معكم يا قليلي الإيمان"
(لو25:8)،
فنرى شِباكنا لا تصيد شيئاً، لا ليلاً ولا حتى نهاراً، فنحن خُلقنا
لنموت، ولكن مع المسيح نموت لنحيا... فلماذا الخوف؟... ألم يقل نبي
الرجاء وخادم الله يوحنا بولس الثاني:"لا تخافوا ولا تستحوا أبداً
عندما يجب أن تدافعوا عن حرياتكم وخاصة عن حرية القيم الإنجيلية
التي تحيوها معاً"؟.
وأختم بنداءٍ إلى أعزائي الشباب وجّهه آباؤنا البطاركة في
مؤتمرهم:"الوطن وطنكم. أحبوا أوطانكم. فلا تيأسوا ولا تستسلموا،
ولا تعملوا أبداً لإحباط المعنويات، بل عليكم أن تحملوا أمانة
إيمانكم في قلوبكم بمسؤولية مسيحية واعية الإنتماء، وحب أوطانكم في
أعناقكم من أجل بنائه...".
وأقولها خاتماً... كل ذلك لا يمكن أن يكون إذا كان قلبنا بعيداً عن
روح الصلاة والتأمل، فهما سلاح لا تراه العيون بل تعمل به العقول،
وهو مفتاح لباب العريس
(متى 10:25)،
والويل لنا إذا أضعنا المفتاح، فسيبقى الباب مغلقاً. فالخطر الذي
يهددنا، يقول سينودس الأساقفة، يأتي خصوصاً من إبتعاد المسيحيين عن
حقيقة إنجيلهم وإيمانهم ورسالتهم. فمصيبة الإنسان الحقيقية ليست
كامنة في الألم الناجم عن تحديات الرسالة، بل في فقدانه الرسالة،
هذا الفقدان الذي يؤدي إلى ضياع المعنى والهدف في الحياة.
فهل أتت الساعة لنلقى جزاءنا وجزاء فعلتنا وضعف إيماننا وكثرة
لهونا؟... وماذا لو متنا حبّاً براعينا وفادينا وكنيستنا وشهادة
لإيماننا، وما ذلك إلا مطلب السينودس حينما يقول:"واجب الكنيسة
يقتضي منها أن تشجع أبناءها على البقاء كشاهدين ورسل وبُناة سلام
وسعادة هانئة في أوطانهم. فلا يجوز أبداً أن يكون في دواخلنا مجال
لليأس والإستسلام من أجل الرحيل... وهذا ما يجب أن نزرعه وننمّيه
في قلوب أبنائنا ومسيرة حياتنا... وليعمل كلام المسيح فينا ومعنا
وبيننا، لأجله نموت، ومعه نحيا، وفيه يكون رجاؤنا... ودمتم.
اكبس هنا للأنتقال الى الصفحة الرئيسية للمونسنيور بيوس قاشا
|